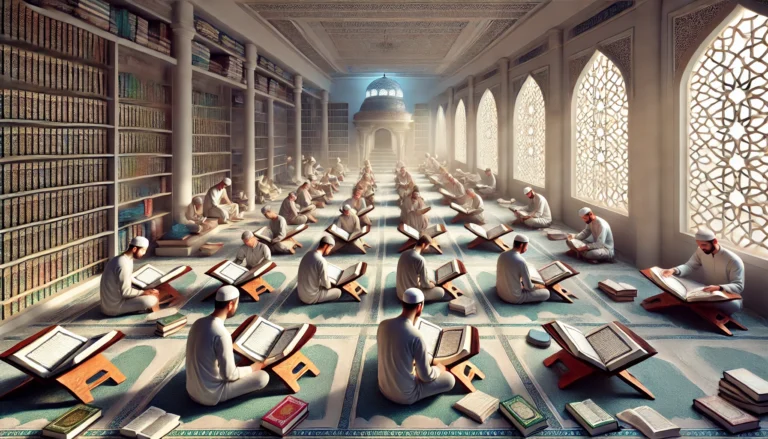سورة البقرة
| سورة البقرة |
بسم الله الرحمن الرحيم
الٓمٓ (1) ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ (2)
عنوان موضوعي: تعريف الكتاب الكريم ووصفه كهدى للمتقين
التفسير: تبدأ سورة البقرة بحروف مقطعة: (الم)، وهي من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، وتُعدّ من دلائل الإعجاز القرآني، حيث تُلفت انتباه المستمع، وتفتح الباب للتأمل في سر هذا الكتاب الذي جاء من حروف معلومة ولكن بصيغة ومعانٍ لا يقدر البشر على الإتيان بمثلها. ثم تأتي الآية التالية لتعلن بوضوح عن عظمة هذا الكتاب: (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ)، أي أنه لا شك في كونه من عند الله، ولا في صدقه أو كماله، مما يملأ النفس طمأنينة ويُعلي من شأن القرآن في القلب والعقل معًا. ويُبيّن النص القرآني أن هذا الكتاب ليس مجرد كلام، بل هو هدًى للمتقين، أي أنه يرشد ويُوجّه الذين اتصفوا بالتقوى، وهم الذين يراقبون الله، ويخافونه، ويتجنبون معصيته، فينفتحون على نور القرآن بقلب سليم، ويُثمر فيهم هذا الهدى إيمانًا وسلوكًا مستقيمًا. وهنا تظهر العلاقة الوثيقة بين صفاء القلب وفاعلية الهداية؛ فكلما زادت التقوى، زاد أثر القرآن في حياة المؤمن.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: خُتمت سورة الفاتحة بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فجاء افتتاح سورة البقرة ليُبيّن أن هذا الصراط لا يُعرف ولا يُهتدى إليه إلا من خلال هذا الكتاب العظيم، الذي جعله الله هدى للمتقين، فيكون بذلك جوابًا عمليًا لدعاء المؤمنين في ختام الفاتحة.
مناسبة المقطع لأول السورة: افتُتحت السورة بحروف مقطعة لجذب الانتباه، ثم جاءت مباشرة الآية التي تُعرّف بالقرآن وتُعلي من شأنه، مما يُرسّخ عظمته في ذهن القارئ منذ البداية. فالبداية بهذا الترتيب تُمهّد لإبراز أهمية الكتاب كمرجع أول للهداية، وتربط بين صدق المصدر وصدق التأثير في المتقين، مما يجعل افتتاح السورة تأسيسًا لقيمة القرآن في حياة المؤمنين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الحروف المقطعة والإعجاز الحروف التي بدأت بها السورة تُذكّر بأن القرآن مكوَّن من حروف نعرفها لكنه معجز في بيانه مما يُعين على استحضار هدفها كلما سُئل عن بدايات السورة، 2. الربط بين نفي الشك وإثبات الهداية قول الله (لا ريب فيه) يتبع مباشرة بيان أنه “هدى للمتقين” مما يُرسّخ في الذهن أن الثقة بالمصدر تؤدي إلى القبول بالهداية ويُسهّل حفظ المعنى متسلسلًا، 3. الربط بين صفة التقوى والانتفاع بالقرآن لا يُنتفع بالقرآن حقًا إلا من اتقى فكلما زاد الإنسان تقوى ازداد فهمًا وانتفاعًا وهذا المعنى يُعزز حفظ الآية من خلال ربط الهداية باستعداد النفس.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الحروف التي افتُتحت بها سورة البقرة؟، 2. كيف وصف الله القرآن الكريم في هذه الآيات؟، 3. من الذين يستفيدون من هداية القرآن كما ذُكر؟، 4. ما فائدة نفي الشك عن القرآن في هذا السياق؟، 5. ما العلاقة بين التقوى والهداية القرآنية؟
ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ (3) وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (5)
عنوان موضوعي: صفات المتقين ومكانتهم عند الله
التفسير: الآيات تصف المتقين بأنهم يلتزمون بأداء الصلاة، وهي أعظم مظاهر العبودية العملية لله، كما أنهم يؤمنون بالغيب، أي بكل ما أخبرنا الله به من أمور غيبية مثل الحياة بعد الموت والحساب، وهذا يعد جوهر الإيمان الذي يربطهم بالله. ومن جانب آخر، ينفقون مما رزقهم الله، سواء كان ذلك الزكاة المفروضة أو تطوعًا في سبيل الخير، مما يعكس حرصهم على تحقيق المصلحة العامة. إضافة إلى ذلك، يؤمنون بما أنزل على النبي ﷺ من قرآن كريم، وكذلك بما أنزل على الرسل السابقين، مما يدل على شمولية إيمانهم واعترافهم بالوحي الإلهي في كافة مراحله. علاوة على ذلك، يوقنون بالآخرة، وهذا الإيقان يشكل دافعًا لهم للعمل الصالح، لأنهم يعتقدون أن الأعمال الصالحة ستكون مآلها إلى الجزاء في الآخرة. ونتيجة لهذه الصفات، نجد أنهم على هدى من الله، وهذا الهدى هو الذي يجعلهم الفائزين في الدنيا والآخرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن وصفت الآية الثانية القرآن بأنه هدى للمتقين، جاء هذا المقطع ليُعرّف المتقين ويحدد صفاتهم العملية والإيمانية التي تجعلهم أهلاً للهداية، فيُظهر الربط أن الهداية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. من بيان أن القرآن هدى للمتقين إلى تحديد صفاتهم الآيات تشرح مباشرة من هم المتقون الذين ينالون هداية القرآن مما يجعل العلاقة بين المقطع السابق والحالي واضحة وسهلة التتبع، 2. تسلسل منطقي بين الإيمان والعمل والجزاء الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق يقود إلى اليقين بالآخرة ثم إلى الهداية والفلاح وهو تسلسل يساعد على ترسيخ المعنى في الذاكرة، 3. تكرار “أُولَٰئِكَ” للتأكيد استخدام هذا اللفظ للفصل بين الصفات والجزاءات يجعل النص متماسكًا وسهل الحفظ حيث يربط كل مجموعة من الصفات بنتيجتها بوضوح.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الصفات التي ذكرتها الآيات للمتقين؟، 2. ما المقصود بالإيمان بالغيب وفق هذا المقطع؟، 3. كيف وصف القرآن علاقة المتقين بما أُنزل على النبي ﷺ وما أنزل قبله؟، 4. ما النتيجة التي يحصل عليها المتقون وفق هذه الآيات؟، 5. ما العلاقة بين اليقين بالآخرة والهداية؟
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (6) خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ (7)
عنوان موضوعي: حالة الكافرين وحرمانهم من الهداية
التفسير: تشير الآيات إلى أن الذين كفروا وجحدوا الحق عنادًا واستكبارًا قد أغلقوا على أنفسهم أبواب الهداية، حتى صار الإنذار وعدمه سواءً بالنسبة لهم، فهم لا يتأثرون بدعوة النبي ﷺ ولا ينتفعون بالموعظة بسبب إصرارهم على الكفر ورفضهم للحق. ويبيّن الله حالهم بقوله إنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، أي جعلها غير قابلة لتلقي الإيمان، فلا تصل إليها دلائل الهدى، كما أن أبصارهم غُشيت، أي غُطّيت بغشاوة تحول بينهم وبين رؤية نور الحق. هذا الوصف ليس نابعًا من ظلم الله لهم، بل هو عقوبة عادلة على إصرارهم واختيارهم للضلال، فقد أغلقوا هم أنفسهم أبواب قلوبهم، فجازاهم الله بسلب الهداية عنهم. وجزاء هذا الإعراض والعناد عذاب عظيم في الآخرة، وهو ما ينتظر من أعرض عن دعوة الحق بعد أن قامت عليه الحجة ورفض الاستجابة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن المتقين الذين يهتدون بالقرآن، يبيّن هذا المقطع حال الكافرين الذين لا ينتفعون بالقرآن، مما يبرز التباين بين الفريقين. الربط يُظهر أن استقبال الهداية يعتمد على استعداد القلب، وهو ما يفتقده الكافرون بسبب عنادهم.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. المقارنة بين المتقين والكافرين الانتقال من صفات المهتدين إلى الكافرين يوضح التباين الشديد بين من يقبلون الهداية ومن يرفضونها مما يسهل استذكار المقطع من خلال وضوح الطرفين، 2. بيان دور القلب في قبول الهداية الربط بين خَتم الله على القلوب ورفض الإيمان يُظهر أن الهداية مرتبطة باستعداد النفس وهو مفهوم جوهري يعزز الفهم والحفظ، 3. قوة التعبير القرآني ألفاظ مثل “خَتَمَ” و”غِشَاوَةٌ” و”عَذَابٌ عَظِيمٌ” تمنح النص قوة تصويرية تساعد على ترسيخه في الذهن.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ماذا تقول الآيات عن تأثير إنذار النبي ﷺ للكافرين؟، 2. ما معنى ختم الله على قلوب وأسماع الكافرين؟، 3. ما الجزاء الذي ينتظر الكافرين وفق هذا المقطع؟، 4. كيف توضح الآيات أن الكفر يعطل قدرة الإنسان على استقبال الهداية؟، 5. ما العلاقة بين الإعراض عن الحق والحرمان من الهداية؟
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)
عنوان موضوعي: حال المنافقين وصفاتهم وعاقبتهم
التفسير: تصف الآيات حال المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُخفون الكفر، يظنون أنهم يخادعون الله والمؤمنين لمصالح دنيوية، لكنهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، إذ تعود عاقبة خداعهم عليهم بالخسران. وفي قلوبهم مرض نفاق وشك، فزادهم الله مرضًا آخر جزاءً لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. وحين يُنصحون بترك الإفساد، يدّعون أنهم مصلحون، بينما هم المفسدون الحقيقيون؛ لأنهم يخلطون الحق بالباطل ويُفسدون النيات والمجتمع. ويستهزئون بالمؤمنين ويصفونهم بالسذاجة، لكن الله يقرر أنهم السفهاء لغياب عقولهم عن إدراك الحق. وإذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا خلوا إلى شياطينهم عادوا إلى الكفر والتآمر، متقلبين حسب المصلحة. ويبيّن الله أن استهزاءهم يرتد عليهم، فيمهلهم في طغيانهم حتى يظنوا أنهم ناجون وهم في أشد الخسران. ويختم المقطع بصورة بليغة، إذ شبّه نفاقهم بتجارة خاسرة، باعوا فيها الهدى واشتروا الضلال، فضاعت منهم الحقيقة ولم يهتدوا إلى سبيل، فكانت تجارتهم خاسرة في الدنيا والآخرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الكافرين وحرمانهم من الهداية، جاءت هذه الآيات لتوضح حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، مما يبيّن أن الإيمان يحتاج إلى صدق داخلي لا مظاهر زائفة. الربط يُظهر تصنيفًا واضحًا للفئات الثلاث التي تناولتها السورة: المؤمنين، الكافرين، والمنافقين، لتتضح معالم كل فئة في الإيمان أو النفاق أو الكفر.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التركيز على صفات المنافقين وأسلوبهم في الخداع الآيات تعرض بوضوح طبيعة النفاق من خداع النفس إلى إظهار غير ما في القلب مما يجعل الصورة الذهنية عنهم واضحة وسهلة التذكر، 2. التشبيه بالخسارة التجارية الربط بين النفاق والتجارة الخاسرة يُسهل تذكر العاقبة حيث استبدلوا الهدى بالضلالة فخسروا الدنيا والآخرة، 3. التباين بين الظاهر والباطن وصف ازدواجيتهم بين إظهار الإيمان للمؤمنين ومجاراة شياطينهم يجعل النص مؤثرًا وسهل الاستيعاب باعتباره نموذجًا حيًّا للنفاق العملي.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف تصف الآيات حال المنافقين في الإيمان؟، 2. ما معنى مرض القلوب الذي ذكرته الآيات؟، 3. كيف يُظهر المنافقون الكذب والازدواجية بين المؤمنين وشياطينهم؟، 4. ما الجزاء الذي توعدت به الآيات المنافقين؟، 5. كيف وصفت الآيات تجارة المنافقين بالهدى والضلالة؟
مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18) أَوۡ كَصَيِّبٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٞ وَرَعۡدٞ وَبَرۡقٞ يَجۡعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ (19) يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُواْۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ (20)
عنوان موضوعي: أمثال المنافقين وحالهم في الإيمان
التفسير: تصوّر الآيات حال المنافقين تصويرًا بليغًا يجمع بين الظاهر الخادع والباطن الفاسد، فمثلهم كمثل من أوقد نارًا ليستضيء بها، فلما كشف له بعض الحق أطفأ الله نوره، فبقي في ظلمات لا يهتدي فيها إلى طريق، إشارة إلى أن إيمانهم كان سطحيًا لا يثمر هداية. ثم تُعرض صورة أخرى: كمثل من أصابه مطر غزير في جوّ يملؤه الرعد والبرق، فيضع أصابعه في أذنيه من شدة الخوف، دلالة على اضطرابهم كلما واجهوا تكاليف الإيمان ومحنه. فهم صمٌّ لا يسمعون الحق سماع قبول، وبكم لا ينطقون به، وعمي لا يبصرون نوره، يترددون بين الإيمان والكفر دون ثبات. والبرق الذي يكاد يخطف أبصارهم يرمز إلى ومضات من الهداية تلوح لهم ثم يرفضونها، فيمضون في ظلمات نفاقهم، ولو شاء الله لأذهب سمعهم وأبصارهم، فهو القادر على كل شيء.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن وصفت الآيات السابقة صفات المنافقين وأفعالهم، جاءت هذه الآيات لتوضّح حالهم بأمثال حسية تُبرز تناقضهم وتذبذبهم في الإيمان، وتُظهر أنهم لا يثبتون على نور الهداية، لأن باطنهم يخالف ظاهرهم. الربط يُظهر أن المنافقين يعيشون صراعًا داخليًا دائمًا بين نور الإيمان وظلمات النفاق.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التشبيه الحسي لحال المنافقين استخدام مثل النار ثم المطر في الظلام يرسم صورًا بصرية قوية تسهّل حفظ وفهم طبيعة النفاق كضياع واضطراب في الإدراك والاتجاه، 2. ربط المثل بعجز المنافق عن التمسك بالنور الآيات توضح أن المنافقين فقدوا الاستفادة من نور الهداية بسبب كفرهم أو ضعف إيمانهم مما يُسهّل فهم ارتباط المثل بحقيقة حالهم، 3. إبراز الخوف والتردد في المواقف الصعبة تصوير المنافقين وهم يضعون أصابعهم في آذانهم أو يكاد البرق يخطف أبصارهم يبين كيف أن الخوف من التكاليف والابتلاءات يعطلهم مما يعزز ربط المعنى بالموقف العملي.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المثل الأول الذي ضربته الآيات للمنافقين؟، 2. ما الرمزية وراء إطفاء الله نور النار التي أوقدها المنافقون؟، 3. ما المثل الثاني الذي ضربته الآيات وما دلالته؟، 4. كيف تصف الآيات خوف المنافقين من التكاليف والابتلاءات؟، 5. ما الذي تؤكده الآيات عن قدرة الله على التعامل مع المنافقين؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (21) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (22)
عنوان موضوعي: دعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده
التفسير: توجه الآيات نداءً عامًا إلى جميع الناس، تدعوهم فيه إلى عبادة الله وحده، لأنه هو الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأمم، وهذا وحده كافٍ لجعل عبادته واجبة، فهي الطريق إلى تحقيق التقوى والخضوع لخالق كل شيء. ثم تُذكّر الآيات بنِعَم الله الظاهرة التي لا يستطيع أحد إنكارها، لتكون دليلاً على استحقاقه للعبادة دون سواه. فمن هذه النعم: أن الله جعل الأرض فراشًا، أي ممهدة مستقرة صالحة للحياة والسكن، وجعل السماء بناءً، تحمي الأرض وتزينها. كما أنه أنزل من السماء ماءً، أي المطر، الذي أنبت به الثمرات رزقًا للناس، وهذه النعم كلها مُسخّرة للإنسان دون حولٍ منه ولا قوة، مما يدل على رحمة الله وقدرته. وتختم الآيات بتحذير شديد من أن يُشرك الإنسان بالله أحدًا أو يتخذ له أندادًا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون يقينًا أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فكيف يُسوّى بين الخالق والمخلوق؟! إن هذا التذكير يُمهّد لما بعده من آيات التحدي والإعجاز في القرآن، ويُؤسس قاعدة التوحيد في قلب كل من أراد الهداية.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن أصناف الناس الثلاثة (المؤمنين، الكافرين، والمنافقين)، جاء هذا المقطع بدعوة عامة لجميع الناس إلى عبادة الله وتوحيده، مما يبرز أن أساس الرسالة القرآنية هو توحيد الله والاعتراف بفضله ونِعَمه. الربط يُظهر أن الهداية الحقيقية تبدأ بالتوحيد الخالص لله، ثم بالاعتراف بنعمه التي تدل على وحدانيته وقدرته.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. النداء العام “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” يميز المقطع كدعوة شاملة لكل البشر مما يسهل استحضاره عند التمييز بين الخطاب العام للناس والخطاب الخاص بالمؤمنين، 2. ربط التوحيد بالنعم الظاهرة استعراض نعم الله كالأرض والسماء والماء والنبات يعزز الفهم بأن هذه الآلاء دالة على الوحدانية مما يجعل الحفظ مرتبطًا بالعقل والقلب معًا، 3. التحذير من الشرك في ختام المقطع ختم الآية بالتحذير من اتخاذ الأنداد يُبرز مركزية التوحيد ويجعل الرسالة قوية ومؤثرة وسهلة الاستذكار.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الدعوة التي وجهتها الآيات للناس؟، 2. ما النعم التي ذكرتها الآيات كأدلة على استحقاق الله للعبادة؟، 3. ما المقصود بجعل الأرض فراشًا والسماء بناءً؟، 4. ما التحذير الذي ختمت به الآيات هذا المقطع؟، 5. كيف تبرز الآيات أن عبادة الله يجب أن تكون قائمة على التوحيد؟
وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (23) فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ (24)
عنوان موضوعي: تحدي القرآن للكافرين وتحذيرهم من عذاب النار
التفسير: توجّه الآيات خطابًا مباشرًا إلى المشككين في القرآن الكريم، وتدعوهم إلى إثبات صدق دعواهم إن كانوا يظنون أن هذا الكتاب من تأليف محمد ﷺ أو غيره من البشر، فتتحداهم بأن يأتوا بسورةٍ من مثله، تماثله في البلاغة والفصاحة والهداية، وهي خصائص لا يستطيع البشر الإتيان بمثلها. وتُسند إليهم الحرية الكاملة في الاستعانة بمن يشاؤون من الشهداء والأعوان في محاولة إتمام هذا التحدي، بشرط أن يكونوا صادقين في ادّعائهم وشكهم. لكن في الوقت نفسه، تؤكد الآيات استحالة تحقق هذا التحدي، لأن القرآن كلام الله الذي لا يُضاهى، وتربط هذا التحدي بتحذير شديد لمن يُعرض عنه، فتُحذّر الكافرين من نارٍ وقودها الناس والحجارة، في وصفٍ يُبرز هولها وشدتها، فهي ليست نارًا عادية، بل نارًا خُصصت للعذاب، وقد أُعدت خصيصًا للكافرين الذين أعرضوا عن الحق بعد أن تبيّن لهم وضوحه. ويحمل هذا التحذير في طياته عدالة الله، فهو لا يُعذّب إلا بعد إقامة الحجة، وقد جاءت الآيات لتقيم هذه الحجة على من يكذب أو يشك، فتُظهر أن النتيجة الطبيعية لتكذيب القرآن بعد وضوحه، هي العذاب الأليم في نار أُعدت لمن استكبر وتمادى.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده في المقطع السابق، يرد هذا المقطع لتثبيت صدق الرسالة القرآنية من خلال التحدي بإعجاز القرآن، وتحذير المشككين من عواقب التكذيب. الربط يُظهر أن الإيمان يستند إلى الدليل الواضح والعقل، وأن التكذيب بعد إقامة الحجة يقود حتمًا إلى العذاب.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. بدء المقطع بالتحدي “وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ” يجعل الآية مميزة في الأسلوب حيث يبدأ الخطاب بالمخاطبة المباشرة للمشككين مما يسهل حفظه، 2. الربط بين العجز عن الإتيان بسورة والنار المعدّة للكافرين يوضح العلاقة بين إقامة الحجة والجزاء، مما يخلق صورة ذهنية قوية للعاقبة، 3. المقابلة بين الشك واليقين وبين العجز والإيمان توضح أن من لم يؤمن بعد ثبوت العجز عن معارضة القرآن يستحق العقاب، مما يُسهّل تذكر المعنى والتسلسل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما التحدي الذي وجهته الآيات للمشككين في القرآن؟، 2. كيف سمحت الآيات للمشككين بمحاولة إثبات شكوكهم؟، 3. ما الذي تؤكده الآيات عن إمكانية تحقيق هذا التحدي؟، 4. ما وصف النار التي أُعدت للكافرين؟، 5. كيف تربط الآيات بين الإيمان بالقرآن وتجنب عذاب النار؟
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25).
عنوان موضوعي: بشارة المؤمنين بالجنة ونعيمها
التفسير: تدعو الآية النبي ﷺ إلى تبشير المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، بأن لهم في الآخرة جزاءً عظيمًا يتمثل في جنات تجري من تحتها الأنهار، مما يدل على وفرة النعيم واستمراريته بلا انقطاع. وحين يُرزقون بثمار الجنة، يتعرفون عليها ويقولون إنها مشابهة لما رُزقوا به من قبل، أي أنها تُشبه ثمار الدنيا في الشكل لكنها تختلف عنها في الطعم واللذة، مما يضيف إليهم شعورًا بالطمأنينة والرضا. ويُعطَون أيضًا أزواجًا مطهرة، خالية من كل ما يُنقص صفاء العلاقة من خُلق أو خِلقة، في إشارة إلى الكمال والنقاء في العلاقات في الجنة. وتُختم الآية بالوعد الأعظم: أنهم يخلدون في هذا النعيم الأبدي، لا ينقطع عنهم أبدًا، فلا موت ولا زوال، بل نعيم دائم في رضا الله وجواره.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن التحدي للمشككين وعقاب الكافرين بالنار، جاءت هذه الآية لتبيّن المقابل للمؤمنين الذين يستجيبون لرسالة الله، وهو الجنة ونعيمها. الربط يبرز عدل الله، حيث يقابل التحذير من النار بالترغيب في الجنة، ليوازن بين الخوف والرجاء في قلوب المؤمنين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من التحذير من النار إلى التبشير بالجنة يُظهر التوازن القرآني بين الوعيد والوعد، مما يجعل الحفظ أسهل بتقابل المعنى، 2. تفصيل نعيم الجنة بالأوصاف الحسية والمعنوية كالأنهار والثمار والأزواج والخلود يكوّن مشهدًا متكاملًا يسهل تذكّره، 3. الربط بين الإيمان والعمل الصالح والجزاء يوضّح أن الجنة ليست بالأماني، بل ثمرة للإيمان الصادق والعمل الصالح مما يسهل ترسيخ المعنى في الذاكرة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما البشرى التي وجهتها الآية للمؤمنين؟، 2. كيف وصفت الآية جنات المؤمنين في الآخرة؟، 3. ما معنى قول المؤمنين: “هذا الذي رُزِقْنَا من قبل”؟، 4. ما الصفات التي ذكرتها الآية للأزواج في الجنة؟، 5. ما الذي يميز نعيم الجنة بالنسبة للمؤمنين وفق هذه الآية؟
۞إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ (26) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (27)
عنوان موضوعي: الأمثال في القرآن وموقف الناس منها.
التفسير: توضح الآيات أن الله لا يستحيي أن يضرب الأمثال، ولو كانت صغيرة كالبعوضة أو أقل، فالمقصود هو الحكمة والمعنى، لا حجم المثل، فالأمثال الربانية تكشف الحقائق وتثبتها في القلوب. يُظهر المقطع انقسام الناس تجاه الأمثال: فالمؤمنون يرونها حقًا من ربهم فتزيدهم إيمانًا ويقينًا، أما الكافرون فيسخرون منها ويعترضون قائلين: (ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟) فيزدادون بها ضلالًا لعنادهم واستكبارهم. ويبيّن الله أنه يهدي بالمثل من كان أهلاً للهداية، ويضل به الفاسقين الخارجين عن طاعته، الذين وصفهم بثلاث صفات بارزة: أنهم ينقضون عهد الله بعد توثيقه، ويقطعون ما أمر الله بوصله من رحم وروابط إيمانية، ويفسدون في الأرض بالعداوة والمعصية. وتُختم الآيات ببيان أن هؤلاء هم الخاسرون، إذ استبدلوا رضا الله وهدايته بالضلال والخسران في الدنيا والآخرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن وعد الله للمؤمنين بالجنة وعذاب الكافرين بالنار، جاءت هذه الآيات لتوضّح أن الله يبيّن الحق بالأمثال، فيجعلها وسيلة لهداية المؤمنين وضلال الكافرين، بحسب ما في قلوبهم من صدق أو عناد.
الربط يُظهر عدل الله في هداية من يستحقها وإضلال من يعاند ويكفر.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من ذكر الثواب والعقاب إلى وسيلة الإيضاح بالأمثال يُبرز دور الأمثال في تقريب المعاني بعد عرض الجزاء، مما يسهل حفظ تسلسل المعاني، 2. التركيز على صفات الفاسقين مثل نقض العهد وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض يجعل المقطع منظمًا وسهل الاستيعاب بالتعداد، 3. التأكيد على عدل الله في الهداية والإضلال يُرسخ أن الضلال نتيجة لاختيار الإنسان وليس ظلمًا من الله، مما يثبّت المعنى في الذاكرة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. لماذا يضرب الله الأمثال في القرآن؟، 2. كيف يختلف موقف المؤمنين عن الكافرين تجاه الأمثال؟، 3. من هم الذين يُضلهم الله وفق الآيات؟، 4. ما الصفات الثلاث التي وصفت بها الآيات الفاسقين؟، 5. كيف تُبيّن الآيات أن نقض العهود والإفساد في الأرض يؤدي إلى الخسارة؟
كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (28) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (29)
عنوان موضوعي: دلائل قدرة الله على الخلق والإحياء
التفسير: تعبّر الآيات عن تعجب واستنكار لكفر الإنسان بالله رغم وضوح دلائل قدرته وعظمته، فالله هو الذي خلق الإنسان بعد أن كان ميتًا لا وجود له، ثم أحياه، ثم يميته بعد انتهاء أجله، ثم يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء، فيسير الإنسان في دورة الخلق والموت والإحياء وفق مشيئة الله وقدرته. ثم تبيّن الآيات أن الله خلق كل ما في الأرض لخدمة الإنسان، من أرزاق ومعايش وأسباب، ثم استوى إلى خلق السماوات السبع بإحكام وإتقان، فجعلها في نظام دقيق يشهد بعلمه الشامل وحكمته البالغة. وهكذا تجمع الآيات بين دلائل القدرة في خلق الإنسان، ودلائل الإحكام في خلق الكون، لتؤكد أن كل ما في الوجود شاهد على عظمة الخالق، وأن الكفر بعد هذه البراهين هو أعظم درجات الجحود.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الأمثال الإلهية وتأثيرها في تمييز المؤمنين من الكافرين، تأتي هذه الآيات لتؤكد بالأدلة الكونية والواقعية دلائل قدرة الله على الإحياء والخلق، مما يجعل الكفر به بعد ذلك سفهًا ومخالفةً للفطرة والعقل.
الربط يُظهر أن الإيمان الصادق يقوم على التأمل في خلق الله وآياته الدالة على قدرته وعلمه.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التسلسل المنطقي في الحديث عن مراحل حياة الإنسان من الموت إلى الإحياء ثم الموت ثم البعث يجعل ترتيب الأفكار متدرجًا وسهل التذكر، 2. الربط بين خلق الأرض والسماوات خلق الأرض لخدمة الإنسان ثم رفع السماوات السبع بإتقان يرسخ شمولية الخلق في الذهن، 3. التأكيد على التفكر في خلق الله بعد عرض الأمثال الإلهية يأتي الحديث عن الخلق والإحياء ليبيّن أن التفكر في الكون طريق إلى الإيمان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما التعجب الذي أثارته الآيات بشأن كفر الإنسان؟، 2. ما المراحل التي يمر بها الإنسان كما وردت في الآيات؟، 3. ماذا تقول الآيات عن خلق الأرض والسماوات؟، 4. كيف تؤكد الآيات على علم الله وحكمته في الخلق؟، 5. ما العلاقة بين خلق الله للإنسان والكون ودعوته إلى الإيمان؟
وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (31) قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ (32) قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ (33)
عنوان موضوعي: خلق آدم وتعليمه وعلاقته بالملائكة
التفسير: تتناول الآيات مشهدًا عظيمًا من مشاهد الخلق الأول، حيث أعلن الله تعالى للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، أي مَن يخلف بعضه بعضًا في عمارتها وطاعة الله فيها. فتساءلت الملائكة عن الحكمة من هذا الاختيار، إذ علموا أن هذا المخلوق قد يقع منه الإفساد وسفك الدماء، وهم أنفسهم يسبحون بحمد الله ويقدسونه، فسألوا سؤال المتعلم المستفهم لا المعترض. فأجابهم الله تعالى بأن علمه أوسع من علمهم، وأن في خلق الإنسان حكمًا خفية لا يدركونها.
ثم أظهر الله فضل آدم عليهم حين علّمه أسماء كل الأشياء، أي علمه القدرة على الإدراك والتعبير والمعرفة، وهي ميزة لم تُمنح للملائكة. ولما عجزت الملائكة عن معرفة هذه الأسماء، أمر الله آدم أن يخبرهم بها، ففعل، فتبين لهم سموّ مكانته وقدرته على العلم والتعليم.
تُختتم الآيات بتأكيد أن الله هو العليم الحكيم، يعلم ما يُعلن الخلق وما يُخفون، وأن كل ما يجري في السماوات والأرض داخل في علمه وحكمته، مما يدل على كمال علم الله في الخلق والتدبير.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد عرض دلائل قدرة الله على الخلق والإحياء في الكون، جاء هذا المقطع ليُبرز أعظم مظهر من مظاهر هذه القدرة: خلق الإنسان واختياره للخلافة في الأرض، بما وهبه الله من العقل والعلم.
الربط يُظهر أن الخلق الإلهي ليس عبثًا، بل هو قائم على حكمة وعلم شامل، وأن مكانة الإنسان في الأرض مقررة بعلم الله وقدرته.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من الخلق العام إلى الخلق الخاص يربط المقطع بين قدرة الله على خلق السماوات والأرض وقدرته على خلق الإنسان وتكريمه بالعلم، 2. بيان فضل العلم والتعليم في التميز الإنساني تتابع الأحداث من تعليم الأسماء إلى اعتراف الملائكة بالعجز يُظهر منزلة العلم مما يسهل الحفظ عبر التسلسل المنطقي، 3. ختام المقطع بعلم الله الشامل يربط بين علم الإنسان الموهوب له وبين العلم المطلق لله في كل ما خفي وظهر مما يُرسّخ المعنى الإيماني.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الإعلان الذي أخبر الله به الملائكة في هذا المقطع؟، 2. كيف ردت الملائكة على إعلان الله عن جعل خليفة في الأرض؟، 3. ما الذي ميز الله به آدم عن الملائكة؟، 4. كيف أثبت آدم علمه أمام الملائكة؟، 5. ما الذي تؤكده الآيات عن علم الله بالغيب؟
وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ (34) وَقُلۡنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيۡطَٰنُ عَنۡهَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ (36) فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (37) قُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (38) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (39)
عنوان موضوعي: سجود الملائكة لآدم وابتلاء الشيطان وهداية الله للإنسان
التفسير: تسرد الآيات مشهدًا من أعظم مشاهد البداية البشرية، حيث أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، سجود تكريم وإجلال لمكانته التي شرفه الله بها، لا سجود عبادة، فامتثل الملائكة جميعًا لأمر الله، إلا إبليس، الذي أبى واستكبر، وكان من الجن، فكفر وعصى أمر ربه، فاستحق اللعنة والطرد من رحمته.
ثم أكرم الله آدم وزوجه بأن أسكنهما الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها حيث شاءا، إلا شجرة واحدة نهاهما عن الاقتراب منها اختبارًا لطاعتهما، لكن الشيطان وسوس لهما وغرّهما حتى أكلا من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما، وأُهبطا إلى الأرض ليبدآ حياة الاختبار والعمل والعبادة.
ومع ذلك، فتح الله لهما باب التوبة، فألهم آدم كلمات تاب بها، فتاب الله عليه وتجاوز عن ذنبه برحمته، ليُعلّم البشرية أن باب التوبة مفتوح ما دام العبد نادمًا صادقًا.
وتُختم الآيات بسنّة إلهية باقية: أن الله سيرسل إلى البشر هدًى من عنده، فمن استجاب له وسار على طريق الإيمان، فله الأمن والسكينة في الدنيا، ولا خوف عليه في الآخرة، وأما من كفر بآيات الله واستكبر عنها، فجزاؤه النار خالدًا فيها، جزاءً وفاقًا لما اختاره من الضلال والكفر.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن خلق آدم وتعليمه الأسماء وفضله على الملائكة، يأتي هذا المقطع ليكمل القصة بذكر سجود الملائكة له، وابتلاء الشيطان له بالوسوسة، وتوبته بعد ذلك، مما يوضح مكانة الإنسان وابتلاءه في دار العمل والاختبار.
الربط يُظهر أن خلافة الإنسان في الأرض مشروطة بالطاعة والاستجابة لهدى الله، وأن الهداية هي طريق النجاة من كيد الشيطان.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التسلسل في الأحداث من السجود لآدم إلى إكرامه في الجنة ثم وسوسة الشيطان فالتوبة والهداية هذا التتابع القصصي يُسهّل تذكر الآيات باعتبارها مراحل مترابطة، 2. التفريق بين من يتبع هدى الله ومن يكفر بآياته الربط بين التوبة والرحمة للهداية في مقابل العذاب للكافرين يوضح العاقبة لكل فريق، 3. الارتباط بالمفهوم العام لاختبار الإنسان في طاعته الانتقال من تكريم آدم إلى ابتلائه يُبرز أن خلافة الإنسان في الأرض مبنية على طاعته لله ومجاهدته للشيطان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهه الله للملائكة بشأن آدم؟، 2. كيف تصرف إبليس عند أمر السجود لآدم؟، 3. ما النهي الذي وجهه الله لآدم وزوجه في الجنة؟، 4. كيف أثرت وسوسة الشيطان على آدم وزوجه؟، 5. ما الجزاء الذي وعد الله به من يتبع هدايته؟ وما مصير الذين يكفرون؟
يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ (40) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ (41) وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (42) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ (43) ۞أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ (44) وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ (45) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ (46) يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ (47) وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ (48)
عنوان موضوعي: دعوة بني إسرائيل إلى الإيمان وذكر نعم الله والتحذير من عاقبة الكفر
التفسير: تبدأ الآيات بنداء خاص لبني إسرائيل، يدعوهم الله فيه إلى تذكّر نعمه العظيمة التي أنعم بها عليهم، من النبوة، والكتب، والنجاة من الطغاة، ويأمرهم بالوفاء بالعهد الذي قطعوه مع الله، من الإيمان والطاعة والتقوى، مقابل أن يفي الله لهم بوعده بالنصر والهداية والجزاء الكريم. وتدعوهم الآيات إلى الإيمان بالقرآن الكريم الذي جاء مصدقًا لما معهم من التوراة، وتحذرهم من أن يكونوا أول من يكفر به عن علم وحسد.
وتنهاهم الآيات عن استبدال آيات الله بثمن قليل، أي بيع الدين بالدنيا، وتحثهم على تقوى الله وحده، وتحذرهم من خلط الحق بالباطل أو كتمان ما في كتبهم من البشارة بالنبي محمد ﷺ. كما تأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما ركنان أساسيان لتحقيق الإيمان العملي.
ثم توجه إليهم توبيخًا على تناقضهم، إذ يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم رغم أنهم يتلون الكتاب ويعلمون الحق، في دعوةٍ إلى التزام ما يدعون إليه قولًا وعملًا. وتحثهم الآيات على الاستعانة بالصبر والصلاة، وتصفها بأنها عبادة عظيمة، لكنها ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يؤمنون بلقاء الله ويوقنون بالرجوع إليه.
وتُختتم الآيات بتذكيرهم بنعمة التفضيل على العالمين في زمانهم، والتحذير من يوم القيامة، يوم لا تنفع فيه الشفاعة، ولا يُقبل فيه فداء، ولا يُغاث فيه من يطلب النصرة، في إشارة إلى أن النجاة لا تكون إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن خلق الإنسان وابتلائه في الأرض، ينتقل الخطاب إلى قصة بني إسرائيل الذين جُعلوا خلفاء من قبل، لكنهم نقضوا العهود مع الله، فصاروا مثالًا لمن لم يشكر النعمة.
الربط يُظهر أن سنّة الله ماضية في عباده: من شكر نِعمه ازداد هدى، ومن كفر بها استحق العقوبة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. تكرار نداء “يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ” يربط الموضوع ويقسم الآيات إلى وحدات متتابعة مما يسهل تذكّر الأحداث والمضامين، 2. التذكير بالنعم والتحذير من كتمان الحق الجمع بين النعمة والتحذير يرسّخ أن الشكر يكون بالعمل لا بالادّعاء، 3. الربط بين الوفاء بالعهد وعواقب الكفر إظهار أن الإيمان الصادق يقوم على العمل والوفاء بالعهد بينما الكفر يجلب العقوبة، 4. الاستعانة بالصبر والصلاة التأكيد على أن الصبر والصلاة وسيلتان للثبات على الإيمان خاصة في وجه الفتن والتحذيرات الأخروية.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الدعوة التي وجهتها الآيات لبني إسرائيل في بداية المقطع؟، 2. ما التحذير الذي جاء في الآيات بشأن كتمان الحق؟، 3. ما العلاقة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبين تحقيق الخشوع؟، 4. ماذا تعني الآيات بتحذير بني إسرائيل من يوم القيامة؟، 5. كيف يبرز المقطع أهمية الصدق والوفاء بعهد الله؟
وَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞ (49) وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ (50) وَإِذۡ وَٰعَدۡنَا مُوسَىٰٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةٗ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَنتُمۡ ظَٰلِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوۡنَا عَنكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ (52)
عنوان موضوعي: تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم وعفوه عنهم
التفسير: تذكّر الآيات بني إسرائيل بنعمة الله الكبرى حين أنقذهم من طغيان فرعون الذي استعبدهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، وكان ذلك امتحانًا عظيمًا ليُظهر صبرهم وإيمانهم. ثم تذكر معجزة شق البحر لموسى عليه السلام، حيث فلقه الله فنجّى المؤمنين وأغرق فرعون وجنوده أمام أعينهم، في مشهد يجلّي قدرة الله وعدله في نصرة الحق وإهلاك الظالمين. وبعد النجاة، وقعوا في خطيئة عظيمة باتخاذ العجل إلهًا، رغم ما رأوه من دلائل التوحيد، فابتلاهم الله بذلك ليطهّر قلوبهم من الانحراف. ومع ذلك، شملتهم رحمته حين تاب عليهم بعد توبتهم، فكانت دروسًا متتابعة في نعم الله وعفوه، ودعوةً لهم إلى الشكر والوفاء بعهد الإيمان.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن دعاهم الله في المقطع السابق إلى تذكّر نعمه ووفاء العهد والإيمان بالقرآن، جاء هذا المقطع ليُفصّل بعض تلك النعم التاريخية العظيمة، مثل إنقاذهم من فرعون وشق البحر والعفو عن عبادتهم للعجل، ليُظهر كيف قوبلت النعم بالجحود، ويُبرز الربط المفارقة بين عظمة النعمة وضعف الاستجابة، مذكّرًا بأن الشكر الحقيقي يكون بالعمل لا بالكلام.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. تسلسل النعم من الإنقاذ إلى العفو عرض النعم بترتيبها الزمني من إنقاذهم من فرعون، إلى شق البحر، ثم عبادتهم للعجل، وأخيرًا عفو الله عنهم يجعل المقطع قصصيًا يسهل حفظه واستحضاره، 2. المقارنة بين النعمة والخطيئة الربط بين الإحسان الإلهي والذنب البشري يُبرز التناقض الذي يقوّي أثر المعنى في الذاكرة، 3. تأكيد العفو بعد الذنب يُظهر سعة رحمة الله بعد الغفران مما يعمّق المعنى التربوي ويُسهّل استذكار ختام المقطع بأنه دعوة للشكر، 4. ربط الابتلاء بالعفو توضيح أن البلاء كان اختبارًا والعفو نعمة يُرسّخ أن سنة الله قائمة على العدل والرحمة معًا.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما العذاب الذي كان آل فرعون يذيقونه لبني إسرائيل؟، 2. ما المعجزة التي أنقذ الله بها بني إسرائيل من فرعون؟، 3. ماذا فعل بنو إسرائيل أثناء غياب موسى عليه السلام؟، 4. كيف تعامل الله مع بني إسرائيل بعد عبادتهم للعجل؟، 5. ما الهدف من تذكير بني إسرائيل بهذه الأحداث؟
وَإِذۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡفُرۡقَانَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ (53) وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلۡعِجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ عِندَ بَارِئِكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (54) وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثۡنَٰكُم مِّنۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ (56) وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَأَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ (57)
عنوان موضوعي: إتمام النعم على بني إسرائيل وتصحيح أخطائهم
التفسير: تتابع الآيات تذكير بني إسرائيل بنعم الله العظيمة عليهم، إذ أنزل على موسى التوراة والفرقان ليكونا نورًا وهداية تميز بين الحق والباطل بعد انحرافهم، ثم تذكر ذنبهم الجسيم حين عبدوا العجل بعد النجاة من فرعون، فأمرهم موسى أن يتوبوا بقتل أنفسهم توبة خالصة، فتابوا وتقبل الله توبتهم برحمته. وتشير الآيات إلى جهلهم حين طلبوا رؤية الله علنًا، فعوقبوا بالصاعقة ثم أحياهم الله رحمةً بهم وعبرةً لمن بعدهم. ثم يُذكّرهم الله بفضله في التيه، إذ ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى رزقًا طيبًا، لكنهم كفروا النعم وبدّلوا الشكر جحودًا، فاستحقوا حرمان البركة، في مشهد يجمع بين التحذير والرحمة، والابتلاء والنعمة، لتقرير أن التوبة سبيل النجاة، وأن الكفر سبب الهلاك.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن ذكّر الله بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون وعفوه عنهم، يواصل هذا المقطع بيان النعم المتتابعة عليهم، مقرونة بتكرار أخطائهم وطرق تصحيحها، ليبيّن كيف يقابلون الرحمة الإلهية بالجحود والعصيان.
الربط يُظهر أن سنّة الله في الأمم قائمة على العدل والرحمة، فمن شكر نجا، ومن كفر هلك.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التتابع بين النعم والخطايا عرض المقطع للنعم الكبرى كالتوراة والفرقان والغمام والمن والسلوى، ثم تخللها بخطايا بني إسرائيل كعبادة العجل وطلب رؤية الله يجعل النص متسلسلًا ومنطقيًا يسهل حفظه، 2. المقابلة بين العقوبة والرحمة الربط بين الصاعقة التي أصابتهم ثم الإحياء بعدها، وبين الذنب ثم قبول التوبة يُظهر توازن عدل الله ورحمته، 3. الجمع بين النعم الدينية والدنيوية عرض النعم الروحية (الكتاب والهداية) إلى جانب النعم المادية (الطعام والظل) يوسع دائرة الفهم ويُسهّل استرجاع المعنى الشامل للنعم، 4. التكرار التربوي في عرض الخطأ ثم المغفرة يعزز في الذهن القاعدة الإيمانية أن التوبة تُصلح ما أفسده الذنب.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام؟، 2. ما الخطأ الذي ارتكبه بنو إسرائيل بعد إنقاذهم وكيف كانت توبتهم؟، 3. ما العقاب الذي نزل ببني إسرائيل عند طلبهم رؤية الله جهرة؟، 4. ما النعم التي أنعم الله بها عليهم أثناء التيه؟، 5. كيف تظهر الآيات توازن عدل الله مع رحمته في معاملة بني إسرائيل؟
وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رَغَدٗا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا وَقُولُواْ حِطَّةٞ نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَٰيَٰكُمۡۚ وَسَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ فَأَنزَلۡنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجۡزٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ (59)
عنوان موضوعي: أمر بني إسرائيل بدخول القرية ونتيجة عصيانهم
التفسير: توضح الآيات نعمة عظيمة أنعم الله بها على بني إسرائيل، حين أمرهم بدخول قرية مباركة يسّر الله لهم فيها الرزق الوفير والخير الدائم، فقال لهم: )كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا( أي تمتعوا بخيراتها دون عناء ولا حرمان، شكرًا لله على فضله. وأمرهم عند دخولها أن يدخلوا الباب سُجَّدًا، أي متواضعين خاشعين، شكرًا لله على النعمة، وأن يقولوا: )حِطَّةٌ( أي يا رب حُطّ عنا خطايانا واغفر ذنوبنا، وقد وعدهم الله إن فعلوا ذلك بالمغفرة وزيادة الثواب للمحسنين.
لكنهم بدّلوا أمر الله استهزاءً وسخرية، فغيّروا القول والفعل، فدخلوا متكبرين وقالوا كلمات غير التي أُمِروا بها، فأصبحوا من الظالمين الفاسقين. فأنزل الله عليهم رجزًا من السماء، وهو عذاب مهلك عقابًا على تعديهم وطغيانهم، ليكون ذلك جزاءً على استهزائهم بأوامر الله بعد تكرار نعمه عليهم. وهكذا تُظهر الآيات أن الشكر والطاعة سبب للنعمة، وأن التمرد والجحود سبب للعقوبة والحرمان.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن ذكّرت الآيات السابقة بنعم الله المتتابعة على بني إسرائيل وعفوه عنهم، جاء هذا المقطع ليعرض موقفًا جديدًا من مواقفهم حين أنعم الله عليهم بدخول القرية، لكنهم استقبلوا النعمة بالعصيان والتحريف، فاستحقوا العقوبة.
الربط يُظهر أن سنّة الله ماضية: من شكر ازداد نعمة، ومن عصى نال العقوبة، وأن تكرار ذنوب بني إسرائيل رغم النعم هو سبب سخط الله عليهم.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: يُلاحظ في هذا المقطع ترابطٌ واضح بين أجزائه ومعانيه؛ إذ يبدأ بعرض النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حين أُمروا بدخول القرية والأكل من خيراتها، ثم يختم بذكر العقوبة التي نزلت بهم بسبب تحريفهم وعصيانهم، فيتبيّن من ذلك أثر الشكر في دوام النعمة وأثر العصيان في زوالها، مما يسهل حفظ تسلسل الأحداث في الذهن. كما تتّضح الألفاظ المحورية في هذا المقطع مثل كلمة “حِطَّة” التي تعني طلب المغفرة، وكلمة “رِجزًا” التي تعني العذاب، فتجعل المعنى قريبًا وواضحًا. ويُلحَظ كذلك تكرار النمط التربوي في القصة: نعمة يتبعها معصية ثم عقوبة، وهو نسق يتكرر في مقاطع قصة بني إسرائيل، مما يكوّن ترابطًا ذهنيًا يساعد على سهولة الحفظ واستحضار العبرة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل في هذا المقطع؟، 2. بماذا أمرهم الله عند دخول القرية؟، 3. ما المقصود بقولهم “حِطَّة”؟، 4. كيف غيّر الظالمون أمر الله؟، 5. ما الجزاء الذي أنزله الله عليهم نتيجة فسقهم؟
۞وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ (60) وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصۡبِرَ عَلَىٰ طَعَامٖ وَٰحِدٖ فَٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيۡرٌۚ ٱهۡبِطُواْ مِصۡرٗا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡتُمۡۗ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ (61) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (62)
عنوان موضوعي: نعمة الماء والطعام وشكر النعمة والإيمان الشامل
التفسير: تصوّر الآيات نعمة الله على بني إسرائيل حين استسقوا موسى (عليه السلام) في التيه، فأمره الله أن يضرب الحجر بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، لكل سبطٍ عينٌ يشرب منها، في معجزة تدل على قدرة الله ورحمته. ثم أُمروا أن يأكلوا من رزق الله دون فساد أو كفر، لكنهم قابلوا النعمة بالجحود حين ملّوا المنّ والسلوى وطلبوا طعامًا أدنى، من بقلها وعدسها وبصلها، فأنكر عليهم موسى ذلك قائلًا: (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)، فاستحقوا الذل والمسكنة وغضب الله لكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه بغير حق. وتختم الآيات ببيان أن النجاة لا تكون بالانتماء لقومٍ أو ملة، بل بالإيمان والعمل الصالح، فذلك طريق الأمن من الخوف والحزن لكل من صدق في إيمانه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر دخول القرية وأمرهم بالشكر والعصيان الذي قابلوه به، يأتي هذا المقطع ليعرض استمرار النعم المادية التي أنعم الله بها عليهم كالماء والطعام، وكيف قابلوا تلك النعم بالسخط والتذمر، ليُظهر أن النعمة لا تدوم إلا بالشكر والطاعة، وأن الشكر سبيل النجاة، والجحود سبب الهلاك، في تتابعٍ يربط بين قصص بني إسرائيل والعبرة منها لكل مؤمن.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التسلسل بين النعم والجحود عرض المقطع لمعجزتي الماء والطعام متبوعتين بجحود بني إسرائيل يجعل تسلسل الأحداث واضحًا ومترابطًا، مما يسهل حفظه واستدعاؤه، 2. الربط بين النعم والعقوبة بعد النعم العظيمة جاء العقاب بالذل والغضب الإلهي، مما يُظهر العلاقة السببية بين الشكر والرفعة، والكفر والمهانة، 3. الانتقال من الخاص إلى العام ختم المقطع ببيان أن النجاة ليست حكرًا على قوم، بل مشروطة بالإيمان والعمل الصالح، مما يجعل المعنى شاملًا ومؤسسًا لقاعدة دينية كلية يسهل تذكرها.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المعجزة التي أكرم الله بها بني إسرائيل عندما استسقوا موسى؟، 2. ما الطعام الذي ملّه بنو إسرائيل وطلبوا بدله طعامًا أدنى؟، 3. ما العقوبة التي نزلت ببني إسرائيل بسبب جحودهم؟، 4. ما الشرط الذي ذكرته الآيات لنيل الأجر والأمن من الخوف؟، 5. كيف توضح الآيات أن النجاة مرتبطة بالإيمان والعمل الصالح لا بالانتماء الديني؟
وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۖ فَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ (64) وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِي ٱلسَّبۡتِ فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ (65) فَجَعَلۡنَٰهَا نَكَٰلٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ (66)
عنوان موضوعي: ميثاق بني إسرائيل وعقوبة المعتدين في السبت
التفسير: تبيّن الآيات أن الله أخذ على بني إسرائيل ميثاقًا عظيمًا عند إنزال التوراة، إذ رفع فوقهم جبل الطور كأنه مظلة ليحملهم على أخذ الكتاب بقوةٍ وجدية، وأمرهم أن يتذكروا ما فيه ويعملوا به، وأن يتقوه في كل أمرٍ ونهي. ومع هذا التهديد البليغ والتذكير الشديد، تولّى كثيرٌ منهم ونقضوا العهد بعد أن عاهدوا، ولكن الله برحمته لم يُهلكهم فورًا، بل أمهلهم ومنحهم فرصة للتوبة.
ثم تسرد الآيات مثالًا واضحًا على عصيانهم، وهو اعتداؤهم في يوم السبت، اليوم الذي حُرّم عليهم فيه الصيد اختبارًا لطاعتهم، فتحايلوا على الأمر الإلهي بحيلٍ ماكرة، فاستحقوا عقوبة شديدة، إذ مسخهم الله قردة خاسئين، إهانةً لهم وجزاءً على تمرّدهم على أمره.
وجعل الله هذه العقوبة عبرةً لمن حضر الواقعة، وموعظةً للأجيال اللاحقة، ليعلم الناس جميعًا أن مخالفة أوامر الله لا تمرّ دون جزاء، وأن تقوى الله هي السبيل للسلامة من سخطه وعذابه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة نعم الله على بني إسرائيل وجحودهم المتكرر، جاء هذا المقطع ليبيّن نقضهم للميثاق الذي أخذوه على أنفسهم، مع ذكر نموذجٍ عملي من تجاوزهم وهو اعتداؤهم في السبت.
الربط يُظهر أن تجاوز حدود الله لا ينشأ فقط من الكفر بالنعم، بل أيضًا من ضعف الالتزام بالعهد، وأن العقوبة الإلهية جاءت لتكون زجرًا وعبرةً للآخرين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الميثاق والعقوبة رفع جبل الطور فوق رؤوسهم يدل على شدة الميثاق، ثم ذكر عقوبة المعتدين يوضح العلاقة بين الالتزام بالأوامر والعقوبة على تركها مما يسهل حفظ التسلسل، 2. الربط بين العصيان والعقوبة المتكررة يظهر أن نقض العهود والتحايل على أوامر الله يؤدي دائمًا إلى الهلاك كما في قصة السبت مما يجعل النمط متكررًا وسهل الاستذكار، 3. الربط بين العبرة والموعظة ختم القصة بجعلها عبرةً لمن حضر وموعظةً للمتقين يوضح الغاية التربوية من الحادثة ويجعل ختام المقطع واضحًا ومترابطًا في الذهن.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟، 2. كيف أظهر الله شدة هذا الميثاق؟، 3. ما الذنب الذي ارتكبه المعتدون في يوم السبت؟، 4. ما العقوبة التي أنزلها الله بهم؟، 5. كيف جعل الله هذه الحادثة عبرةً وموعظةً للناس؟
وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ (67) قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ (68) قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوۡنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ (69)
عنوان موضوعي: أمر بذبح بقرة وكشف تعنت بني إسرائيل في تنفيذ أوامر الله
التفسير: تسرد الآيات قصة أمر الله لبني إسرائيل على لسان موسى (عليه السلام) بذبح بقرةٍ لكشف جريمة قتل، ليظهر الحق وتتحقق العدالة، لكنهم بدل الطاعة سخروا وقالوا: (أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا)، فأنكر موسى استهزاءهم مستعيذًا بالله أن يكون من الجاهلين. ومع أن الأمر كان بسيطًا، بدأوا يكثرون الأسئلة والجدال: (مَا هِيَ؟)، (مَا لَوْنُهَا؟)، (مَا هِيَ صِفَتُهَا؟)، فكلما زاد سؤالهم زاد الله عليهم التشديد. وأُخبروا أنها بقرة لا صغيرة ولا كبيرة، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فصار العثور عليها صعبًا بسبب تعنتهم. وهكذا جسدت القصة طبيعتهم في المماطلة وكثرة الجدل بدل المسارعة إلى الطاعة، فكان ذلك سببًا في حرمانهم من التوفيق الإلهي.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الإيمان والعمل الصالح كأساسٍ للنجاة، جاءت هذه القصة لتعرض نموذجًا عمليًا مضادًا، إذ أظهر بنو إسرائيل تعنتًا ومماطلة في تنفيذ أمرٍ إلهيٍّ واضح، مما يعكس ضعف الإيمان وغياب الخضوع لله في أفعالهم.
الربط يُظهر أن الطاعة الكاملة لأمر الله علامة الإيمان الصادق، بينما الجدل والتردد سببٌ في حرمان التوفيق والبركة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. التدرج في الأسئلة تسلسل أسئلة بني إسرائيل حول البقرة (ما هي؟ ما لونها؟ ما صفاتها؟) يجعل المقطع مترابطًا يسهل حفظه عبر تتبع تطور الحوار، 2. استخدام الأوصاف المحددة مثل “لا فارض ولا بكر” و”صفراء فاقع لونها” و”تسر الناظرين” يمنح النص دقةً لغوية وصورًا بصريةً قوية تُعين على تذكره، 3. التكرار مع التغيير في قولهم “ادعُ لنا ربك يبين لنا” مع تنوع المطلوب في كل مرة يخلق نمطًا لغويًا متكررًا يسهل استحضاره وحفظه.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهه الله لبني إسرائيل في هذه الآيات؟، 2. كيف كان ردهم الأول على أمر موسى عليه السلام؟، 3. ما الصفات التي وصف الله بها البقرة في بداية الأمر؟، 4. ما اللون الذي حدده الله للبقرة في الوصف؟، 5. ما الدليل على تعنت بني إسرائيل وتأخرهم في تنفيذ أمر الله؟
قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلۡبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيۡنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ (70)قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلَا تَسۡقِي ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لَّا شِيَةَ فِيهَاۚ قَالُواْ ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ (71) وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا فَٱدَّٰرَٰءۡتُمۡ فِيهَاۖ وَٱللَّهُ مُخۡرِجٞ مَّا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ (72) فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (73)
عنوان موضوعي: المماطلة في تنفيذ أوامر الله ومعجزة إحياء المقتول بالبقرة
التفسير: تواصل الآيات عرض موقف بني إسرائيل تجاه أمر الله بذبح بقرة، حيث أبدوا المماطلة وطلبوا مزيدًا من التوضيح، مدّعين أن البقر تشابه عليهم، مع تعهدهم أخيرًا بأنهم – إن شاء الله – سيهتدون، وهي أول مرة يذكرون فيها مشيئة الله. فأخبرهم موسى أن الله يأمرهم ببقرة لا ذلولًا، لا تُستخدم في حرث الأرض ولا في سقي الزرع، سليمة من العيوب، لا علامة فيها تخالف لونها، أي بقرة كاملة الصفات. عندها قالوا: “الآن جئت بالحق”، فذبحوها على كرهٍ منهم، وقد كادوا ألا يفعلوا. ثم تكشف الآيات سبب هذا الأمر، إذ وقعت جريمة قتل في بني إسرائيل واختُلف في القاتل، فتنازعوا حوله، فأراد الله أن يُظهر القاتل بمعجزة باهرة، فأمرهم أن يضربوا المقتول بجزء من البقرة المذبوحة، فلما فعلوا أحياه الله، فنطق باسم القاتل، فبان الحق. وفي هذه المعجزة برهان على قدرة الله على إحياء الموتى، وتصديق لرسالة موسى عليه السلام، وعظة لبني إسرائيل لعلهم يعقلون ويتعظون.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: جاء هذا المقطع مكمّلًا لقصة ذبح البقرة، مبيّنًا تسلسل الحوار بين موسى وبني إسرائيل، وموضحًا الحكمة من الأمر الإلهي، وهي كشف القاتل بطريقة إعجازية تدل على حكمة الله في أوامره، وإن خفيت على الناس أولًا.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. تكرار عبارة “ادعُ لنا ربك يبين لنا” في كل مرة مع اختلاف المطلوب يربط الآيات ببعضها، 2. التدرّج في وصف البقرة من صفات عامة إلى دقيقة يسهل الحفظ عبر التسلسل الذهني، 3. ختم القصة بالمعجزة الكبرى في إحياء المقتول يجعلها نقطة التذكّر البارزة التي تربط القصة بالقدرة الإلهية.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما سبب استمرار بني إسرائيل في التسويف؟، 2. ما الصفات التي طلبها الله في البقرة؟، 3. متى نفذ بنو إسرائيل الأمر؟، 4. ما الحكمة من الأمر بذبح البقرة؟، 5. كيف أظهر الله القاتل الحقيقي؟ وما الدليل العقائدي في هذه المعجزة؟
ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةٗۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡمَآءُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ (74) ۞أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ (75)
عنوان موضوعي: قسوة قلوب بني إسرائيل وتحريفهم لكلام الله
التفسير: تبيّن الآيات أن قلوب بني إسرائيل قست بعد أن رأوا الآيات البينات التي أظهرها الله لهم، حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة، لأن الحجارة قد تتفاعل مع عظمة الله فتتفجر منها الأنهار أو تتشقق فيخرج منها الماء أو تهبط من خشية الله، بينما قلوبهم لا تخشع ولا تتأثر رغم كل ما شهدته من معجزات. وتوضح الآيات أن الله عليم بأعمالهم، لا يغيب عنه شيء مما يخفونه أو يبدونه. ثم تُنكر على المؤمنين طمعهم في إيمان بني إسرائيل، إذ إن فيهم من كان يسمع كلام الله ثم يحرّفه عمدًا بعد أن يعقله ويفهمه، فدلّ ذلك على أن مشكلتهم ليست في الجهل بل في العناد ومقاومة الحق.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة معجزة إحياء المقتول بالبقرة دليلاً على قدرة الله، يبيّن هذا المقطع أن قلوب بني إسرائيل لم تتأثر بهذه الآية العظيمة، بل ازدادوا قسوة وتحريفًا لكلام الله، مما يُظهر أن القلوب إذا خلت من الخشية لم تؤثر فيها أعظم المعجزات، وأن العناد يؤدي إلى القسوة والتحريف بعد البيان.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من مشهد الإحياء إلى مشهد القسوة يسهّل الربط بين القدرة الإلهية وردة فعل بني إسرائيل، 2. المقارنة بين قسوة القلوب والحجارة توفّر صورة بصرية قوية تسهّل تذكّر المقطع، 3. التحريف بعد السماع والفهم يربط بين القسوة العملية والقسوة القلبية مما يعمّق المعنى في الحفظ والفهم.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف وصفت الآيات قلوب بني إسرائيل بعد المعجزات؟، 2. ما الفرق بين قسوة الحجارة وقلوب بني إسرائيل؟، 3. كيف يظهر في الآيات علم الله بأعمالهم؟، 4. لماذا استنكرت الآيات طمع المؤمنين في إيمان بني إسرائيل؟، 5. ما الذنب الذي ارتكبه بعضهم تجاه كلام الله؟
وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ (76) أَوَ لَا يَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ (77)
عنوان موضوعي: نفاق بني إسرائيل وخداعهم للمؤمنين وكتمانهم للحق
التفسير: تصوّر الآيات نفاق فريقٍ من اليهود الذين كانوا يقولون للمسلمين (آمنا) وهم يخفون الكفر في قلوبهم، يخادعون المؤمنين ليكسبوا مكانةً بينهم، وهم في الحقيقة لا يؤمنون. فإذا خلوا إلى بعضهم لام بعضهم بعضًا على إظهار ما في التوراة من الحق الذي يوافق القرآن، خشية أن يحتج به المسلمون عليهم أمام الله يوم القيامة، فوبّخهم الله بقوله: (أَفَلَا تَعْقِلُونَ)، أي ألا تدركون أن الله يعلم خفاياكم؟ ثم جاءت الآية التالية لتبيّن أن الله يعلم ما يسرّونه وما يعلنونه، وأن محاولتهم إخفاء الحق لا تخفى عليه، فهو العليم بظاهرهم وباطنهم جميعًا.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بينت الآيات السابقة قسوة قلوب بني إسرائيل وتحريفهم لكلام الله، يكشف هذا المقطع جانبًا آخر من فسادهم، وهو نفاقهم وخداعهم للمؤمنين وكتمانهم لما يعلمون من الحق، فيتّضح أن الفساد متأصل في باطنهم كما هو في ظاهرهم، وأن ما يفعلونه من تظاهر بالإيمان ليس إلا ستارًا لإخفاء الحسد والخداع.
الربط: الربط يُظهر أن القسوة والتحريف قادا إلى النفاق والكتمان، وأن من اعتاد مخالفة الحق ظاهرًا ينتهي إلى إخفائه باطنًا.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. من قسوة القلب إلى التظاهر بالإيمان القلوب التي فقدت الخشية صارت تمارس النفاق وتقول ما لا تعتقد، 2. من التحريف إلى الكتمان يتدرج السلوك من تحريف علني إلى كتمان متعمّد خوفًا من انكشاف الحق، 3. من المكر البشري إلى علم الله المطلق يُظهر المقطع أن الخداع لا يجدي لأن الله مطّلع على السرائر، 4. من الموقف العملي إلى العقيدة يربط المقطع بين أفعال بني إسرائيل وبين الإيمان بعلم الله الشامل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الموقف الذي اتخذه بعض بني إسرائيل عند لقائهم المؤمنين؟، 2. ماذا قال بعضهم لبعض عند الخلو؟ ولماذا؟، 3. ما السبب الذي جعلهم يكتمون ما في التوراة؟، 4. كيف وبّختهم الآية بقولها (أَفَلَا تَعْقِلُونَ)؟، 5. ما الذي تؤكده الآية (أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ)؟
وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ (79)
عنوان موضوعي: الجهل بالدين وتحريف الكتاب لتحقيق المكاسب
التفسير: توضح الآيات أن من بني إسرائيل فئة أميّة لا تفقه الكتاب فقهًا صحيحًا، وإنما تعتمد على الأماني والظنون الباطلة دون علم أو بصيرة، فيتوهمون أنهم على هدى وهم في ضلال. كما تكشف عن فئة أخرى من علمائهم الذين استغلوا جهل العامة، فقاموا بتحريف الكتاب وكتابة نصوص بأيديهم ثم نسبوها إلى الله زورًا وبهتانًا، بغرض الحصول على مكاسب دنيوية كالأموال والمناصب والنفوذ. فجاء الوعيد الإلهي بالويل لهم، أي العذاب الشديد، جزاءً على ما اختلقوه بأيديهم وما جمعوه من أرباح باطلة نتيجة هذا التزوير في كلام الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة نفاق بني إسرائيل وكتمانهم للحق، يكشف هذا المقطع عن جانب آخر من فسادهم، وهو الجهل بالدين عند العامة، واستغلال هذا الجهل من قبل المحرّفين لتحقيق مكاسب دنيوية، فيظهر الربط بين الفساد العقدي والفساد المصلحي، إذ إن نفاق القلوب وكتمان الحق أدّيا إلى تحريف الكتاب وخداع الجهلة لتحقيق مصالح دنيوية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الجهل والتحريف يوضح تدرج الفساد من الجهل بالدين إلى استغلاله في التضليل، 2. الربط بين الفساد الديني والمكاسب الدنيوية يُظهر أن التحريف كان وسيلة لجمع المال والجاه، 3. الربط بين لفظ “ويل” والعقوبة يسهل تذكّر شدة الوعيد الإلهي للمحرّفين، 4. التفرقة بين الأميين والمحرّفين توضح تعدد مستويات الانحراف داخل المجتمع وتعمق المعنى في الذهن.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف وصفت الآيات الأميين من بني إسرائيل؟، 2. ما الجريمة التي ارتكبها المحرفون تجاه كتاب الله؟، 3. ما الهدف الذي سعوا إليه من وراء هذا التحريف؟، 4. ما الوعيد الذي توعدهم الله به؟، 5. كيف تكشف الآيات العلاقة بين الجهل بالدين واستغلاله لتحقيق المصالح الدنيوية؟
وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَةٗۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدٗا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ (80) بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (81) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (82)
عنوان موضوعي: وهم بني إسرائيل حول عذاب النار والجزاء العادل
التفسير: تذكر الآيات ادعاء بني إسرائيل أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة، وهو ادعاء يكشف استخفافهم بعقاب الله واغترارهم بأماني لا دليل عليها. فيواجههم الله بسؤال استنكاري: هل أخذتم عهدًا من الله بذلك، أم أنكم تفترون عليه الكذب بغير علم؟ وتبيّن الآيات أن ميزان الجزاء عند الله ليس الانتماء ولا الادعاء، بل العمل. فمن غلبت عليه السيئات وأحاطت به خطاياه، كان من أصحاب النار خالدًا فيها جزاءً بما كسب. أما من آمن وعمل الصالحات، فهؤلاء هم أصحاب الجنة، خالدين فيها برحمة الله وعدله. فالآيات تقرر قاعدة العدل الإلهي التي لا تفرّق بين الناس إلا بأعمالهم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة جهل بني إسرائيل وتحريفهم للكتاب لتحقيق مصالح دنيوية، يكشف هذا المقطع عن بُعدٍ آخر من انحرافهم، وهو سوء فهمهم للدين واغترارهم بالأماني الباطلة، حيث زعموا النجاة من النار دون عمل، فجاءت الآيات لتردّ عليهم وتؤكد أن النجاة لا تكون إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن الافتراء على الله يمتد إلى الكذب على النفس في شأن الآخرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الادعاء والرد الإلهي يوضح أن الله أبطل حججهم بأسلوب الاستفهام الاستنكاري القوي، 2. الربط بين العمل والجزاء يُظهر أن المصير يُحدَّد بالعمل لا بالأماني، 3. الربط بين أصحاب النار وأصحاب الجنة يقدّم مقارنة واضحة تسهّل تثبيت المعنى في الذهن، 4. التدرّج من الأماني إلى الحقيقة يبيّن كيف واجه القرآن الوهم بالبيان العقائدي الصريح.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الادعاء الذي زعمه بنو إسرائيل بشأن النار؟، 2. كيف ردت الآيات على قولهم؟، 3. ما المعيار الحقيقي للجزاء في الآخرة؟، 4. ماذا يحدث لمن أحاطت به خطاياه؟، 5. كيف توضح الآيات العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح ودخول الجنة؟
وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ (83) وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُونَ دِمَآءَكُمۡ وَلَا تُخۡرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ ثُمَّ أَقۡرَرۡتُمۡ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَرِيقٗا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمۡ تَظَٰهَرُونَ عَلَيۡهِم بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَإِن يَأۡتُوكُمۡ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ (85) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ (86)
عنوان موضوعي: ميثاق بني إسرائيل ونقضهم له
التفسير: تذكّر الآيات الميثاق العظيم الذي أخذه الله على بني إسرائيل، إذ أمرهم بعبادته وحده، والإحسان إلى الوالدين والأقارب، ورعاية اليتامى والمساكين، والتحدث إلى الناس بالقول الحسن، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان العهد واضحًا، لكن أكثرهم أعرضوا عنه ولم يلتزم به إلا قلة قليلة. ثم تذكر الآيات ميثاقًا آخر أمرهم فيه ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يُخرج بعضهم من ديارهم، وقد أقروا به وشهدوا عليه، لكنهم نقضوه فقتلوا وأخرجوا إخوانهم، وتحالفوا مع الأعداء ضدهم، في تناقض صارخ مع ما عاهدوا الله عليه. والمفارقة أنهم إذا وقع من أخرجوهم في الأسر سارعوا لفدائهم بالأموال زاعمين أن ذلك من واجب الدين، فجاءهم التوبيخ الإلهي: كيف تفادونهم وأنتم من أخرجهم؟! أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟! ففضحت الآيات تناقضهم وانتقائيتهم في العمل بالشرع. وختمت الآيات بوعيد لهم بالخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، لأنهم باعوا الآخرة بالدنيا، واستبدلوا المبدأ بالمصلحة، والحق بالباطل، فاستحقوا المصير العادل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بينت الآيات السابقة أماني بني إسرائيل الزائفة بشأن النجاة من النار، جاء هذا المقطع ليكشف السبب الحقيقي وراء استحقاقهم العذاب، وهو نقضهم المتكرر لعهودهم مع الله، مما يؤكد أن النجاة لا تكون بالأقوال والدعاوى، بل بالوفاء بالعهد والالتزام بالعمل الصالح.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الميثاق الأول والثاني يوضح تسلسل الأوامر من الإحسان والعبادة إلى النهي عن القتل والإخراج، مما يُبرز تناقضهم بين القول والعمل، 2. الربط بين الميثاق والنقض يُظهر العلاقة بين العصيان والعقوبة الإلهية، 3. الربط بين الأماني الكاذبة والوفاء بالعهد يرسّخ أن النجاة لا تتحقق إلا بالعمل والصدق في الالتزام بأوامر الله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما أبرز البنود التي تضمنها الميثاق الأول؟، 2. ما المخالفات التي ارتكبها بنو إسرائيل في الميثاق الثاني؟، 3. كيف وبّختهم الآيات على إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض؟، 4. ما العقوبة التي أنزلها الله بمن نقض عهده؟، 5. كيف توضّح الآيات خطورة استبدال الآخرة بالدنيا؟
وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَقَفَّيۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ بِٱلرُّسُلِۖ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ (87) وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيلٗا مَّا يُؤۡمِنُونَ (88)
عنوان موضوعي: تاريخ تكذيب بني إسرائيل للرسل ولعنهم بسبب كفرهم
التفسير: تبيّن الآيات أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل، ثم أرسل من بعده رسلًا متتابعين لتجديد الدعوة وتصحيح الانحراف، ومنهم عيسى ابن مريم الذي أيّده الله بالبينات الواضحة الدالة على نبوته، وسانده بروح القدس، أي جبريل عليه السلام. لكن بني إسرائيل قابلوا هذا الفضل الإلهي بالعناد، فكلما جاءهم رسول بما يخالف أهواءهم استكبروا، فكان موقفهم بين التكذيب والقتل. واحتجّوا بقولهم إن قلوبهم “غُلف” أي مغلقة لا تفقه، فبيّن الله أن قلوبهم ليست مغلقة بطبيعتها، وإنما لُعنت وطُبع عليها بسبب كفرهم، فصار الإيمان لا يدخلها إلا نادرًا. وهكذا تُظهر الآيات تاريخًا متكرّرًا من الجحود والعناد الذي جلب عليهم اللعنة والعقوبة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات نقض بني إسرائيل لعهودهم مع الله، وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض، يأتي هذا المقطع ليكشف استمرار هذا السلوك عبر تاريخهم الطويل مع أنبياء الله، حيث بلغ بهم العناد حدّ تكذيب الرسل وقتلهم، فاستحقوا اللعنة جزاءً لكفرهم واستكبارهم.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تسلسل الرسل يوضّح ترتيب الأحداث من موسى إلى عيسى مما يسهل حفظ المقطع تاريخيًا، 2. الربط بين الاستكبار والتكذيب يُظهر أن الكبر هو السبب الأساس في رفض الحق عبر العصور، 3. الربط بين الكفر وضعف الإيمان يبيّن أن تكرار التكذيب أورثهم لعنة إلهية وانغلاق القلوب عن الهداية.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام؟، 2. كيف أيد الله عيسى ابن مريم عليه السلام؟، 3. كيف كان موقف بني إسرائيل من الرسل الذين جاؤوا بعد موسى؟، 4. ما الذريعة التي احتج بها بنو إسرائيل لرفض الإيمان؟، 5. كيف يوضح المقطع أثر كفرهم واستكبارهم على قلوبهم وإيمانهم؟
وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ (89) بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ (90)
عنوان موضوعي: تكذيب بني إسرائيل للقرآن وكفرهم بسبب الحسد
التفسير: أنزل الله تعالى القرآن الكريم مصدقًا لما في التوراة من البشارات بنبي آخر الزمان، وكان بنو إسرائيل يعرفون صفاته كما جاءت في كتبهم، ويرجون أن يكون منهم حتى ينتصروا به على أعدائهم. فلما جاءهم محمد ﷺ، وهو من العرب لا من بني إسرائيل، أنكروه عنادًا وحسدًا، مع أنهم يعلمون صدقه وموافقته لما في التوراة. فاختاروا الكفر على الإيمان، مع علمهم بالحق، فاستحقوا غضب الله مرتين: غضبًا على كفرهم بالرسالة التي عرفوا صدقها، وغضبًا على حسدهم لفضل الله حين أنزل الوحي على غيرهم. وخُتمت الآيات بتهديد صريح أن جزاء هذا الكبر والعناد هو العذاب المهين الذي يليق بمن رفض الحق عن علم وحسد.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة تاريخ بني إسرائيل في تكذيب الرسل واستكبارهم عليهم، يكشف هذا المقطع استمرار هذا العناد في موقفهم من النبي محمد ﷺ، إذ كفروا به رغم معرفتهم بصدق نبوته، فامتد تكذيبهم من أنبياء بني إسرائيل إلى خاتم الأنبياء، مما يبرز رسوخ الكبر والحسد في نفوسهم.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الكتب السماوية يوضّح أن القرآن جاء مصدقًا للتوراة ومكمّلًا لها مما يربط سياق الرسالات المتتابعة، 2. الربط بين التكذيب المتكرر والكبر يُظهر أن رفض الحق سلوك متجذر في بني إسرائيل مع كل نبي، 3. الربط بين الحسد والكفر يوضح أن الحسد كان الدافع الرئيس لرفضهم رسالة الإسلام، وأنه سبب الحرمان من الهداية والجزاء المهين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الكتاب الذي جاء مصدقًا لما مع بني إسرائيل؟، 2. كيف كان موقفهم من النبي محمد ﷺ رغم معرفتهم بصفاته؟، 3. ما السبب الرئيس لكفرهم بما أنزل الله؟، 4. ما الوعيد الذي توعدهم الله به في هذه الآيات؟، 5. كيف توضح الآيات العلاقة بين الحسد والكفر؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤۡمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَهُمۡۗ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبۡلُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (91) ۞وَلَقَدۡ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذۡتُمُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَنتُمۡ ظَٰلِمُونَ (92) وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱسۡمَعُواْۖ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَأُشۡرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡعِجۡلَ بِكُفۡرِهِمۡۚ قُلۡ بِئۡسَمَا يَأۡمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (93)
عنوان موضوعي: رفض بني إسرائيل للقرآن واستمرار عصيانهم
التفسير: تبيّن الآيات أن بني إسرائيل رفضوا الإيمان بالقرآن الكريم بحجة أنهم يؤمنون فقط بما أُنزل عليهم من التوراة، مع أن القرآن جاء مصدقًا لما في التوراة من الحق. وتواجههم الآيات بسؤال استنكاري يكشف تناقضهم: إن كنتم مؤمنين حقًا بما أنزل الله، فلماذا قتلتم أنبياءه من قبل؟ وتذكّر بخطيئتهم الكبرى حين عبدوا العجل بعد أن جاءهم موسى بالبينات، مما يدل على عمق انحرافهم رغم وضوح الحجج. كما تشير الآيات إلى حادثة رفع جبل الطور فوقهم حين أخذ الله عليهم الميثاق ليلتزموا بأحكام التوراة، لكنهم أظهروا العصيان وقالوا: “سمعنا وعصينا”، حتى صار حب العجل راسخًا في قلوبهم بسبب كفرهم. وتختم الآيات بتفنيد دعواهم الإيمان، إذ بيّنت أن ما يسمونه “إيمانًا” إنما هو إيمان زائف يأمرهم بالكفر والقتل، لا بالإصلاح والطاعة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة كفر بني إسرائيل بالقرآن حسدًا من عند أنفسهم، يوضّح هذا المقطع أنهم لم يلتزموا حتى بالتوراة التي يزعمون الإيمان بها، إذ نقضوا عهودها، وقتلوا أنبياءها، وعبدوا العجل من دون الله، مما يبرهن أن كفرهم بالقرآن ليس حادثًا جديدًا بل استمرار لعصيانهم القديم ورفضهم المتكرر للحق.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الكفر بالقرآن والعصيان القديم يوضّح أن رفضهم للحق عادة متكررة في كل عصر، 2. الربط بين الميثاق والعصيان يبرز أن رفع جبل الطور فوقهم لم يُغيّر من طباعهم، إذ استمروا في نقض العهد، 3. الربط بين الوقائع التاريخية مثل عبادة العجل وقتل الأنبياء يُسهم في ترسيخ تسلسل الأحداث التي تُظهر عنادهم رغم وضوح البراهين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما حجّة بني إسرائيل في رفض الإيمان بالقرآن؟، 2. كيف أظهرت الآيات تناقضهم في دعوى الإيمان بالتوراة؟، 3. ما الذنب الذي ارتكبوه بعد مجيء موسى بالبينات؟، 4. كيف كان موقفهم من ميثاق الطور؟، 5. ما الذي يبيّن فساد إيمانهم في ختام الآيات؟
قُلۡ إِن كَانَتۡ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةٗ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (94) وَلَن يَتَمَنَّوۡهُ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٖ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلۡفَ سَنَةٖ وَمَا هُوَ بِمُزَحۡزِحِهِۦ مِنَ ٱلۡعَذَابِ أَن يُعَمَّرَۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ (96)
عنوان موضوعي: ادعاء بني إسرائيل بالاختصاص بالآخرة وحرصهم على الدنيا
التفسير: تذكر الآيات ادعاء بني إسرائيل أن الجنة والدار الآخرة خالصة لهم دون سائر الناس، فيتحداهم الله بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في زعمهم، لأن من يوقن بالجنة لا يخاف الموت بل يشتاق إلى لقاء ربه. ولكن الآيات تكشف أنهم لن يتمنوا الموت أبدًا لما اقترفوه من ذنوب عظيمة وظلم متكرر يجعلهم يخشون لقاء الله. ثم تصف حرصهم الشديد على الحياة، حتى إن حرصهم يفوق حرص المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذ يتمنى أحدهم أن يُعمَّر ألف سنة، مع أن طول العمر لا ينجيهم من العذاب الإلهي إن كانوا من الكافرين. وتختم الآيات بتأكيد أن الله بصير بأعمالهم، مطلع على ما يخفونه من نفاق وكفر، وأن جزاءهم آتٍ لا محالة مهما طال بهم العمر.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة كفر بني إسرائيل بالقرآن واستمرار عصيانهم، يأتي هذا المقطع ليكشف تناقضهم في ادعاء النجاة في الآخرة، حيث زعموا أن الجنة لهم وحدهم، بينما واقعهم يدل على خوف من الموت وحرص على الدنيا، مما يفضح زيف دعواهم وضعف يقينهم بالآخرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من ادعاء النجاة إلى الخوف من الموت يوضح التناقض بين القول والعمل، 2. مقارنة حرصهم على الحياة بالمشركين تجعل الصورة أوضح وتعمق الفهم بالمقارنة، 3. الربط بين علم الله بأعمالهم وحرصهم على الحياة يبيّن أن الله يعلم حقيقتهم وأن طول العمر لا ينجي من العذاب.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الادعاء الذي زعمه بنو إسرائيل عن الدار الآخرة؟، 2. لماذا لا يتمنون الموت رغم دعواهم النجاة؟، 3. كيف وصفت الآيات حرصهم على الحياة؟، 4. ما العلاقة بين طول العمر والعذاب كما أوضحت الآيات؟، 5. ماذا تؤكد الآيات عن علم الله بأعمال بني إسرائيل؟
قُلۡ مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّـجِبۡرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلۡبِكَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ (97) مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوّٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ (98)
عنوان موضوعي: عداء بني إسرائيل لجبريل وموقف الله من أعدائه
التفسير: تبيّن الآيات موقف بني إسرائيل الذين أظهروا عداوتهم لجبريل عليه السلام، مدّعين أنه عدوهم لأنه ينزل بالوحي الذي يحمل أوامر الله وعقوباته، لا النعم والمنافع كما يفعل ميكائيل. فجاء الرد الإلهي واضحًا أن جبريل ليس عدوًا، بل رسول من عند الله نزّل القرآن على قلب النبي محمد ﷺ بإذن الله، مصدقًا لما بين يديه من التوراة، وهادياً وبشيرًا للمؤمنين. وتوضح الآيات أن من يعادي جبريل أو ميكائيل أو أيًّا من الملائكة والرسل، فإنما يعادي الله نفسه، لأنهم جميعًا مأمورون بأمره ومنفذون لوحيه. وتختم الآيات ببيان أن الله عدو للكافرين الذين يعادون ملائكته ورسله عنادًا واستكبارًا، وأن هذا العداء ما هو إلا امتداد لكفرهم القديم بالحق.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن كشفت الآيات السابقة عن كفر بني إسرائيل وحرصهم على الدنيا ورفضهم للوحي، يأتي هذا المقطع ليُظهر بوضوح مظهرًا آخر من تمردهم، وهو عداوتهم لجبريل عليه السلام وللملائكة عمومًا، مما يدل على أن عنادهم تجاوز البشر إلى معاداة وسائط الوحي الإلهي أنفسهم، فصار عداؤهم موجّهًا إلى الله مباشرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الانتقال من رفض الوحي إلى معاداة جبريل يربط بين كفرهم بالقرآن وعداوتهم لملَك الوحي، 2. الجمع بين جبريل وميكائيل والرسل يوضّح أن عداءهم شامل لكل من يحمل أمر الله، 3. استعمال الأمر الإلهي “قُل” في الرد يجعل الخطاب حاسمًا وسهل التذكّر، مؤكدًا أن الله عدو للكافرين المعتدين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما سبب عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام؟، 2. كيف ردت الآيات على ادعائهم؟، 3. ما العلاقة بين معاداة الملائكة وعداوة الله؟، 4. من الذين يعدّهم الله أعداءً له في هذه الآيات؟، 5. كيف تكشف الآيات أن عداء بني إسرائيل للحق متجذر في نفوسهم؟
وَلَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۖ وَمَا يَكۡفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقُونَ (99) أَوَ كُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ نَبَذَ فَرِيقٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ كَأَنَّهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (101)
عنوان موضوعي: الكفر بآيات الله ونقض العهود
التفسير: تبيّن الآيات أن الله أنزل على النبي محمد ﷺ آياتٍ بيّناتٍ واضحةً تدل على صدق رسالته، ولكن الفاسقين وحدهم هم الذين يكفرون بها، لأنهم خرجوا عن طاعة الله وأعرضوا عن الحق عن علمٍ وعناد. وتذكّر الآيات أيضًا بنقض بني إسرائيل لعهودهم المتكررة، إذ ما من عهدٍ عاهدوه إلا ألقاه فريقٌ منهم وراء ظهره، مما يدل على ضعف إيمانهم وعدم التزامهم بما أمر الله به. كما تصف موقف فريقٍ من أهل الكتاب الذين، حين جاءهم رسول من عند الله يصدق ما معهم من التوراة، أعرضوا عنه وألقوا كتاب الله خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فجمعوا بين الكفر بالآيات ونقض العهود والاستخفاف بالوحي الإلهي، وهو سلوك يعكس تمردهم الدائم على الحق.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة عداء بني إسرائيل لجبريل وميكائيل وعداوتهم للوحي، يكشف هذا المقطع جانبًا جديدًا من انحرافهم، وهو رفضهم للآيات البينات التي أنزلها الله على نبيه ونقضهم للعهود المتكررة، مما يبيّن أن كفرهم ليس وليد موقفٍ عابر، بل هو امتداد لفسقٍ متجذّر وعصيانٍ مستمر.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين وضوح الآيات وفسق القلوب يوضح أن الكفر بالحق سببه الفسق لا الجهل، 2. الربط بين نقض العهود والكفر يبيّن أن الإعراض عن الوحي يقترن دومًا بنقض العهد، 3. الربط بين موقف أهل الكتاب من الرسول والكتاب يُظهر تناقضهم حين رفضوا ما يوافق ما بأيديهم من الحق، مما يسهل حفظ تسلسل المواقف عبر السورة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. من الذين يكفرون بالآيات البينات وفق الآيات؟، 2. كيف عبّرت الآيات عن تكرار نقض بني إسرائيل للعهود؟، 3. ما موقف فريقٍ من أهل الكتاب من كتاب الله ورسوله؟، 4. ما العلاقة بين الكفر بالآيات ونقض العهود؟، 5. كيف توضّح الآيات أن الفسق هو الدافع الرئيس لرفض الحق؟
وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ (102) وَلَوۡ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَمَثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ خَيۡرٞۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ (103)
عنوان موضوعي: السحر وأثره والتحذير منه
التفسير: تبيّن الآيات أن بني إسرائيل اتبعوا السحر الذي ألصقوه ظلمًا بسليمان عليه السلام، مع أن سليمان لم يكفر ولم يعمل بالسحر، بل كان السحر من تعليم الشياطين التي كفرت بالله. وتشير الآيات إلى قصة الملكين هاروت وماروت في بابل، اللذين كانا يختبران الناس بتعليم السحر تحذيرًا لا تشجيعًا، وكانا يقولان لمن يتعلّم: “إنما نحن فتنة فلا تكفر”، أي لا تستخدم هذا العلم في الشر. وقد تعلّم الناس من الملكين ما يُحدث الضرر مثل التفريق بين الرجل وزوجه، ولكنهم لا يضرون أحدًا إلا بإذن الله، فالأمر كله بيد الله. وتوضح الآيات أن السحر ضرره أعظم من نفعه، وأن من يتبعه أو يتعلّمه يخسر نصيبه في الآخرة، لأن السحر طريق للكفر والفساد، ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان خيرًا لهم عند الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن ذكرت الآيات السابقة كفر بني إسرائيل بآيات الله ونقضهم للعهود، يكشف هذا المقطع مظهرًا جديدًا من انحرافهم، وهو اتباعهم للسحر واتهامهم نبيًّا من أنبياء الله بالكفر، مما يُظهر انحدارهم من رفض الوحي إلى ممارسة أعمال شركية تُنافي الإيمان.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين براءة سليمان وعمل الشياطين يوضّح تنزيه الأنبياء عن الكفر والسحر، 2. الربط بين تعليم السحر والتحذير منه يرسّخ أن ما كان في بابل فتنة لا تشريعًا، 3. الربط بين ضرر السحر وخسارة الآخرة يبيّن أن اتباع السحر يقود إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، بينما الإيمان هو الطريق إلى الخير والنجاة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ماذا نسب بنو إسرائيل ظلمًا إلى سليمان عليه السلام؟، 2. من الذين علّموا الناس السحر وكيف حذّروهم من الكفر؟، 3. ما نوع الضرر الذي كان يحدثه السحر بين الناس؟، 4. كيف تؤكد الآيات أن السحر لا يضر إلا بإذن الله؟، 5. ما مصير من اختار السحر على الإيمان وفق ما جاء في الآيات؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ (104) مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ (105)
عنوان موضوعي: توجيه للمؤمنين وتحذير من أعداء الخير
التفسير: توجه الآيات الخطاب إلى المؤمنين، آمرةً إياهم بتحري الأدب في مخاطبة النبي ﷺ، فتنهى عن قولهم “راعِنا” لأنها كانت تُستعمل من قِبل اليهود على وجه السخرية والاستهزاء، وتوجّههم إلى استخدام عبارة “انظُرنا” التي تعبّر عن الاحترام والتوقير. كما تأمرهم بالاستماع الجاد لكلام الله ورسوله، وعدم تقليد أهل السوء في أقوالهم، وتوضح أن للكافرين عذابًا أليمًا جزاء استهزائهم وتحريفهم للكلمات. وتكشف الآيات عن حقد الكافرين من أهل الكتاب والمشركين على ما ينزّله الله من خير ووحي ورحمة على المؤمنين، لأنهم لا يطيقون رؤية فضل الله على غيرهم. وتختتم الآيات بتقرير قاعدة عظيمة، وهي أن الفضل والرحمة بيد الله وحده، يختص بها من يشاء من عباده، وأنه ذو الفضل العظيم الذي لا يُمنع عطاؤه ولا يُعترض حكمه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة انحراف بني إسرائيل واتباعهم للسحر وتحريفهم للحق، يأتي هذا المقطع ليوجه الخطاب للمؤمنين أنفسهم، ليكونوا على وعيٍ بأدب الخطاب واحترام النبي ﷺ، ويحذرهم من التأثر بسخرية الكافرين، وليبين في الوقت نفسه حسد الكافرين لما أنزل الله من الوحي والرحمة على المؤمنين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الجمع بين توجيه المؤمنين والتحذير من الكافرين يبرز التوازن بين تربية النفس ومواجهة العداء الخارجي، 2. الربط بين كلمتي “راعنا” و”انظرنا” يوضّح الفرق بين أدب الاحترام وسوء النية، مما يسهل تذكّر السياق، 3. الربط بين حسد الكافرين وفضل الله يرسّخ أن الهداية والعطاء بيد الله وحده، لا يمنعها اعتراض أو حقد.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما التوجيه الذي وجهته الآيات للمؤمنين في مخاطبة النبي ﷺ؟، 2. لماذا نهت الآيات عن استخدام كلمة “راعِنا”؟، 3. ما موقف الكافرين من نزول الخير والوحي على المؤمنين؟، 4. كيف تؤكد الآيات أن الرحمة والفضل بيد الله وحده؟، 5. ما العلاقة بين الأدب في الخطاب ونيل رحمة الله؟
۞مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ (106) أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمۡ تُرِيدُونَ أَن تَسۡـَٔلُواْ رَسُولَكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (108)
عنوان موضوعي: حكمة النسخ وتحذير من مخالفة الإيمان
التفسير: توضّح الآيات أن النسخ في الشرائع، أي إبدال حكمٍ بحكمٍ آخر أو رفعه لحكمةٍ يعلمها الله، هو من تمام قدرته وحكمته، إذ يأتي الله بخيرٍ منها أو بمثلها، بما يناسب مصالح عباده وأحوالهم. وتؤكد أن ملك السماوات والأرض كله لله وحده، فهو المولى والنصير الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يحق لأحد أن يعترض على أمره أو ينازعه سلطانه. كما تحذر الآيات المؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من طلب المعجزات التعجيزية من أنبيائهم، كما قالوا لموسى عليه السلام: “أرِنا الله جهرة”، فحذر الله أمة محمد ﷺ من سلوك طريقهم في الاعتراض والجدل. وتختتم الآيات بالتأكيد على أن من يبدّل الإيمان بالكفر ويترك سبيل الهدى فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر الدنيا والآخرة، لأن الاعتراض على حكم الله طريق الانحراف عن الصراط المستقيم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن ذكرت الآيات السابقة حقد أهل الكتاب والمشركين على المسلمين واعتراضهم على نزول الخير عليهم، يبيّن هذا المقطع أن اعتراضهم على النسخ جزء من عنادهم وكفرهم بحكمة الله، فيؤكد للمؤمنين أن النسخ من رحمة الله وعدله، ويأمرهم بالثبات على الإيمان دون جدال أو تشكيك كما فعلت الأمم السابقة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين النسخ وحكمة الله يوضّح أن التبديل في الأحكام جزء من كمال التشريع لا نقصه، 2. الربط بين اعتراض بني إسرائيل والتحذير للمؤمنين يذكّر بأن مخالفة الأوامر والجدال في الحق سبب للضلال، 3. الربط بين الإيمان والاستقامة يُبرز أن التسليم لحكمة الله هو طريق الثبات على الهدى، بينما استبدال الكفر بالإيمان يؤدي إلى الخسران.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الحكمة من النسخ في الشرائع كما توضّحها الآيات؟، 2. ماذا تؤكد الآيات عن ملك الله وقدرته؟، 3. ما التحذير الذي وجّهته الآيات للمؤمنين؟، 4. ما مصير من يبدّل الإيمان بالكفر؟، 5. كيف تربط الآيات بين التسليم لحكمة الله والاستقامة على الطريق المستقيم؟
وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ (109) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (110)
عنوان موضوعي: حسد أهل الكتاب ودعوة المسلمين للصبر والعمل الصالح
التفسير: تبيّن الآيات أن كثيرًا من أهل الكتاب يتمنّون أن يُرجعوا المسلمين إلى الكفر بعد أن آمنوا، لا عن حجة أو برهان، بل بدافع الحسد الذي يملأ قلوبهم بعد أن رأوا فضل الله يُؤتى للمؤمنين، رغم علمهم بأن الإسلام هو الحق من عند الله. فيوجّه الله المؤمنين إلى العفو والصفح عنهم، وعدم مقابلة الأذى بالأذى، إلى أن يأتي الله بأمره في نصرة دينه وإظهار الحق، مع التذكير بأن الله على كل شيء قدير. ثم تأمر الآيات المؤمنين بالانشغال بالعبادة والعمل الصالح، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن طريق النجاة في الثبات والطاعة لا في الجدال والانتقام، وتختم بتطمينهم أن كل خيرٍ يعملونه محفوظ عند الله مضاعف الأجر، فهو بصير بأعمالهم لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة حكمة النسخ والتحذير من الاعتراض على أوامر الله، يأتي هذا المقطع ليكشف دافعًا نفسيًا عند أهل الكتاب، وهو الحسد للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله، ويوجّه المسلمين إلى الصبر والعفو، والتركيز على الطاعة والعمل الصالح، لأن الثبات على الإيمان لا يكون بالجدال بل بالصبر والإخلاص في العبادة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين حسد أهل الكتاب والعفو الإلهي يوضّح أن المؤمن يقابل الحسد بالحِلم لا بالعداوة، 2. الربط بين الصبر والطاعة يُظهر أن الثبات أمام الأذى يكون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، 3. الربط بين العمل الصالح والجزاء الأخروي يرسّخ أن كل خيرٍ محفوظ عند الله، مما يعزز اليقين والاطمئنان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ماذا يتمنى كثير من أهل الكتاب للمسلمين بعد إيمانهم؟، 2. ما السبب الحقيقي وراء هذا التمنّي؟، 3. كيف وجّهت الآيات المسلمين في التعامل مع حسد أهل الكتاب؟، 4. ما الأعمال التي دعت إليها الآيات كوسيلة للثبات؟، 5. كيف توضّح الآيات أن الله يجزي كل عمل صالح ولا يضيّع أجر المحسنين؟
وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ تِلۡكَ أَمَانِيُّهُمۡۗ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (111) بَلَىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (112)
عنوان موضوعي: ادعاءات أهل الكتاب في الجنة ومعيار الفوز الحقيقي
التفسير: تبيّن الآيات أن أهل الكتاب زعموا أن الجنة حكرٌ عليهم دون غيرهم، فقالت اليهود إنها لهم خاصة، وقالت النصارى مثل ذلك، وكلّها أماني باطلة لا تستند إلى دليل من الله. فجاءهم التحدي الإلهي: “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، ليُظهر أن النجاة لا تُنال بالدعوى، بل بالعمل. ثم أوضحت الآيات أن الجنة ليست امتيازًا لقومٍ دون آخر، بل لمن أسلم وجهه لله مخلصًا، واتبع أوامره، وأحسن عمله، فالإيمان الصادق والعمل الصالح هما معيار الفوز الحقيقي. وتختم الآيات بتقرير قاعدة الخلود في الطمأنينة والأمن لمن حقق هذه الصفات، إذ له أجره عند ربه، ولا خوفٌ عليه في الدنيا ولا حزنٌ في الآخرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة حسد أهل الكتاب للمؤمنين ومحاولتهم ردّهم عن الإيمان، يكشف هذا المقطع جانبًا آخر من غرورهم، وهو زعمهم احتكار الجنة، فيردّ الله عليهم بأن النجاة لا تكون بالانتماء أو التمنّي، بل بالإخلاص لله والعمل الصالح، مما يربط بين الحسد والغرور كأصلين للحرمان من الهداية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الادعاء وغياب الدليل يوضّح أن أقوالهم بلا حجة فتسهل المقارنة بين الأماني والبرهان، 2. الربط بين الإسلام والإحسان يجعل معيار النجاة واضحًا في الذهن: إخلاص لله مع عمل صالح، 3. الربط بين العمل الصالح والأمان الأخروي يرسّخ أن ثمرة الإيمان الحق هي الطمأنينة في الآخرة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الادعاء الذي زعمه أهل الكتاب بشأن الجنة؟، 2. كيف ردت الآيات على مزاعمهم؟، 3. ما المعيار الحقيقي للفوز بالجنة؟، 4. ما الجزاء الذي وعد الله به من أسلم وجهه وأحسن عمله؟، 5. كيف تفرّق الآيات بين الأماني الفارغة والعمل الحقيقي؟
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113).
العنوان الموضوعي: خلافات أهل الكتاب وحكم الله يوم القيامة
التفسير: تبيّن الآية الخلافات العميقة بين اليهود والنصارى، إذ يزعم كل فريقٍ أن الآخر ليس على شيء من الحق، مع أنهم جميعًا يتلون الكتاب الذي يأمر بالإيمان بالله والعمل الصالح. وتوضّح أن هذا التعصب في الموقف ليس حكرًا على أهل الكتاب، بل شاركهم فيه الجهّال من الأمم الأخرى الذين قالوا القول نفسه عن غير علمٍ أو هدى، مما يدل على أن الجهل والتعصب يتكرران في كل عصر. وتختم الآية بتقرير الحقيقة الكبرى أن الله وحده هو الذي سيفصل بين الناس يوم القيامة، فيُظهر الحق فيما اختلفوا فيه، ويحكم بين عباده بالعدل الكامل، فلا يبقى مجال للظنون ولا للمجادلة.
مناسبة الآية لما قبلها: بعد أن عرضت الآيات السابقة ادعاء أهل الكتاب بأن الجنة حكرٌ عليهم، جاءت هذه الآية لتكشف تناقضهم فيما بينهم، إذ لم يكتفوا بادعاء النجاة بل كفّر بعضهم بعضًا، مما يدل على أن أقوالهم ليست عن وحي أو علم بل عن هوى وجهل. وتوضّح المناسبة أن من أعرض عن الوحي واحتكم إلى رأيه ضل وتفرّق، وأن الحكم الفصل سيكون لله وحده يوم القيامة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التناقض في أقوالهم وتلاوتهم للكتاب يوضّح المفارقة بين العلم والعمل، 2. الربط بين أقوالهم وأقوال الجاهلين يبيّن أن الجهل والتعصب أصلٌ مشترك في كل أمةٍ تركت الوحي، 3. الربط بين الخلاف الدنيوي والحكم الإلهي يرسّخ أن الفصل النهائي في العقيدة يكون عند الله وحده يوم القيامة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الادعاء الذي قاله اليهود والنصارى تجاه بعضهم؟، 2. كيف وصف الله حالهم مع أنهم يتلون الكتاب؟، 3. من الذين قالوا مثل قولهم من الأمم الأخرى؟، 4. ما الذي سيفعله الله يوم القيامة لحسم هذه الخلافات؟، 5. ما العلاقة بين التفرق في الدنيا والحكم الإلهي في الآخرة؟
وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ (114) وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ (115)
العنوان الموضوعي: منع ذكر الله في المساجد وحقيقة التوجه إلى الله
التفسير: تبدأ الآية بإنكار شديد على من يمنع ذكر الله في المساجد ويسعى في خرابها، سواء بالهدم أو التعطيل عن العبادة، فهؤلاء ارتكبوا أعظم أنواع الظلم، لأنهم حالوا بين الناس وبين عبادة ربهم، وهو الغاية التي خُلق الخلق لأجلها. وتبيّن الآية أن هؤلاء لا يحق لهم دخول المساجد إلا بخوفٍ وذلٍّ من عقوبة الله، وقد توعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة جزاءً لما اقترفوه. ثم تبيّن الآية التالية أن المشرق والمغرب ملك لله، أي أن عبادة الله لا تُحصر في مكانٍ معين، فحيثما توجّه المؤمن فثمّ وجه الله، لأن الله حاضر بعلمه وقدرته في كل موضع، وهو واسع الفضل، عليمٌ بأحوال عباده ونواياهم، مما يرسّخ مفهوم التوحيد الخالص وأن الإخلاص هو أساس العبادة لا المكان.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة تناقضات أهل الكتاب واختلافهم في الدين، يكشف هذا المقطع عن ذروة ظلمهم، وهو منع الناس من ذكر الله والسعي في خراب بيوته، مبينًا أن العبادة لا تُعطّل بظلمهم، لأن التوجّه إلى الله لا يُقيَّد بمكانٍ أو حدود، بل يتحقق بالإخلاص في أي موضع.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين منع الذكر وخراب المساجد يوضّح أن تعطيل العبادة أعظم أنواع الظلم، 2. الربط بين الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة يرسّخ أن العقوبة تمتد في الدارين، 3. الربط بين شمولية التوجّه إلى الله وملكه الواسع يبيّن أن الإيمان الحقيقي لا يتقيد بمكان بل يقوم على الإخلاص لله في كل موضع.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الظلم الذي وصفته الآية بأنه أعظم الظلم؟، 2. ما الجزاء الذي توعّدت به الآيات من يمنع ذكر الله ويسعى في خراب المساجد؟، 3. كيف أوضحت الآيات شمول ملك الله في المشرق والمغرب؟، 4. ما العلاقة بين التوجّه إلى الله في أي مكان وبين سعة رحمته وعلمه؟، 5. كيف تربط الآيات بين تعطيل العبادة والعقوبة في الدنيا والآخرة؟
وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ (116) بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (117) وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ لَوۡلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوۡ تَأۡتِينَآ ءَايَةٞۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡۘ تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ (118) إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ (119)
عنوان موضوعي: تنزيه الله عن اتخاذ الولد ووظيفة النبي في التبليغ
التفسير: تشير الآيات إلى الرد على ادعاء بعض أهل الكتاب والمشركين بأن الله اتخذ ولدًا، وتؤكد تنزيه الله عن ذلك لأنه مالك السماوات والأرض، وكل ما فيهما خاضع لأمره وطاعته. تصف الله بأنه خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنه إذا أراد شيئًا قال له “كن” فيكون. تذكر الآيات اعتراضات الجاهلين الذين يطلبون أن يكلمهم الله مباشرة أو يروا آية، وتوضح أن هذه المطالب ليست جديدة بل قالها من قبلهم أقوام تشابهت قلوبهم في الجهل والعناد. وتختم الآيات ببيان وظيفة النبي محمد ﷺ كرسول يحمل الحق، بشيرًا لمن أطاع الله ونذيرًا لمن عصاه، مع التأكيد أن هداية الناس بيد الله وحده وأن النبي غير مسؤول عن الكافرين الذين اختاروا الضلال.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن منع ذكر الله في المساجد وسعة ملك الله، تتناول هذه الآيات تنزيه الله عن ادعاءات الكافرين حول اتخاذ الولد، وتوضيح مهمة النبي في مواجهة الجهل والعناد، مما يربط بين شمولية ملك الله وحكمته في إرسال الرسل. الربط يُظهر أن اعتراضات الكافرين دليل على الجهل المستمر عبر العصور.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تنزيه الله وشمولية ملكه تبدأ الآيات بتفنيد دعوى اتخاذ الله ولدًا وتُثبت أن له ما في السماوات والأرض مما يُرسّخ في الذهن أن المالك المطلق منزّه عن النقص والتشبيه، 2. الربط بين تكرار الاعتراضات وجهل المعترضين تُبيّن الآيات أن طلب المعجزة أو كلام الله تكرّر من أقوام سابقة مما يربط بين الجهل المتكرر وتشابه القلوب في العناد، 3. الربط بين مهمة النبي والاستجابة البشرية تختم الآيات بتحديد دور النبي ﷺ في البلاغ والإنذار وتوضيح أن الهداية بيد الله مما يُسهّل فهم التوازن بين التبليغ والنتيجة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف ردت الآيات على ادعاء أن الله اتخذ ولدًا؟، 2. ما وصف الله في خلقه السماوات والأرض؟، 3. ما الاعتراض الذي أثاره الجاهلون وكيف ردت عليه الآيات؟، 4. ما وظيفة النبي محمد ﷺ كما وردت في الآيات؟، 5. كيف تؤكد الآيات أن الجهل والعناد موجودان عبر العصور؟
وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ (120) ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ (121)
عنوان موضوعي: عدم رضا أهل الكتاب إلا باتباع ملتهم والإيمان الحق بالكتاب
التفسير: تؤكد الآيات أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن النبي محمد ﷺ حتى يتبع دينهم، وهو مطلب يعبر عن تعصبهم ورفضهم للحق. تُرشد الآيات النبي إلى الرد عليهم بأن هدى الله وحده هو الهدى الحق، وليس أهواء البشر، وتحذره من اتباع أهوائهم بعد أن جاءه العلم من الله، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان حماية الله ونصرته. تنتقل الآية التالية لتصف المؤمنين الحقيقيين من أهل الكتاب بأنهم يتلون الكتاب حق تلاوته، أي يقرأونه بفهم وتدبر ويؤمنون به كما أمر الله. أما من يكفر بالكتاب بعد وضوح الحق، فقد خسروا الدنيا والآخرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن اعتراضات الكافرين ومطالبهم الباطلة، تتناول هذه الآيات موقف أهل الكتاب من النبي والإسلام، وتوضح سبب تعصبهم، مع بيان الفارق بين من يؤمن بالكتاب حقًا ومن يكفر به. الربط يظهر أن تعنت أهل الكتاب تجاه الإسلام مرتبط بتعصبهم وليس بعدم وضوح الحق.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تعصب أهل الكتاب ورفضهم للحق توضح الآيات أن عدم رضا اليهود والنصارى ليس سببه غموض الحق بل تعصبهم ورغبتهم في فرض ملتهم، 2. الربط بين الثبات على العلم وترك الأهواء تُحذر الآيات من اتباع أهواء أهل الكتاب بعد نزول العلم مما يُرسّخ أهمية الثبات على هدى الله، 3. الربط بين الإيمان الحق بالكتاب والخسارة عند الكفر به تُبرز الآيات أن من يتلو الكتاب حق تلاوته يؤمن به ومن يكفر به بعد وضوحه فهو من الخاسرين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الشرط الذي يضعه اليهود والنصارى ليرضوا عن النبي ﷺ؟، 2. كيف ردت الآيات على تعصب أهل الكتاب؟، 3. من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته وما صفاتهم؟، 4. ما مصير من يكفر بالكتاب وفقًا لهذه الآيات؟، 5. كيف تظهر الآيات أهمية الثبات على هدى الله وعدم اتباع الأهواء؟
يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ (122) وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ (123)
عنوان موضوعي: تذكير بني إسرائيل بنعم الله والتحذير من يوم القيامة
التفسير: تبدأ الآيات بتذكير بني إسرائيل بنعمة الله العظيمة عليهم، حيث فضلهم على العالمين في زمانهم بما أرسل إليهم من أنبياء وأنزل عليهم من كتب. تدعوهم إلى تقوى الله والتهيؤ ليوم القيامة، الذي لا تنفع فيه الشفاعة ولا الفدية (العدل)، ولا يُنصر أحد مهما كانت مكانته أو نسبه. الهدف من التذكير هو حث بني إسرائيل على الاستجابة لدعوة الحق وتجنب الاعتماد على أمانيهم الكاذبة بأنهم مفضلون بلا عمل صالح.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن المؤمنين ودعوتهم للوحدة والاعتصام بحبل الله، ينتقل الخطاب إلى بني إسرائيل لتذكيرهم بنعم الله عليهم وتحذيرهم من الاعتماد على النسب أو الشفاعة يوم القيامة. الربط يُظهر أن النجاة يوم القيامة تعتمد على التقوى والعمل الصالح، وليس على الانتساب إلى أمة معينة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التذكير بالنعم والتحذير من الغفلة تبدأ الآيات بتذكير بني إسرائيل بنعمة التفضيل ثم تنتقل مباشرة لتحذيرهم من يوم القيامة مما يُبرز أن التفضيل لا يُغني عن العمل، 2. الربط بين الاعتماد على النسب وواقع الحساب توضح الآيات أن يوم القيامة لا تنفع فيه شفاعة ولا فدية مما يُسقط أوهام الاعتماد على الانتساب وحده، 3. الربط بين نعم الدنيا ومسؤولية الآخرة تُبيّن الآيات أن تذكير بني إسرائيل بالنعم يتبعه مسؤولية عظيمة وهي تقوى الله والاستعداد ليوم لا يُنصر فيه أحد إلا بعمله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما النعمة التي ذكّر الله بها بني إسرائيل في هذه الآيات؟، 2. ما التحذير الذي وجهته الآيات لبني إسرائيل بشأن يوم القيامة؟، 3. ما الأمور التي لا تنفع يوم القيامة كما وردت في الآيات؟، 4. كيف توضح الآيات أن التفضيل الإلهي لا يغني عن العمل الصالح؟، 5. ما العلاقة بين ذكر النعم والتحذير من الحساب في هذه الآيات؟
۞وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ (124) وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (125) وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنٗا وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلٗا ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ (126) وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (129)
عنوان موضوعي: ابتلاء إبراهيم عليه السلام ومقام الكعبة
التفسير: تبيّن الآيات أن الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بمجموعة من الأوامر والاختبارات الصعبة، فاستجاب لها جميعًا بطاعة تامة، فجعله الله إمامًا للناس، وقد طلب إبراهيم أن تكون الإمامة في ذريته، فبيّن الله أن عهده لا ينال الظالمين، تأكيدًا أن الشرف الإلهي لا يقوم على النسب بل على الصلاح. ثم أوضحت الآيات أن الله جعل الكعبة بيتًا مقدسًا آمنًا يُقصد للطواف والعبادة، وأمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لعبادة الله وحده. وذكر دعاء إبراهيم بأن يجعل مكة بلدًا آمنًا ويرزق أهلها من الثمرات، فاستجاب الله للمؤمنين منهم، أما الكافرين فمتاعهم في الدنيا مؤقت ثم مصيرهم إلى العذاب. كما تصف الآيات مشهد بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة وهما يدعوان الله أن يتقبل عملهما، وأن يجعلهما وذريتهما أمة مسلمة، ويسألان الهداية والمغفرة، فيتجلى من المقطع إخلاص إبراهيم وسمو مقامه في طاعة الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد تذكير بني إسرائيل بنعم الله وتحذيرهم من الكفر والعصيان، تعرض هذه الآيات نموذجًا مضادًا في شخصية إبراهيم عليه السلام، الذي أتمّ أوامر الله بإخلاص وبنى البيت الحرام على التوحيد، لتبيّن أن الاصطفاء الإلهي لا يكون بالوراثة أو الانتماء، بل بالطاعة الكاملة لله والتقوى.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الابتلاء والطاعة والإمامة يوضّح أن الإمامة لا تُنال إلا بالاختبار والصبر على الطاعة، 2. الربط بين بناء الكعبة ووحدة التوحيد يبيّن أن البيت الحرام رمز للتوحيد والإخلاص في العبادة، 3. الربط بين المتاع الدنيوي للكافرين والعاقبة الأخروية يرسّخ أن الرزق في الدنيا لا يدل على رضا الله، فالعاقبة للمتقين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الابتلاءات التي اجتازها إبراهيم عليه السلام وما جزاؤه عليها؟، 2. ما الأمر الإلهي الذي وُجّه إلى إبراهيم وإسماعيل بشأن الكعبة؟، 3. بماذا دعا إبراهيم ربه لمكة وأهلها؟، 4. ما الدعوات التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل أثناء بناء الكعبة؟، 5. كيف تُظهر الآيات العلاقة بين الطاعة والإمامة وبين الكفر والعقوبة؟
وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (130) إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (131) وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ (132) أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ (133) تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (134)
عنوان موضوعي: الإيمان بمِلَّة إبراهيم وأهمية الإسلام والتوحيد
التفسير: تبدأ الآيات بالاستنكار على من يعرض عن ملة إبراهيم عليه السلام، واصفةً من يفعل ذلك بأنه سفيه نفسه، لأن ملة إبراهيم قائمة على التوحيد الخالص والإسلام الكامل لله. وتبيّن أن الله اصطفى إبراهيم في الدنيا ورفعه في الآخرة إلى مقام الصالحين، جزاءً على طاعته واستسلامه لأمر الله. ثم تشير الآيات إلى وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهم بأن يثبتوا على الإسلام وألا يموتوا إلا وهم مسلمون، تأكيدًا على أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لجميع أنبيائه وأممهم. وتعرض مشهد يعقوب عند وفاته وهو يسأل أبناءه عن عبادتهم من بعده، فيجيبونه بأنهم سيعبدون الله وحده، إله آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فيعلنون التزامهم بالإسلام. وتختم الآيات ببيان قاعدة العدل والمسؤولية، وهي أن كل أمة تُحاسب على أعمالها، فلا تنفع الأنساب ولا الادعاءات، بل يُسأل كل إنسان عما قدّم من عمل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر بناء الكعبة ودعاء إبراهيم بأن تكون ذريته أمة مسلمة، تؤكد هذه الآيات امتداد تلك الدعوة في ذريته، وأن ملة إبراهيم هي أساس التوحيد والإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء، لتردّ بذلك على دعوى اليهود والنصارى بالانتماء لإبراهيم مع مخالفتهم لتوحيده.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الاصطفاء والإسلام الخالص يوضّح أن الكرامة الإلهية ناتجة عن الإيمان الصادق والتوحيد لا عن النسب، 2. الربط بين الوصية والإيمان المتوارث يبرز حرص الأنبياء على غرس الإسلام في ذريتهم، 3. الربط بين التوحيد والمسؤولية الفردية يرسّخ أن الحساب عند الله قائم على العمل لا على الوراثة أو الانتماء.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما وصف الآيات لمن يرغب عن ملة إبراهيم؟، 2. كيف بيّنت الآيات اصطفاء إبراهيم في الدنيا والآخرة؟، 3. ما الوصية التي أوصى بها إبراهيم ويعقوب أبناءهم؟، 4. كيف أجاب أبناء يعقوب على سؤال أبيهم عن عبادتهم بعده؟، 5. ما المبدأ الذي تكرّسه الآيات في ختامها بشأن مسؤولية الأعمال؟
وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِـۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (135) قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ (136) فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ (137) صِبۡغَةَ ٱللَّهِ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبۡغَةٗۖ وَنَحۡنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ (138)
عنوان موضوعي: الدعوة لملة إبراهيم والتوحيد الكامل
التفسير: تردّ الآيات على دعوى اليهود والنصارى الذين قالوا: “كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا”، فيأمر الله نبيَّه أن يعلن أن الهداية الحقة هي في اتباع ملة إبراهيم الحنيف، القائمة على التوحيد الخالص دون شرك أو انحراف. وتدعو الآيات المسلمين إلى إعلان إيمانهم الشامل بالله وما أُنزل إليهم، وما أُنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أُوتي موسى وعيسى وسائر النبيين من ربهم، دون تفريق بين أحدٍ منهم، مؤكدين أنهم مسلمون لله وحده. ثم تبيّن أن من وافق المسلمين في هذا الإيمان فقد اهتدى إلى الحق، أما من أعرض وتولّى فقد انحرف عن الصراط المستقيم، وتطمئن المؤمنين بأن الله كافيهم شر من يعاديهم، فهو السميع العليم الذي يعلم نوايا القلوب. وتُختَم الآيات ببيان أن الإسلام هو “صبغة الله” التي فطر الناس عليها، وأن عبادة الله وحده هي أعظم صبغة وأجمل سمة يتزين بها المؤمنون.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن أكدت الآيات السابقة على ملة إبراهيم وأهمية الإسلام القائم على التوحيد، جاء هذا المقطع ليبيّن أن الهداية لا تكون بالانتماء إلى طائفة أو قوم، بل بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب على نهج إبراهيم الحنيف، مما يوضح أن الإسلام هو الامتداد الكامل لجميع الرسالات السماوية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين ملة إبراهيم والرد على ادعاءات الطوائف يوضّح أن الدين الحق هو التوحيد لا الانتماء الحزبي أو القومي، 2. الربط بين الإيمان الشامل والتمسك بالإسلام يؤكد أن الإسلام يجمع بين جميع الرسل والكتب في وحدة العقيدة، 3. الربط بين الفطرة والتوحيد يبيّن أن “صبغة الله” هي الفطرة السليمة التي تنسجم مع الإيمان بالله وحده.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الرد الذي وجّهه القرآن على دعوى اليهود والنصارى بالهداية باتباع ملتهم؟، 2. ما منهج المسلمين في الإيمان بالرسل والكتب السماوية وفق الآيات؟، 3. كيف وصفت الآيات من وافق المسلمين ومن تولّى عن الإيمان؟، 4. ما المقصود بعبارة “صبغة الله”؟، 5. كيف تؤكد الآيات شمولية الإسلام ووحدته مع الرسالات السماوية؟
قُلۡ أَتُحَآجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ وَلَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُخۡلِصُونَ (139) أَمۡ تَقُولُونَ إِنَّ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰۗ قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُۗ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ (140) تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (141)
عنوان موضوعي: الرد على ادعاءات أهل الكتاب وإثبات التوحيد
التفسير: تخاطب الآيات أهل الكتاب الذين يجادلون المسلمين في شأن الله، مبيّنة أن الله رب الجميع، لا يختص بقوم دون آخرين، وأن الفصل بين الناس يكون بالأعمال لا بالأنساب أو الانتماءات، فلكل أمة ما كسبت من خير أو شر. ثم تردّ الآيات على افترائهم بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا يهودًا أو نصارى، مؤكدة أن هذه الأقوال باطلة لأن اليهودية والنصرانية جاءت بعدهم بزمن طويل، وأن علم الله أصدق من زعمهم. وتدين الآيات من يكتم شهادة الحق مع علمه بها، لأنه يخفي ما أنزله الله من الهداية. وتُختم بتقرير قاعدة العدل الإلهي: أن كل أمة مسؤولة عن عملها، لا تُحاسَب على عمل غيرها، ولا ينفعها الانتساب إلى أحد، بل يُجازى كل إنسان بما قدمت يداه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة ملة إبراهيم القائمة على التوحيد والإيمان بجميع الأنبياء، جاءت هذه الآيات لتفند افتراء أهل الكتاب الذين نسبوا الأنبياء إلى دياناتهم، وتؤكد أن معيار القرب من الله هو الإخلاص والعمل الصالح، لا الانتماء ولا النسب، مما يظهر كمال عدل الله في محاسبته لعباده.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التوحيد ورفض المجادلة العقيمة يوضّح أن الله رب الجميع، والإخلاص له هو المعيار، 2. الربط بين تزوير التاريخ وكتمان الشهادة يبيّن تحريف أهل الكتاب في نسب الأنبياء وطمسهم للحقائق، 3. الربط بين الاستقلال في العمل والمحاسبة الفردية يرسّخ أن كل إنسان مسؤول عن عمله، لا يحمل وزر غيره.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الرد الذي وجّهته الآيات على جدال أهل الكتاب في شأن الله؟، 2. كيف ردّت الآيات على زعمهم أن الأنبياء كانوا يهودًا أو نصارى؟، 3. ما وصف الآيات لمن يكتم شهادة الحق؟، 4. ما المبدأ الذي أكّدته الآيات في مسؤولية الأعمال؟، 5. كيف توضّح الآيات أن الإخلاص والعمل هما أساس القرب من الله؟
۞سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ (142) وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ (143) قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ (144) وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٖ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٖ قِبۡلَتَهُمۡۚ وَمَا بَعۡضُهُم بِتَابِعٖ قِبۡلَةَ بَعۡضٖۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ إِنَّكَ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (145)
عنوان موضوعي: تحويل القبلة واختبار الإيمان
التفسير: تبدأ الآيات ببيان موقف السفهاء من الناس، من الكفار والمنافقين، الذين اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فاستنكروا التغيير استهزاءً وتشكيكًا، فردّ الله عليهم بأن المشرق والمغرب ملكه، وهو وحده الذي يوجّه عباده حيث يشاء، ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. ثم تبيّن الآيات أن الله جعل الأمة الإسلامية أمة وسطًا معتدلة في عقيدتها وشريعتها، لتكون شاهدة على الأمم، كما كان الرسول ﷺ شهيدًا عليها، وأن تحويل القبلة كان امتحانًا إلهيًا ليظهر المؤمنون الصادقون الذين يتبعون الرسول ممن يرتدّون على أعقابهم. وتؤكد أن الله لا يضيع إيمان من صلّى نحو القبلة الأولى، لأن الله رحيم بعباده. وتعرض مشهد استجابة الله لدعاء النبي ﷺ حين كان يتطلع إلى السماء منتظرًا الأمر الإلهي، فأمره الله أن يتوجه بوجهه نحو المسجد الحرام، قبلةً دائمة للمسلمين. وتوضح الآيات أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا التحويل هو الحق من عند الله، لكنهم يجحدون عنادًا، وأنهم لن يتبعوا قبلة المسلمين كما لن يتبع المسلمون قبلتهم، فكلٌّ له وجهته التي وُلِّيها، والمهم هو المسارعة إلى الخيرات.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة ملة إبراهيم والدعوة إلى التوحيد، جاء هذا المقطع ليبيّن أن تحويل القبلة امتداد لملّة إبراهيم وبناء الكعبة، وأنه اختبارٌ إيماني يميز الصادقين في اتباع الرسول، كما يُبرز استقلال الأمة الإسلامية عن أهل الكتاب وتميّزها في الاتجاه والهوية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تحويل القبلة وصدق الإيمان يوضح أن الامتثال لأمر الله اختبارٌ للطاعة الخالصة، 2. الربط بين استقلال القبلة ووسطية الأمة يبرز أن للأمة الإسلامية خصوصيتها وشهادتها على الناس، 3. الربط بين علم أهل الكتاب والمكابرة يرسّخ أن المعرفة بلا إخلاص تؤدي إلى الضلال رغم وضوح الدليل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما ردّ القرآن على استهزاء السفهاء بتغيير القبلة؟، 2. لماذا جعل الله الأمة الإسلامية أمة وسطًا؟، 3. ما الحكمة من تحويل القبلة كما ورد في الآيات؟، 4. كيف أكدت الآيات علم أهل الكتاب بحقيقة القبلة الجديدة؟، 5. ما التحذير الذي وجّهته الآيات بشأن اتباع أهواء أهل الكتاب؟
ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ (146) ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ (147) وَلِكُلّٖ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ (148) وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ وَإِنَّهُۥ لَلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ (149) وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ (150)
عنوان موضوعي: حقيقة القبلة وتمييز الحق من الباطل
التفسير: تتناول الآيات مسألة تحويل القبلة لتوضيح حقيقتها وردّ اعتراضات أهل الكتاب والمشركين، وتثبيت المسلمين على الحق. وتبيّن أن فريقًا من أهل الكتاب يعلم يقينًا أن تحويل القبلة إلى المسجد الحرام هو من عند الله، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا الحق حسدًا وإنكارًا. وفي مواجهة هذا الموقف المليء بالشكوك والافتراءات، يأمر الله نبيَّه ﷺ بالثبات على ما أُوحي إليه، فالحقيقة لا تتأثر بإنكار الناس، لأن ما جاءه من ربه هو الحق المبين. وتوضح الآيات أن لكل أمة قبلة تتجه إليها، لكن العبرة بالمسارعة إلى الخيرات، فذلك معيار الإيمان، والله سيجمع الخلائق يوم القيامة ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. وتكرّر الآيات الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام لتأكيد الثبات على الأمر الإلهي، وتعزيز هوية الأمة الإسلامية، مع التذكير بأن الله محيط بأعمال عباده. وتُختتم بتوجيه المسلمين إلى خشية الله وحده دون الناس، لأن هذا التحويل جزء من إتمام نعمة الله عليهم، ودليل على هدايتهم، وفصلٌ بين أهل الحق وأهل الباطل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة استهزاء السفهاء من الناس بتحويل القبلة وثبّتت المؤمنين على طاعة الله، يأتي هذا المقطع ليؤكد أن أهل الكتاب يعلمون حقيقة الأمر ولكنهم يكتمونها، فيأمر الله المؤمنين بالثبات على الحق دون خوف من المعترضين، لأن التحويل للقبلة علامة الهداية وإتمام النعمة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين علم أهل الكتاب وكتمانهم للحق يبيّن تناقضهم بين المعرفة والعمل، 2. الربط بين توجيه القبلة وإتمام النعمة يوضّح أن التحويل جزء من تكريم الأمة وهدايتها، 3. الربط بين خشية الله والثبات على الحق يرسّخ أن الإخلاص لله هو أساس الطاعة، لا رضا الناس.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف وصفت الآيات علم أهل الكتاب بحقيقة تحويل القبلة؟، 2. ما التوجيه الذي أعطته الآيات للنبي ﷺ والمؤمنين بشأن القبلة؟، 3. ما المبدأ الذي ذكرته الآيات في المسارعة إلى الخيرات؟، 4. لماذا أمرت الآيات المؤمنين بخشية الله دون خشية الناس؟، 5. كيف ترتبط نعمة تحويل القبلة بهداية الأمة الإسلامية؟
كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ (151) فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ (152) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ (153)
عنوان موضوعي: إرسال النبي ﷺ وفضل الذكر والصبر
التفسير: تبيّن الآيات أن من أعظم نعم الله على المؤمنين إرساله النبي محمدًا ﷺ، الذي يتلو عليهم آيات الله، فيطهّر قلوبهم من الشرك والجهل، ويزكي نفوسهم، ويعلّمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعرّفهم ما لم يكونوا يعلمون من أمور الدين والدنيا. وتدعو الآيات المؤمنين إلى دوام ذكر الله وشكره على هذه النعمة العظيمة، وتحذّرهم من الكفر والجحود بها، لأن الشكر هو سبب دوام النعم، والكفر بها سبب زوالها. وتختم الآيات بتوجيهٍ عظيمٍ للمؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة في مواجهة الشدائد والمحن، مؤكدة أن الله مع الصابرين بالعون والتأييد والتوفيق، مما يغرس في النفس الطمأنينة والثبات على طريق الإيمان.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة نعمة تحويل القبلة وإتمام الله نعمته على الأمة الإسلامية، يأتي هذا المقطع ليذكّرهم بنعمة أعظم، وهي بعثة النبي ﷺ، الذي جاء ليهديهم ويزكيهم، ثم يوجّههم إلى واجب الشكر والذكر لله، والاستعانة بالصبر والصلاة، تأكيدًا على أن النعم تستوجب عبادة الله والثبات على طاعته.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين نعمة الرسول والتزكية والتعليم يوضّح أن الرسالة جاءت لإصلاح القلوب والعقول، 2. الربط بين الذكر والشكر يُظهر أن شكر النعم يحفظها ويزيدها، بينما كفرها سبب زوالها، 3. الربط بين الصبر والصلاة ومعية الله يرسّخ أن الثبات في الشدائد يتحقق بالاستعانة بالله، وأن معيته تُنال بالصبر والطاعة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المهام التي يقوم بها النبي ﷺ بحسب الآيات؟، 2. ما التوجيه الذي وجّهته الآيات للمؤمنين في ذكر الله وشكره؟، 3. كيف دعت الآيات المؤمنين لمواجهة الشدائد؟، 4. ما فضل الصبر والصلاة كما ورد في الآيات؟، 5. كيف تربط الآيات بين نعمة إرسال النبي ﷺ ووجوب العبادة والشكر؟
وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ (154) وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ (155) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ (156) أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ (157)
عنوان موضوعي: الشهادة في سبيل الله وفضل الصبر على الابتلاء
التفسير: تبيّن الآيات تصحيح المفهوم الخاطئ حول الشهداء في سبيل الله، إذ توضح أنهم ليسوا أمواتًا كما يظن الناس، بل أحياء عند الله يُرزقون وينعمون بفضل ما قدّموا، غير أن البشر لا يدركون حقيقتهم. ثم تنتقل الآيات إلى بيان سنة الله في الابتلاء، حيث يختبر عباده بشيء من الخوف، والجوع، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ليتميّز المؤمن الصابر من غيره. وتصف الصابرين بأنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا: ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(، تعبيرًا عن تسليمهم التام لله وإيمانهم بأن كل ما يصيبهم بقدر الله. وتختم الآيات بذكر جزاء هؤلاء الصابرين، إذ لهم صلوات من ربهم ورحمة خاصة، وهم وحدهم المهتدون إلى الطريق الحق.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن دعت الآيات السابقة إلى الصبر والاستعانة بالله في مواجهة الشدائد، يركّز هذا المقطع على نوع خاص من الصبر، وهو الصبر على الابتلاء والمصائب، وخصوصًا في سبيل الله، ليُظهر أن التضحية والثبات سبيل إلى الهداية والرضا الإلهي.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الشهادة والحياة الحقيقية عند الله يوضّح أن حياة الشهداء أرفع من الحياة الدنيوية، مما يعمّق معنى التضحية، 2. الربط بين الابتلاء والصبر يُظهر أن الصبر عند وقوع البلاء هو ميزان الإيمان، 3. الربط بين الصبر والرحمة والهداية يرسّخ أن الصبر طريق لنيل الرحمة الإلهية والوصول إلى الهدى.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف وصفت الآيات حال الشهداء في سبيل الله؟، 2. ما أنواع الابتلاءات التي ذكرها الله؟، 3. ما موقف الصابرين عند المصائب؟، 4. ما الجزاء الذي وعد الله به الصابرين؟، 5. كيف تربط الآيات بين الصبر والهداية؟
۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)
عنوان موضوعي: السعي بين الصفا والمروة كعبادة من شعائر الله
التفسير: تبيّن الآية أن السعي بين الصفا والمروة عبادة عظيمة من شعائر الله التي أمر بها عباده، لما فيها من إحياء ذكر الله وتعظيم أمره، فهي ليست عادة جاهلية، بل شعيرة خالصة لله تعالى. وتوضح أن من أدى الحج أو العمرة فلا حرج عليه أن يسعى بينهما، لأن هذا السعي عبادة مشروعة مأمور بها، وقد نُفي الحرج بعد أن كان بعض المسلمين يتحرجون منه في أول الإسلام بسبب ما كان عليه الجاهليون من وضع الأصنام عليهما. وتختم الآية ببيان فضل التطوع بالخير في العبادة، وأن الله يشكر لعباده كل عمل صالح، ويعلم نواياهم وأعمالهم، مما يدل على أن العبادة المقبولة هي ما كان خالصًا لله وموافقة لأمره.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن ذكرت الآيات السابقة الصبر على الابتلاء والجزاء الإلهي للصابرين، جاءت هذه الآية لتبيّن جانبًا من مظاهر العبادة والطاعة، وهو السعي بين الصفا والمروة، لتربط بين الإيمان العملي والصبر في أداء العبادات، وتؤكد أن التقرب إلى الله يكون بالعمل الصالح والطاعة الخالصة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين شعائر الله والتوحيد يوضّح أن السعي عبادة خالصة لله لا صلة لها بالجاهلية، 2. الربط بين رفع الحرج وتشريع العبادة يُبرز أن الإسلام دين يُيسّر ولا يُعسّر، 3. الربط بين التطوع ومقام الشكر الإلهي يؤكد أن الله يثيب على كل عمل صالح مهما كان صغيرًا إذا كان خالصًا له.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الشعيرة التي ذكرتها الآية وما حكمها؟، 2. لماذا كان بعض المسلمين يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة؟، 3. ما فضل التطوع بالخير في ضوء الآية؟، 4. كيف وصفت الآية الله في ختامها؟، 5. ما العلاقة بين تعظيم شعائر الله والعبادة الخالصة له؟
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ (159) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (160) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ (161) خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ (162)
عنوان موضوعي: عقوبة كتمان الحق والتوبة من الكفر
التفسير: تبيّن الآيات شدة عقوبة الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى بعد أن أوضحه للناس في الكتاب، فهؤلاء يستحقون لعنة الله ولعنة جميع اللعّانين من الملائكة والمؤمنين، لأنهم أخفوا الحق وضللوا الناس عن سبيل الله. ومع ذلك تفتح الآيات باب الأمل، فتستثني من هذه العقوبة من تابوا توبة صادقة، وأصلحوا ما أفسدوا، وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمون، فهؤلاء يتوب الله عليهم، لأنه تواب رحيم يقبل التوبة عن عباده. ثم تذكر الآيات مصير من ماتوا على كفرهم دون توبة، بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين في العذاب الذي لا يخفف عنهم ولا يؤخر، فيبقى جزاؤهم أبديًا جزاءً لإصرارهم على الكفر حتى الموت.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن عبادة المؤمنين المخلِصين وبيان فضل التوحيد، جاءت هذه الآيات لتحذّر من عكس ذلك، وهو كتمان الحق أو إنكاره بعد ظهوره، مبيّنة أن العبادة الحقة لا تكتمل إلا بالتصريح بالحق ونشر الهداية، مع التأكيد أن رحمة الله مفتوحة للتائبين، وأن الإصرار على الكفر يؤدي إلى اللعنة الأبدية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين كتمان الحق واستحقاق اللعنة يرسّخ أن كتمان البينات أعظم الخيانات، 2. الربط بين التوبة ورفع العقوبة يوضّح أن باب الرحمة مفتوح لمن تاب وأصلح، 3. الربط بين الموت على الكفر والعذاب الأبدي يبيّن خطورة الإصرار على الكفر حتى النهاية.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما عقوبة من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى؟، 2. ما الشروط التي تضعها الآيات لقبول التوبة من كتمان الحق؟، 3. ما جزاء الكفار الذين يموتون على كفرهم؟، 4. كيف وصفت الآيات عذابهم في الآخرة؟، 5. ما العلاقة بين كتمان الحق واستحقاق لعنة الله؟
وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ (164)
عنوان موضوعي: وحدانية الله ودلائل قدرته
التفسير: تبدأ الآيات بتقرير أعظم أصول العقيدة، وهو أن الله وحده لا إله إلا هو، لا شريك له في الخلق ولا في العبادة، ثم تُثني عليه بأسمائه الحسنى: الرحمن الرحيم، الدالّين على سعة رحمته ولطفه بخلقه. وتلفت الآيات الأنظار إلى دلائل قدرته ووحدانيته في الكون، موجهة الخطاب إلى أصحاب العقول ليتفكروا في آيات الله المبثوثة في الوجود. فتعدّد مظاهر قدرته العظيمة: خلق السماوات والأرض، وتعاقب الليل والنهار بهذا النظام الدقيق، وتسخير البحر لتجري فيه السفن محمّلة بمنافع الناس، وإنزال المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها، ونشر الكائنات في أرجائها، وتصريف الرياح والسحاب بين السماء والأرض. كل ذلك يجري بأمر الله وحده، لا يشاركه فيه أحد، وهو البرهان الواضح على وحدانيته المطلقة. وتُختتم الآية ببيان أن هذه الدلائل الكونية موجّهة لأولي الألباب، ليتدبروا ويتبينوا أن الله هو الخالق المدبر المستحق وحده للعبادة والطاعة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة كتمان الحق وعاقبة الكافرين، جاءت هذه الآيات لتفتح باب التأمل في دلائل الإيمان الواضحة في الكون، وتبيّن أن من كتم الحق أو جحده فقد خالف الفطرة والعقل، لأن مظاهر قدرة الله شاهدة على وحدانيته في كل ما خلق وقدّر.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين وحدانية الله وآيات الكون يوضّح أن الإيمان الحق يقوم على التفكر في الخلق، 2. الربط بين دلائل الخلق والدعوة للتفكر يُبرز تسلسل المشاهد الكونية من السماء إلى الأرض مما يسهل الحفظ والتأمل، 3. الربط بين صفات الرحمة والقدرة يُظهر كمال التوحيد في الجمع بين الجلال والإحسان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الصفات التي وصفت بها الآيات الله تعالى؟، 2. ما أبرز الدلائل الكونية التي تذكّر بقدرة الله ووحدانيته؟، 3. ما الغاية من ذكر هذه الآيات الكونية؟، 4. كيف يدل انتظام الكون على وحدانية الله؟، 5. ما العلاقة بين استخدام العقل والتوصل إلى الإيمان في هذه الآيات؟
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ (165) إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ (166) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (167)
عنوان موضوعي: الشرك وحسرة الكافرين يوم القيامة
التفسير: تصف الآيات حال المشركين الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كمحبة المؤمنين لله، فسوّوا بين الخالق والمخلوق في المحبة والتعظيم، وهو أعظم الظلم، لأن العبادة والخضوع الكامل لا يليقان إلا بالله وحده. وتُبرز المفارقة بين حب المشركين الجاهل القائم على تقليد وضلال، وحب المؤمنين الصادق القائم على معرفة الله وتوحيده، فالمؤمنون أشد حبًّا لله لأنهم يدركون عظمته ويُخلصون له. ثم تنتقل الآيات إلى مشهد يوم القيامة، حين تنكشف الحقيقة وتزول الأوهام، فيرى الكافرون العذاب عيانًا، ويدركون أن القوة كلها لله، وأن أندادهم التي عبدوها لا تملك لهم نفعًا ولا ضرًّا. وهناك تتقطع الروابط بين الأتباع والمتبوعين، فيتبرأ القادة من أتباعهم، وتعلو الحسرة وجوه الجميع، ويتمنّى الأتباع العودة إلى الدنيا ليتبرؤوا من قادتهم كما تبرؤوا منهم، ولكن هيهات؛ فقد انقضى زمن العمل، وبقي الندم الأبدي. وتُختم الآيات بتصوير رهيب لمصيرهم، إذ تُعرض أعمالهم أمامهم كحسراتٍ مؤلمة، فيرون باطل ما عملوا، ولا يجدون مهربًا من النار، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات دلائل قدرة الله ووحدانيته في الكون، ينتقل السياق إلى التحذير من الشرك وبيان عاقبته، ليؤكد أن من اتخذ أندادًا مع الله فقد أضاع حقيقته، وأن مآله الندم والعذاب، بينما التوحيد الخالص هو طريق النجاة والهداية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الشرك وحب غير الله يوضّح أن تسوية غير الله به في المحبة أصل الشرك، 2. الربط بين التبرؤ يوم القيامة وقطع العلاقات يرسّخ أن التبعية في الباطل تنقلب خذلانًا في الآخرة، 3. الربط بين الأعمال الحسرة والعذاب الأبدي يُظهر أن أعمال الكافرين تعود عليهم ندمًا بعد فوات الأوان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما حال المشركين في محبتهم لأندادهم كما وصفتهم الآيات؟، 2. كيف وصفت الآيات حب المؤمنين لله مقارنة بحب المشركين؟، 3. ما المشهد الذي تصوره الآيات عن يوم القيامة؟، 4. ما الأمنية التي يتمناها الأتباع بعد فوات الأوان؟، 5. كيف تختم الآيات الحديث عن مصير المشركين في الآخرة؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ (169)
عنوان موضوعي: الطعام الحلال والتحذير من الشيطان
التفسير: تبدأ الآيات بنداءٍ عامٍ موجهٍ إلى الناس جميعًا، تأمرهم أن يأكلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا، أي مباحًا شرعًا نافعًا في بدنه وروحه، خاليًا من الضرر والخبث، فالأكل الحلال جزء من الطاعة وعبادة الله في الحياة اليومية. ثم يأتي التحذير من اتباع خطوات الشيطان، الذي يزين للناس الانحراف عن الحق، وهو عدوٌّ ظاهر العداوة لا يخفى مكره ولا يخمد شره. وتوضّح الآيات أن الشيطان يسعى لإضلال الإنسان من خلال ثلاث وسائل رئيسية: الأمر بالسوء وهو كل معصية تخالف أمر الله، والأمر بالفحشاء أي المنكرات التي تستقبحها الفطرة وتحرّمها الشريعة، والأمر بالافتراء على الله بغير علم، كتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو ذروة الإضلال. فجمعت الآيات بين الدعوة إلى الانتفاع بنعم الله في الحلال، وبين التحذير من الانسياق وراء وساوس الشيطان المضلّة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن عرضت الآيات السابقة مآل المشركين وحسرتهم يوم القيامة، انتقلت هذه الآيات إلى توجيه الناس نحو الطاعة العملية في حياتهم، بدءًا من أكل الحلال والابتعاد عن المحرمات، محذّرةً من اتباع الشيطان الذي يقود إلى الشرك والضلال، مما يربط بين التوحيد والالتزام بالسلوك اليومي الصحيح.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الأكل الحلال وعبادة الله يوضّح أن الالتزام بالحلال صورة من صور الطاعة، 2. الربط بين خطوات الشيطان والمعاصي يبيّن أن الانحراف يبدأ تدريجيًا بخطوات يسيرة ثم يتسع، 3. الربط بين الكذب على الله والضلال يؤكد أن القول على الله بغير علم من أعظم ما يوقع في الكفر والانحراف.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهته الآيات للناس بشأن الطعام؟، 2. كيف وصفت الآيات الشيطان وعلاقته بالإنسان؟، 3. ما الأمور الثلاثة التي يأمر بها الشيطان وفق الآيات؟، 4. كيف ترتبط طاعة الله في الطعام بالحذر من الشيطان؟، 5. ما الغاية من الجمع بين الأمر بأكل الحلال والتحذير من الشيطان؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ (170) وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ وَنِدَآءٗۚ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ (171)
عنوان موضوعي: اتباع التقليد الأعمى وحال الكافرين
التفسير: تصف الآيات موقف الكافرين حين يُدعون إلى اتباع ما أنزل الله من الوحي والهدى، فيرفضون الانقياد للحق، متمسكين بعادات آبائهم وموروثاتهم، حتى وإن كانت قائمة على الضلال والجهل. وتبيّن أن هذا التمسك الأعمى بالتقليد يجعلهم أسرى للعادات لا للعقل، فيعطلون فكرهم عن التمييز بين الحق والباطل. ثم تضرب الآيات مثلًا بليغًا لهم، إذ تُشبههم بالأنعام التي تسمع أصوات الراعي لكنها لا تفهم ما يُقال، فالكافر يسمع آيات الله كما تُسمع الأصوات دون أن يعقل معناها أو ينتفع بها. وتصفهم الآيات بأنهم صمّ عن سماع الحق، بكم عن نطقه، عمي عن إدراك آيات الله، فصاروا في ظلماتٍ من الجهل والضلال لا يهتدون إلى سبيل الرشاد.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن دعت الآيات السابقة إلى أكل الحلال وترك اتباع خطوات الشيطان، تأتي هذه الآيات لتحذر من نوعٍ آخر من الانقياد الباطل، وهو التقليد الأعمى للآباء والأجداد، لأنه من أساليب الشيطان في إضلال الناس. وهكذا يتكامل المعنى بين التوحيد القائم على الفهم، والتحذير من التبعية التي تُطفئ نور العقل والإيمان.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التقليد الأعمى ورفض الوحي يُظهر أن من قدّم عادات الآباء على هدى الله ضل عن الحق، 2. الربط بين المثل المضروب وفقدان الإدراك يُجسّد حال الكافر الذي يسمع دون فهم كالبهيمة التي تسمع الصوت بلا معنى، 3. الربط بين الصمم والبكم والعمى وضياع الهداية يرسّخ أن إهمال العقل يطفئ وسائل الهداية كلها.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما ردّ الكافرين حين يُطلب منهم اتباع ما أنزل الله؟، 2. كيف وصفت الآيات موقفهم من تقاليد آبائهم؟، 3. ما المثل الذي ضربته الآيات لحال الكافرين؟، 4. ما الصفات التي ذكرتها الآيات عن الكافرين؟، 5. كيف توضّح الآيات أثر التقليد الأعمى على العقل والهداية؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ (173)
عنوان موضوعي: الطعام الطيب وتحريم المحرمات
التفسير: تبدأ الآيات بنداء موجه إلى المؤمنين، تأمرهم بالأكل من الطيبات التي رزقهم الله بها، أي المباحات النافعة الطاهرة، مع شكر الله على نعمه، إن كانوا صادقين في عبادتهم له. وتوضّح الآيات ما حرّمه الله من الأطعمة، وهي: الميتة (ما مات دون تذكية شرعية)، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذُكر عليه اسم غير الله عند الذبح. ثم تستثني من التحريم حالة الاضطرار، كأن يُضطر الإنسان إلى أكل شيء من ذلك خوفًا على حياته، بشرط ألا يتجاوز الحد ولا يتعمّد الأكل من المحرم رغبةً فيه، وتختم الآيات ببيان سعة رحمة الله وغفرانه لمن اضطر، تأكيدًا على أن التشريع الإلهي قائم على اليسر والرحمة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن حذّرت الآيات السابقة من اتباع الشيطان وبيّنت طريق الهداية، جاء هذا المقطع ليشرح التطبيق العملي للطاعة، من خلال الالتزام بما أحل الله واجتناب ما حرّم، فيتجلى أن العبادة لا تقتصر على الشعائر، بل تشمل السلوك اليومي حتى في الطعام والشراب.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الطيبات والشكر لله يوضح أن الأكل من الحلال عبادة تُقترن بالشكر والاعتراف بفضل الله، 2. الربط بين التحريم والتوحيد يُظهر أن ما يُذكر عليه اسم غير الله محرّم لأنه يمس أصل التوحيد، 3. الربط بين الاضطرار والتيسير الإلهي يرسّخ أن شريعة الله قائمة على الرحمة والتوازن فلا حرج على المضطر ما دام غير متعدٍّ.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهته الآيات للمؤمنين بخصوص الطعام؟، 2. ما الأطعمة التي حرّمتها الآيات؟، 3. ما شروط استثناء الاضطرار من التحريم؟، 4. كيف ختمت الآيات ببيان صفة الله؟، 5. ما العلاقة بين شكر الله والالتزام بتجنّب المحرمات؟
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ (175) ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ (176)
عنوان موضوعي: عقوبة كتمان الحق واستبداله بالباطل
التفسير: تتحدث الآيات عن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من الحق والهدى، رغبةً في مكاسب دنيوية زائلة من مالٍ أو جاه، فيبيعون آيات الله بثمنٍ قليل، غير مبالين بعاقبة فعلهم. وتصف حالهم يوم القيامة وصفًا مهيبًا، إذ يكون ما يأكلونه كالنار التي تشتعل في بطونهم، ويُحرمون من كلام الله ومن نظره إليهم، فلا يزكّيهم ولا يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم جزاءً لكتمانهم وتحريفهم. وتوضح الآيات أنهم باعوا الهدى بالضلالة، والمغفرة بالعذاب، واستبدلوا النور بالعمى، في مشهدٍ يجسّد عاقبة من قلب الحق باطلًا. وتختم الآيات بتعجبٍ من جرأتهم على احتمال نار جهنم، وتبيّن أن سبب عذابهم هو مخالفتهم لما أنزل الله من الحق، وأن ما أحدثوه من اختلافٍ وشقاقٍ في الدين إنما هو بعدٌ تام عن الصراط المستقيم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تناولت الآيات السابقة الحديث عن الأطعمة الحلال والحرام وأحكام الطيبات، تأتي هذه الآيات لتُبيّن خطورة من يُحرّف التشريعات أو يُخفي الحق الذي أنزله الله، مبينةً أن كتمان الوحي أصل كل انحراف وتشويه في الدين، وأن ذلك يقود صاحبه إلى الخسران في الدنيا والآخرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين كتمان الحق والطمع الدنيوي يوضّح أن دافع التحريف هو حب الدنيا على حساب الآخرة، 2. الربط بين العقوبة وحرمان التزكية يبرز أن كتمان الحق يُطفئ النور الداخلي فيُحرم صاحبه من الطهارة والقبول، 3. الربط بين الضلالة والشقاق يُظهر أن من بدّل كلام الله بالباطل تفرّق عن الهدى وابتعد عن الصراط المستقيم.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما وصف الآيات لمن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؟، 2. ما العقوبات التي ذكرتها الآيات لهؤلاء يوم القيامة؟، 3. ما الاختيارات الخاطئة التي قاموا بها كما وصفتها الآيات؟، 4. ما السبب الأساسي لعذابهم كما ورد في الآيات؟، 5. كيف توضّح الآيات أن كتمان الحق يؤدي إلى شقاقٍ بعيدٍ عن الهداية؟
۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ (177)
عنوان موضوعي: حقيقة البر وأركانه
التفسير: تصحّح الآية مفهومًا خاطئًا عن البر، موضّحة أنه لا يقتصر على المظاهر الشكلية كالتوجّه في الصلاة نحو المشرق أو المغرب، بل هو أوسع وأعمق من ذلك، إذ يقوم على الإيمان الصادق والعمل الصالح. وتفصّل الآية أركان البر الحقيقي، فتبدأ بأساسه العقائدي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والرسل، لأن العقيدة هي الأصل الذي تُبنى عليه جميع الأعمال. ثم تبيّن أركانه العملية، وأبرزها الإنفاق من المال مع شدة حبّه، في وجوه الخير: كالأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي تحرير الرقاب. وتذكر بعد ذلك ركني العبادة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم تنتقل إلى جانب الأخلاق من خلال الوفاء بالعهد، وتختم بذكر الصبر في الشدائد كالفقر والمرض وأوقات القتال. وتختم الآية بمدح من جمع هذه الصفات بأنه الصادق في إيمانه، المتقي الذي يسير على طريق الهداية.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد التحذير من كتمان الحق وبيان عقوبة المفسدين، جاءت هذه الآية لتقدّم الصورة الكاملة للبر الحقيقي، مؤكدة أن الإيمان لا يتحقق بالمظاهر أو الشعارات، بل بالاعتقاد الحق والعمل الصالح والخلق القويم، مما يوازن بين العقيدة والسلوك العملي.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تصحيح المفهوم والواقع العملي يوضّح أن البر ليس شكليًا بل جوهريًّا يقوم على الإيمان والعمل، 2. الربط بين أركان البر وتكامل الدين يُظهر أن البر يجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة، 3. الربط بين الصدق والتقوى وثمرة البر يبيّن أن البر الحق طريقٌ إلى الصدق والإيمان الكامل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف صححت الآية مفهوم البر؟، 2. ما أركان الإيمان التي ذكرتها الآية؟، 3. ما صور العمل الصالح التي عدّتها الآية من البر؟، 4. ما الصفات الأخلاقية التي أكدت عليها الآية؟، 5. ما الجزاء الذي وعدت به الآية لمن يلتزم بهذه الصفات؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ (178) وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (179)
عنوان موضوعي: تشريع القصاص ورحمته
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين بتطبيق حكم القصاص في القتلى لتحقيق العدالة والمساواة، فيُقتل القاتل بالمقتول دون تجاوز أو ظلم، كما جاء في قوله تعالى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ثم تفتح الآيات باب الرحمة والتسامح، فتُجيز لأولياء الدم أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، بشرط أن يكون العفو باتفاق الطرفين، وأن يُؤدَّى التعويض (الدية) بالمعروف والإحسان دون بخس أو إكراه. وتُبيّن أن هذا التشريع من تخفيف الله ورحمته بعباده، لأنه يجمع بين العدل والرحمة، ويردع القاتل ويمنع الفوضى والانتقام. وتختم الآيات بالتأكيد على أن في القصاص حياةً للأمة، لأنه يمنع تكرار الجريمة ويحقق الأمن، وتدعو أصحاب العقول إلى إدراك هذه الحكمة والتقوى في تطبيق أمر الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة أركان البر والإيمان والعمل الصالح، جاءت هذه الآيات لتُظهر أن الدين لا يقتصر على العقيدة والعبادة، بل يشمل تنظيم الحياة الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الناس، فيبرز بذلك توازن الشريعة بين حق الله وحقوق العباد.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين القصاص والعدالة يوضّح أن حفظ النفس لا يتحقق إلا بالعدل، 2. الربط بين العفو والرحمة الإلهية يبيّن أن التشريع يجمع بين الحق والفضل، 3. الربط بين القصاص والحياة يُبرز أن الردع المنضبط سبيلٌ لحماية المجتمع ودعوةٌ للتقوى.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الحكم الذي شرعته الآيات في القتل العمد؟، 2. ما موقف الإسلام من العفو والدية في القصاص؟، 3. ما الغاية من تشريع القصاص كما ورد في الآيات؟، 4. ما أثر القصاص في المجتمع بحسب الآيات؟، 5. كيف يجمع هذا التشريع بين العدل والرحمة؟
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ (180) فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (181) فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (182)
عنوان موضوعي: تشريع الوصية وحكم تعديلها
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين عند حضور الموت بإعداد الوصية لمن يترك مالًا (خيرًا)، لتكون للوالدين والأقربين، وفقًا للمعروف والعدل، دون ظلم أو محاباة. وتبيّن أن تنفيذ الوصية حق واجب على المتقين الذين يراعون حدود الله ويحفظون حقوق الناس. ثم تحذر الآيات من تبديل الوصية بعد سماعها، لأن من يغيّرها يتحمّل الإثم وحده، والله سميع عليم بما يفعلون، فيعلم النوايا والمقاصد. وتوضح الآية الأخيرة حالة استثنائية، وهي إذا خشي الشخص المكلّف بتنفيذ الوصية وقوع انحراف أو ظلمٍ من الموصي، فقام بإصلاح الأمر بين الورثة بالعدل، فلا إثم عليه، لأن الله غفور رحيم بمن يسعى لإقامة العدل والإصلاح.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تناولت الآيات السابقة تشريع القصاص وإقامة العدل بين الناس، جاءت هذه الآيات لتستكمل بناء النظام الاجتماعي الإسلامي، بتشريع يضمن العدل في توزيع الحقوق المالية بعد الموت، ويحمي الوصية من العبث أو الظلم، مما يُظهر تكامل التشريع الإلهي بين العدالة في الحياة والحقوق بعد الوفاة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الوصية والعدل المالي يبيّن أن الوصية حق للأقربين تحفظ المودة والعدل بعد الموت، 2. الربط بين تبديل الوصية والمساءلة يُظهر أن العبث بأحكام الله موجب للإثم والعقوبة، 3. الربط بين الإصلاح والرحمة الإلهية يؤكد أن السعي لتصحيح الظلم عمل محمود يغفر الله لصاحبه ويرحمه.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. لمن تجب الوصية وفقًا للآيات؟، 2. ما حكم من يبدّل الوصية بعد سماعها؟، 3. متى يجوز تعديل الوصية دون إثم؟، 4. ما الصفات التي ختم الله بها هذه الآيات؟، 5. كيف تربط الآيات بين العدل في الوصية والتقوى؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (184) شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ (186)
عنوان موضوعي: تشريع الصيام وفضل الدعاء
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين بعبادة الصيام، كما فُرضت على الأمم السابقة، تحقيقًا لغاية عظيمة هي التقوى، وتهذيب النفس وصونها عن المعاصي. وتوضح أن الصيام في أيام معدودات، مع رخصةٍ للمريض والمسافر بالإفطار وقضاء ما فاتهم لاحقًا، وتُجيز الفدية لمن يشق عليهم الصيام بشرط أن يطعموا مسكينًا، مع الحث على التطوع لمن استطاع الصيام فهو خير له. وتبيّن أن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، هدىً للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان، ولذلك أُمر من شهده أن يصومه، مع تكرار الرخصة للمريض والمسافر بشرط القضاء، تأكيدًا أن الله يريد اليسر بعباده ولا يريد العسر، وأن الغاية إكمال العدة وشكر الله على نعمة الهداية. ثم تأتي الآية الجامعة التي تُظهر قرب الله من عباده واستجابته لدعاء الداع إذا دعاه، بشرط الإيمان والاستجابة له، ليكون الدعاء وسيلة للصلة بالله وتحقيق الرشد.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر التشريعات الاجتماعية التي تنظم حياة الناس كأحكام القصاص والوصية، تنتقل هذه الآيات إلى تشريع عبادة روحية سامية، وهي الصيام، لتربط بين إصلاح المجتمع بالعدل وإصلاح الفرد بالتقوى، وتُتوج المقطع بفضل الدعاء الذي يعبّر عن العلاقة القلبية بين العبد وربه.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الصيام والتقوى يوضّح أن المقصود من العبادة تهذيب النفس لا مجرد ترك الطعام، 2. الربط بين التشريع والتيسير يُظهر رحمة الله في الرخص التي شرعها لعباده، 3. الربط بين رمضان والقرآن والدعاء يرسّخ أن الشهر موسم للهداية والتوبة والقرب من الله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الهدف من فرض الصيام كما ورد في الآيات؟، 2. ما الحالات التي رخص الله فيها بالفطر؟، 3. لماذا سُمّي رمضان بشهر القرآن؟، 4. كيف تصف الآيات قرب الله من عباده واستجابته لهم؟، 5. ما العلاقة بين الصيام والشكر في هذه الآيات؟
أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ (187)
عنوان موضوعي: أحكام الصيام والجماع والإفطار
التفسير: تبيّن الآية أن الله أباح للمؤمنين الجماع مع زوجاتهم في ليالي الصيام بعد أن كان ممنوعًا في بداية فرض الصوم، تخفيفًا ورحمةً منه، وتصف العلاقة الزوجية بأنها علاقة قربٍ وسكنٍ وسترٍ متبادل، في قوله: “هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ“، تعبيرًا عن الحميمية والمودة بين الزوجين. وتذكر أن بعض المؤمنين خالفوا الحكم الأول سرًا، فعفا الله عنهم وتاب عليهم، ثم أباح لهم ذلك في الليل. كما توضح الآية أنه يجوز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر الصادق، أي ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يجب الإمساك إلى غروب الشمس. وتنهي الآية عن الجماع أثناء الاعتكاف في المساجد، لأن ذلك من حدود الله التي يجب ألا تُتعدّى. وتُختم الآية بتأكيد أن الله يبيّن للناس أحكامه وآياته بوضوح ليزدادوا تقوىً وطاعةً له، فالشريعة رحمةٌ وتزكيةٌ وتنظيم للحياة وفق منهج الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تناولت الآيات السابقة فرض الصيام وبيان حكمته، جاء هذا المقطع مكمّلًا للتشريع ببيان التفاصيل العملية للصيام، كأحكام الجماع، والطعام، والشراب، والاعتكاف، مما يُظهر توازن الشريعة بين مراعاة الفطرة الإنسانية وتحقيق التقوى الإيمانية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التيسير والرخصة في الجماع يبيّن أن التشريع الإسلامي يراعي الطبيعة البشرية ويقدّم الرخصة بعد المنع لحكمة ورحمة، 2. الربط بين الوقت والتكليف يُوضح بدقة حدود الصيام من الفجر إلى الغروب باستخدام التعبير البياني “الخيط الأبيض والأسود”، 3. الربط بين احترام حدود الله والتقوى يؤكد أن ضبط السلوك والالتزام بالأوامر طريق لنمو الإيمان وتحقيق التقوى.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الحكم الذي أوضحته الآية بشأن الجماع في ليالي الصيام؟، 2. كيف وصفت الآية العلاقة بين الزوجين؟، 3. ما الوقت الذي حدّدته الآية لبداية الإمساك والإفطار؟، 4. ما التحذير المتعلق بالاعتكاف في المساجد؟، 5. كيف تربط الآية بين بيان الأحكام وتحقيق التقوى؟
وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (188)
عنوان موضوعي: تحريم أكل الأموال بالباطل والرشوة
التفسير: تحذّر الآية المؤمنين من أكل أموال الناس بغير حق، أي بالطرق الباطلة كالسرقة والغش والاحتيال والخداع، فكل ما يُؤخذ دون وجه شرعي يعد ظلمًا وإثمًا عظيمًا. وتنهى الآية عن استخدام الأموال في إغراء الحكام أو دفع الرشاوى لتحريف الأحكام أو الحصول على حقوق ليست لصاحبها، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع العدالة وأكل أموال الناس ظلمًا. وتؤكد الآية أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وخاصة إذا كان مع علم صاحبه بخطورته وإصراره عليه، مما يدل على انحراف الأخلاق وفساد الإيمان.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تناولت الآيات السابقة أحكام الصيام وأثره في تهذيب النفس وضبط الشهوات، جاءت هذه الآية لتربط العبادة بالسلوك العملي، مؤكدة أن التقوى لا تتحقق بالصيام فقط، بل أيضًا بالعدل والنزاهة في التعاملات المالية، وأن العبادة الصادقة تُترجم إلى أمانة وعدل بين الناس.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين المعاملات والعبادات يوضّح أن العبادة الحقة تشمل الأمانة المالية كما تشمل الصيام والصلاة، 2. الربط بين الباطل والعدالة القضائية يرسّخ خطر الرشوة في هدم العدل وتبديل الحقوق، 3. الربط بين العلم والإثم يبيّن أن ارتكاب الذنب عن علم يزيد العقوبة ويؤكد عِظَم الجريمة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما التحذير الذي وجّهته الآية بخصوص أموال الناس؟، 2. ما الوسيلة التي يستعملها بعض الناس لأخذ أموال غيرهم بغير حق؟، 3. كيف وصفت الآية من يأكل أموال الناس ظلمًا؟، 4. ما العلاقة بين العدالة في المال والتقوى؟، 5. ما أثر النهي عن أكل الأموال بالباطل في إصلاح المجتمع؟
۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ وَلَيۡسَ ٱلۡبِرُّ بِأَن تَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأۡتُواْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أَبۡوَٰبِهَاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (189)
عنوان موضوعي: الأهلة ومفهوم البر الصحيح
التفسير: تبدأ الآية بالإجابة عن تساؤل الناس حول الأهلة، فتوضح أن تغيّر شكل القمر من الهلال إلى البدر ثم عودته هلالًا هو نظامٌ إلهي لتحديد المواقيت الزمنية للناس، كمعرفة مواعيد العبادات من صيامٍ وحجٍ ومعاملاتٍ شرعية. ثم تنتقل الآية لتصحيح مفهومٍ خاطئ للبر، إذ كان بعض العرب إذا أحرموا بالحج لا يدخلون بيوتهم من أبوابها بل من خلفها، ظنًا منهم أن ذلك من التقوى، فبيّنت أن البر ليس في المظاهر أو الأفعال الشكلية، بل في طاعة الله والتزام أوامره. وتختم الآية بتوجيهٍ عمليٍّ واضح: )وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا(، رمزًا للسلوك المستقيم في الدين والدنيا، مقرونًا بالأمر بالتقوى التي هي أساس الفلاح والهداية.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن تناولت الآيات السابقة التشريعات المتعلقة بالأموال والمعاملات، جاءت هذه الآية لتبيّن جانبًا من التشريعات العبادية، مثل تنظيم الزمن بالهلال وتصحيح المفاهيم الخاطئة في العبادة، مؤكدة أن التقوى هي روح العبادات، وأن العمل الصالح لا يُقبل إلا إذا وافق أمر الله لا العادات أو المظاهر.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الزمن والعبادة يُظهر أن الأهلة وسيلة لتنظيم العبادات في أوقاتها المشروعة، 2. الربط بين المظاهر والتقوى يوضّح أن البر الحقيقي في طاعة الله لا في الطقوس الشكلية، 3. الربط بين الفعل الرمزي والهداية يجعل “الدخول من الأبواب” مثالًا على السير في الطريق المستقيم في العبادة والعمل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الغرض من الأهلة كما بينته الآية؟، 2. ما المفهوم الخاطئ للبر الذي صححته الآية؟، 3. ما معنى الدخول من أبواب البيوت في سياق الآية؟، 4. كيف ترتبط التقوى بالفلاح كما وردت في الآية؟، 5. ما العلاقة بين تصحيح المفاهيم الدينية والعمل بالتقوى في الإسلام؟
وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ (190) وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ (191) فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (192) وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ (193) ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ (194)
عنوان موضوعي: أحكام القتال في سبيل الله وحدود العدل فيه
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين بالقتال في سبيل الله دفاعًا عن الدين وردًّا للعدوان، مع النهي الصريح عن الاعتداء، لأن الله لا يحب المعتدين. وتبيّن أن القتال في الإسلام مشروع لرفع الظلم لا لطلب الدنيا أو العدوان، وأنه يُوجَّه فقط ضد من بدأ الحرب على المسلمين، كما تأمر بإخراج المعتدين من ديارهم كما أخرجوا المسلمين من ديارهم. وتوضّح أن الفتنة، أي الشرك والاضطهاد عن الدين، أشد من القتل، لأنها تفسد العقيدة وتمنع حرية الإيمان. وتنهى الآيات عن القتال في المسجد الحرام إلا إذا بدأ المعتدون القتال فيه، فإن كفّوا وجب الكف عنهم لأن الله غفور رحيم، فالغاية إنهاء الفتنة وتوحيد الدين لله، لا سفك الدماء. وتؤكد أن العدوان لا يكون إلا على الظالمين، كما تقرر مبدأ المماثلة في الرد على العدوان دون تجاوز: “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”، وتختم بالأمر بالتقوى لأن الله مع المتقين في كل حال، في الحرب والسلم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان أحكام العبادة والإنفاق والصيام، تنتقل الآيات إلى تشريع القتال باعتباره ضرورة لحماية الدين ورفع الظلم، فيظهر التكامل بين العبادة الروحية والجهاد العملي، وأن الإسلام يجمع بين الرحمة والحزم في إقامة العدل.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين العبادة والدفاع عن الحق يوضّح أن القتال وسيلة لحماية الدين ورد العدوان لا للعداوة، 2. الربط بين العدل والقصاص يبيّن أن الرد على الاعتداء يكون بمثله دون تجاوز مع لزوم التقوى، 3. الربط بين إنهاء الفتنة وتحقيق التوحيد يرسّخ أن الهدف من القتال هو رفع الفتنة وجعل الدين خالصًا لله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الغاية من القتال كما بيّنتها الآيات؟، 2. ما القواعد التي وضعها القرآن بشأن القتال في سبيل الله؟، 3. ما المقصود بالفتنة ولماذا وُصفت بأنها أشد من القتل؟، 4. ما حكم القتال في المسجد الحرام وفقًا للآيات؟، 5. كيف تؤكد الآيات أهمية التقوى أثناء القتال؟
وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْ إِۛنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (195)
عنوان موضوعي: الإنفاق في سبيل الله والإحسان
التفسير: تأمر الآية المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله، أي بذل المال في أوجه الخير التي تعود بالنفع على الدين والمجتمع، كدعم الجهاد، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وإقامة الأعمال الصالحة. وتحذّر الآية من ترك الإنفاق أو التقصير فيه، لأن ذلك يؤدي إلى التهلكة، سواء بهلاك الإيمان أو بضعف الأمة وضياع قوتها. وتدعو الآية إلى الإحسان في كل عمل، ليكون الإنفاق مقرونًا بالإخلاص والإتقان، وتختم ببيان أن الله يحب المحسنين الذين يجعلون عطائهم خالصًا لوجهه، فيجمعون بين العمل والنية الصالحة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر أحكام القتال في سبيل الله، تأتي هذه الآية لتبيّن أن الجهاد لا يقوم بالسيف وحده، بل يحتاج إلى دعم مادي من المؤمنين، فالنصر يتحقق بتكامل الجهد والمال والإحسان في العمل، لا بالمواجهة فقط.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين القتال والإنفاق يوضّح أن المال والسلاح جناحا النصر في سبيل الله، 2. الربط بين التقصير والتهلكة يبيّن أن ترك الإنفاق يؤدي إلى ضعف الأمة وهلاكها، 3. الربط بين الإحسان ومحبة الله يرسّخ أن أفضل الإنفاق ما كان بإتقان وإخلاص.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهته الآية للمؤمنين بشأن الإنفاق؟، 2. ما المقصود بالتهلكة التي حذّرت منها الآية؟، 3. كيف ربطت الآية بين الإنفاق والإحسان؟، 4. ما الصفات التي يحبها الله كما وردت في الآية؟، 5. كيف تبيّن الآية العلاقة بين العمل المادي (الإنفاق) والمعنوي (الإحسان) في سبيل الله؟
وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (196) ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ (197) لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (199) فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ (200) وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (201) أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ (202) ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ (203)
عنوان موضوعي: أحكام الحج والعمرة وأهمية الذكر والتقوى
التفسير: تأمر الآيات بإتمام الحج والعمرة لله على الوجه الأكمل دون تقصير، إلا لمن عُذر بعذر شرعي كالإحصار أو المرض، فعليه حينئذٍ ذبح ما تيسّر من الهدي ثم التحلل. ومن حلق رأسه أو قصره لعذر فعليه فدية، وهي: صيام أو صدقة أو نسك. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي شكر، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة عند الرجوع. وتوضّح الآيات أن الحج يُؤدّى في أشهر معلومات، ويُنهى فيه عن الرفث والفسوق والجدال، صيانةً لنقاء العبادة وخشوعها. وتؤكد أن خير الزاد هو التقوى، فهي الزاد المعنوي الذي يُعين الحاج على طاعة الله. كما تحثّ على الإكثار من ذكر الله عند الإفاضة من عرفات والمشعر الحرام، لأن الذكر هو روح العبادة، وتستمر الدعوة إلى ذكر الله بعد قضاء المناسك، مع التذكير بعفوه ورحمته. وتفرّق الآيات بين من يقصر دعاءه على الدنيا فيضيع أجره في الآخرة، ومن يدعو بخير الدنيا والآخرة، وهو الفائز الحقيقي. وتُبيّن أن أيام التشريق (الأيام المعدودات) من شعائر الذكر، ومن تعجّل في النفر يومين أو تأخّر إلى الثالث فلا إثم عليه بشرط التقوى، مما يختتم المقطع بتأكيد محوري على مراقبة الله في كل عمل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الإنفاق والقتال في سبيل الله، جاءت هذه الآيات لتشريع عبادة الحج والعمرة، باعتبارهما ذروة الطاعة والخضوع، ولتغرس في النفوس أن العبادة ليست حركات ظاهرية بل هي تربية على التقوى والذكر والخضوع لله، لتربط بين الجهاد المادي والجهاد الروحي.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإتمام والتقوى يوضّح أن كمال العبادة يتحقق بإخلاص النية ومراقبة الله، 2. الربط بين المناسك والذكر يبيّن أن الذكر هو روح الحج في كل مراحله، 3. الربط بين الدعاء والمصير يرسّخ أن الدعاء الصادق يشمل خير الدنيا والآخرة، وهو علامة الوعي الإيماني الكامل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما حكم الإحصار في الحج والعمرة وما الفدية الواجبة فيه؟، 2. كيف تؤكد الآيات أهمية التقوى في أداء المناسك؟، 3. ما السلوكيات التي نُهي عنها الحاج أثناء المناسك؟، 4. ما الفرق بين من يدعو للدنيا فقط ومن يدعو لخيري الدنيا والآخرة؟، 5. ما الحكمة من تكرار ذكر الله في مواطن الحج المختلفة؟
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلۡإِثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۖ وَلَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ (206) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ (207)
عنوان موضوعي: المنافقون والمخلصون: صفاتهم وعواقب أفعالهم
التفسير: تصف الآيات حال المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُخفون الفساد، فهم يُعجبون الناس بحديثهم المنمّق في الدنيا، ويشهدون الله على ما في قلوبهم زعمًا بالصدق، لكن أعمالهم تكشف حقيقتهم، إذ يسعون في الأرض للإفساد وإهلاك الزرع والنسل، والله لا يحب المفسدين. وإذا وُعظوا بتقوى الله استكبروا وزادهم الكِبر عنادًا، فكان مآلهم جهنم جزاءً على فسادهم. وفي المقابل، تذكر الآيات صنفًا آخر من الناس وهم المخلصون، الذين يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله، أي يبذلون أرواحهم وأموالهم طاعةً لله وابتغاء ثوابه، فكان جزاؤهم رضا الله ورحمته، إذ ختمت الآيات بقوله تعالى: ( والله رؤوف بالعباد ( تأكيدًا لعنايته بالمخلصين.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر أحكام العبادات كالحج وأهمية التقوى والذكر، جاءت هذه الآيات لتُبرز أثر التقوى في السلوك العملي، ففرّقت بين من يجعل الدين مظهرًا للتزيين والرياء، ومن يعبده بصدقٍ وإخلاصٍ وتضحية، لتُظهر أن الإيمان الحقيقي يُقاس بالأفعال لا بالأقوال.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين القول والعمل يوضّح التناقض بين المنافق الذي يُحسن الكلام ويُفسد في الواقع، والمخلص الذي يضحي ابتغاء مرضاة الله، 2. الربط بين الفساد والعقوبة يرسّخ أن الإفساد في الأرض يقود إلى جهنم، 3. الربط بين التضحية والرحمة الإلهية يُظهر أن من يبيع نفسه لله ينال عنايته ورأفته.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف تصف الآيات من يُعجب الناس قوله ويزعم الإخلاص؟، 2. ما صور الفساد التي يرتكبها هذا الصنف من الناس؟، 3. كيف يكون موقفهم عند النصح بتقوى الله؟، 4. من هو الذي يبيع نفسه لله وما جزاؤه؟، 5. كيف تُبرز الآيات الفرق بين المنافق والمخلص في السلوك والمصير؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ (208) فَإِن زَلَلۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ (210)
عنوان موضوعي: الدعوة إلى السِّلم والتحذير من خطوات الشيطان
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين بالدخول في الإسلام كافة، أي التمسك بجميع تعاليمه وأحكامه دون انتقاء أو تهاون، لأن الإيمان الصادق يقتضي التسليم الكامل لله في كل ما أمر ونهى. وتحذرهم من اتباع خطوات الشيطان الذي لا يدعو إلا إلى المعصية والضلال، فهو عدو ظاهر العداوة للإنسان. ثم تنبههم إلى خطورة الانحراف عن طريق الحق بعد أن جاءهم العلم والبينات، فليس لمن زلّ بعد البيان عذر عند الله. وتختتم بتذكير المؤمنين بعظمة الله وقدرته، فهو عزيز لا يُغلب، حكيم في أفعاله وأحكامه، يحاسب بالعدل. كما تصف مشهد القيامة حين يأتي الله في ظللٍ من الغمام ومعه الملائكة، للفصل بين الخلائق بالحق، فيُجازى كل إنسان بما عمل، ليعلم الجميع أن المرجع والمآل إلى الله وحده، العدل الذي لا يُظلم عنده أحد.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان صفات المنافقين والمخلصين في طاعتهم لله، تأتي هذه الآيات لتدعو المؤمنين إلى الالتزام الكامل بالإسلام والتحذير من الانحراف عن طريق الحق، وتأكيد أن المعصية بعد العلم من خطوات الشيطان التي تؤدي إلى الخسران.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإيمان والطاعة الكاملة يُبيّن أن الإسلام لا يُؤخذ مجتزأً بل يُعمل به كله، 2. الربط بين الزلل والعقوبة يُبرز أن الانحراف بعد البينات يوجب العقاب لأن الله عزيز حكيم، 3. الربط بين التحذير والجزاء يُظهر أن ذكر مشهد القيامة يذكّر بعاقبة العصيان وأن المرجع إلى الله للفصل والعدل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما معنى الدخول في الإسلام كافة كما ذكرت الآيات؟، 2. لماذا نهت الآيات عن اتباع خطوات الشيطان؟، 3. ما عاقبة من يزل بعد وضوح البينات؟، 4. كيف صوّرت الآيات مشهد يوم القيامة؟، 5. ما العلاقة بين الالتزام الكامل بالإسلام وتحقيق التقوى؟
سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ كَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُم مِّنۡ ءَايَةِۭ بَيِّنَةٖۗ وَمَن يُبَدِّلۡ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ (212)
عنوان موضوعي: إنذار بني إسرائيل وزينة الحياة الدنيا للكافرين
التفسير: يأمر الله نبيه ﷺ أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات البينات التي أرسلها الله إليهم من قبل، وهي المعجزات الواضحة التي كانت دليلاً على صدق أنبيائهم، تنبيهًا لهم على ما قابلوها به من كفر وجحود. ثم تحذر الآيات من تبديل نعمة الله بالكفر، أي استبدال الإيمان بالجحود، والشكر بالكفران، مع التذكير بأن عقوبة الله شديدة لمن يبدل النعمة ويكفر بالهداية. وتصف حال الكافرين الذين فُتنوا بزينة الحياة الدنيا، فانشغلوا بالمظاهر المادية وسخروا من المؤمنين لزهدهم فيها، بينما المؤمنون الصادقون يدركون أن النعيم الحقيقي هو في الآخرة. وتختم الآيات بتأكيد أن المتقين سيكونون يوم القيامة في مقامٍ أعلى من الكافرين، وأن الله يرزق من يشاء رزقًا واسعًا لا يُقاس بمقاييس الدنيا، فهو سبحانه الغني الكريم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد دعوة المؤمنين للدخول في الإسلام كافة والتحذير من اتباع الشيطان، تأتي هذه الآيات لتضرب مثالًا واقعيًا في بني إسرائيل الذين بدّلوا نعمة الله، وتحذر من الاغترار بزخارف الدنيا كما فعل الكافرون، مؤكدة أن التفاضل الحقيقي عند الله بالتقوى لا بالمال أو الجاه.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تبديل النعمة والعقوبة يُظهر أن كفر النعم سبب للهلاك والعقوبة، 2. الربط بين الافتتان بالدنيا والسخرية من المؤمنين يُوضح أن الانشغال بالمظاهر يُعمي عن الحق ويؤدي للازدراء بأهل الإيمان، 3. الربط بين الدنيا والآخرة يُبرز أن علو المؤمنين في الآخرة هو الجزاء العادل بعد استهزاء الكافرين بهم في الدنيا.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما السؤال الذي أُمر النبي ﷺ أن يوجهه لبني إسرائيل؟، 2. ما المقصود بتبديل نعمة الله وكيف حذرت الآيات منه؟، 3. كيف تصف الآيات موقف الكافرين من المؤمنين في الدنيا؟، 4. ما جزاء المؤمنين المتقين يوم القيامة؟، 5. ما الدلالة التي تحملها عبارة “والله يرزق من يشاء بغير حساب”؟
كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ (213) أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ (214)
عنوان موضوعي: بعثة الأنبياء واختبار الإيمان
التفسير: تبيّن الآيات أن الناس كانوا أمة واحدة على الفطرة والتوحيد، ثم اختلفوا بسبب البغي والحسد، فبعث الله الأنبياء مبشّرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب السماوية ليحكموا بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه. غير أن أهل الكتاب خالفوا أمر الله واختلفوا بعد مجيء البينات، فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه غيرهم، وهي منّة عظيمة وهداية للصراط المستقيم. ثم تُذكّر الآيات المؤمنين أن طريق الجنة ليس طريق الأماني، بل طريق الصبر والثبات على الابتلاء، كما حدث للأمم السابقة التي ابتُليت بالبأساء والضراء وزُلزلت حتى قال رسلها والمؤمنون معهم: متى نصر الله؟ فجاءهم الجواب الإلهي المطمئن: ألا إن نصر الله قريب.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن زينة الدنيا وافتتان الكافرين بها، تأتي هذه الآيات لتبين أن الاختلاف بين الناس سنة قديمة، وأن الإيمان الحق يُختبر بالصبر على الابتلاء لا بمجرد التمنيات، مما يرسّخ قيمة الثبات في سبيل الحق.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين وحدة الأصل واختلاف المصير يوضّح أن الناس كانوا على التوحيد ثم انحرفوا بالبغي، 2. الربط بين الوحي والاختبار يُظهر أن الإيمان لا يكتمل إلا بالصبر على الفتنة، 3. الربط بين الشدة والنصر يُرسّخ أن النصر يأتي بعد الصبر، كما في قول الله ألا إن نصر الله قريب.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. لماذا بعث الله الأنبياء والكتب السماوية؟، 2. ما سبب اختلاف أهل الكتاب بعد وضوح الحق؟، 3. كيف هدى الله المؤمنين لما اختلف فيه غيرهم؟، 4. ما طبيعة الابتلاءات التي واجهتها الأمم السابقة؟، 5. ما الدلالة التي تحملها عبارة ألا إن نصر الله قريب؟
يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ (215)
عنوان موضوعي: مصارف الإنفاق في سبيل الخير
التفسير: تجيب الآية عن سؤال المؤمنين للنبي ﷺ: ماذا ينفقون وعلى من؟ فتوضح أن المطلوب إنفاق الخير، أي المال الطيب الحلال، وتبيّن أن الإنفاق يجب أن يبدأ بالأقربين وفق ترتيب يحقق التكافل والرحمة، فيُقدَّم الوالدان لما لهما من حقٍّ عظيم، ثم الأقربون من العائلة، يليهم اليتامى الذين فقدوا من يعولهم، ثم المساكين الذين لا يملكون كفايتهم، وأخيرًا ابن السبيل، وهو المسافر المحتاج الذي انقطعت به السبل. وتختم الآية بتذكير المؤمنين أن الله مطّلع على كل خير يفعلونه، فيحفظ لهم الأجر ويجازيهم عليه يوم القيامة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان أن طريق الإيمان يمر بالصبر على الابتلاء، تأتي هذه الآية لتوضّح الجانب العملي للإيمان، وهو الإنفاق في سبيل الله، تعبيرًا عن الإحسان والبذل للمحتاجين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإيمان والعمل الصالح تُظهر الآية أن الصدقة من ثمار الإيمان الصادق، 2. الربط بين القرابة والرحمة يوضّح أن أولى الناس بالإحسان هم الأقربون، 3. الربط بين العمل والجزاء يؤكد أن الله عليم بكل خير، فلا يضيع أجر من أنفق في سبيله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. من هم أولى الناس بالإنفاق حسب الآية؟، 2. ما المقصود بإنفاق “الخير”؟، 3. ما الفئات التي ذكرتها الآية كمستحقين للإنفاق؟، 4. ما الرسالة التي تحملها عبارة فإن الله به عليم؟، 5. كيف تربط الآية بين الإيمان والبذل في سبيل الله؟
كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (216) يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (217) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (218)
عنوان موضوعي: أحكام القتال والتضحية في سبيل الله
التفسير: تؤكد الآيات أن القتال فُرض على المؤمنين رغم كراهيتهم له لأنه يحمل خيرًا لهم في تحقيق العدل وحماية الدين، وتوضح أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرًا له وما يحبه قد يكون شرًا لأن علم الله أعظم وأشمل. وتبيّن أن القتال في الشهر الحرام أمر عظيم لكنه أقل جرمًا من صدّ الناس عن سبيل الله والكفر به وإخراج المؤمنين من مكة، وتؤكد أن الفتنة أي الشرك والاضطهاد أشد من القتل، وأن الكفار لن يتوقفوا عن قتال المؤمنين حتى يردّوهم عن دينهم. وتحذر من الردة وتوضح أن من يرتد ويموت كافرًا تبطل أعماله ويخلد في النار، ثم تمدح المؤمنين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأنهم يرجون رحمته، وتختم بأن الله غفور رحيم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الإنفاق ومصارفه، تأتي هذه الآيات لتبيّن نوعًا آخر من التضحية وهو القتال، مما يربط بين بذل المال وبذل النفس في سبيل الله، ويُظهر أن التضحية واجب لتحقيق النصر، سواء بالمال أو بالنفس.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الفرض والتقوى القتال فرض مع كراهة النفس لكنه طريق لرحمة الله، 2. الربط بين الظاهر والمآل ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرًا له، 3. الربط بين التضحية والنصر الجهاد سبيل الثبات ونيل رضا الله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. لماذا فُرض القتال رغم كراهية النفس؟، 2. ما الجرم الأكبر من القتال في الشهر الحرام؟، 3. ما عاقبة المرتد عن الدين؟، 4. كيف وصفت الآيات المجاهدين في سبيل الله؟، 5. ما العلاقة بين الإيمان والهجرة والجهاد؟
۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ (219)
عنوان موضوعي: حكم الخمر والميسر وأمر الإنفاق
التفسير: ترد الآية على سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر فتوضح أن فيهما إثمًا كبيرًا ومنافع قليلة دنيوية مثل التسلية والربح، لكن إثمهما أعظم من نفعهما مما يشير إلى تحريمهما لاحقًا. وتجيب عن سؤال آخر بشأن الإنفاق فتأمر بالإنفاق من العفو أي مما زاد عن الحاجة، لتغرس الاعتدال في العطاء دون إسراف. وتختم بأن هذه الأحكام تُبيَّن للناس ليتفكروا في عواقب الأمور فيلتزموا بالحق ويبتعدوا عن الباطل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن القتال والإنفاق في سبيل الله، تأتي هذه الآية لتوضح أحكامًا اجتماعية تمس حياة الناس اليومية، مما يربط بين الالتزام الديني وتجنب المحرمات، ويُظهر أن الإسلام يعالج جميع جوانب الحياة الروحية والاجتماعية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين السؤال والتفكر تبدأ الآية بإجابات وتنتهي بدعوة للتأمل، 2. الربط بين التحذير والبديل تُقابل أضرار الخمر والميسر بتوجيه نحو الإنفاق المعتدل، 3. الربط بين الفرد والمجتمع تُبرز أن التشريع الإسلامي يوازن بين تهذيب النفس والإصلاح الاجتماعي.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المنافع التي أشار إليها القرآن في الخمر والميسر؟، 2. لماذا إثم الخمر والميسر أعظم من نفعهما؟، 3. ما المقصود بالعفو في الإنفاق؟، 4. ما الغاية من دعوة الناس للتفكر في الأحكام؟، 5. كيف تُظهر الآية شمولية التشريع الإسلامي؟
فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ (220) وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ (221)
عنوان موضوعي: الإصلاح في أموال اليتامى وتحريم الزواج من المشركين
التفسير: تشير الآيات إلى سؤال المؤمنين عن كيفية التعامل مع أموال اليتامى فتوضح أن الإصلاح لهم خير، وتجيز مخالطتهم بشرط الإخوة والنية الصالحة، وتؤكد أن الله يعلم المفسد من المصلح وأنه لو شاء لشدد الأحكام لكنه عزيز حكيم. ثم تنهى عن الزواج بالمشركات حتى يؤمنّ وتبيّن أن أَمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت الرجال، وكذلك لا يُنكح المشركون بالمؤمنات حتى يؤمنوا، لأن عبدًا مؤمنًا خير من مشرك ولو أعجب الناس. وتختتم بأن المشركين يدعون إلى النار، أما الله فيدعو إلى الجنة والمغفرة، ليكون في ذلك تذكير للناس.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن أحكام الخمر والميسر والإنفاق، تأتي هذه الآيات لتسلط الضوء على إصلاح العلاقات الاجتماعية من خلال العناية باليتامى ومنع الزواج بالمشركين، مما يربط بين التقوى والإصلاح الاجتماعي ويُظهر أن الشريعة تبني مجتمعًا نقيًّا بالإيمان والأخلاق.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإصلاح والمعاملة بالإخوة توجيه لحسن معاملة اليتامى، 2. الربط بين النكاح والدين يربط الزواج بالعقيدة لا بالإعجاب، 3. الربط بين الدعوة والمصير المشركون يدعون إلى النار والمؤمنون إلى الجنة والمغفرة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما التوجيه بشأن التعامل مع أموال اليتامى؟، 2. ما الفرق بين الإصلاح والإفساد في أموالهم؟، 3. ما حكم الزواج بالمشركات والمشركين؟، 4. لماذا قدّم الإيمان على الإعجاب بالمظهر؟، 5. ما الغاية من هذه الأحكام كما وردت في ختام الآيات؟
وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (223)
عنوان موضوعي: أحكام المحيض وعلاقة الأزواج
التفسير: توضح الآيات أن المحيض أذى فيُمنع الجماع أثناءه، وتأمر بالعودة للعلاقة الزوجية بعد الطهر والاغتسال، مؤكدة أن الله يحب التوابين والمتطهرين. وتصف النساء بأنهن حرث للرجال أي موضع الزرع والنسل، وتبيح للزوج أن يأتي زوجته في موضع الحرث بأي هيئة شاء، وتحث على تقديم الخير في العلاقة الزوجية، مقرونة بالتقوى والوعي بلقاء الله.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن العلاقات الاجتماعية والزواج، تأتي هذه الآيات لتكمل تنظيم العلاقة الأسرية ببيان أحكام المحيض والحرث، مما يربط بين الطهارة الجسدية والروحية، ويُظهر أن الإسلام يضبط أدق تفاصيل الحياة بالعفة والتقوى.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الطهارة والعلاقة الزوجية الحيض أذى فيُعتزل ثم يُستأنف بعد الطهر، 2. الربط بين العلاقة والنية الصالحة يجعل العلاقة وسيلة للتقرب لا شهوة مجردة، 3. الربط بين التقوى والجزاء يُذكّر بأن الله مطّلع على أعمال عباده.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما حكم العلاقة الزوجية أثناء الحيض؟، 2. ما شرط العودة للعلاقة بعد الطهر؟، 3. كيف وصفت الآيات النساء في العلاقة الزوجية؟، 4. ما التوجيه في حسن المعاشرة بين الزوجين؟، 5. كيف تربط الآيات بين التقوى والعلاقة الزوجية؟
وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (224) لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ (225)
عنوان موضوعي: أحكام الأيمان وعفو الله
التفسير: تحذر الآيات من جعل الأيمان بالله مانعًا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فالحلف لا يكون عذرًا لترك الخير، وتؤكد أن الله سميع بصير فيجب مراقبته، وتوضح أن اللغو في الأيمان لا يؤاخذ الله به لأنه يصدر بلا قصد، أما الأيمان المقصودة والعمدية فهي التي يؤاخذ عليها بما عقدت القلوب، وتختم بالتذكير بسعة رحمة الله ومغفرته.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن العلاقة الزوجية وأحكامها، تأتي هذه الآيات لتبين أهمية ضبط الأيمان وعدم استخدامها لتعطيل الخير، مما يُظهر أن الإسلام ينظم أقوال المسلم ونواياه كما ينظم أفعاله.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الأيمان وفعل الخير الحلف لا يكون عذرًا لترك البر، 2. الربط بين الظاهر والباطن الحساب على نية القلب لا على مجرد القول، 3. الربط بين صفات الله والتوبة ختم الآيات بـ«غفور حليم» يربط العفو بضبط النفس.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما النهي الذي وجهته الآيات بشأن الأيمان؟، 2. ما الفرق بين لغو اليمين واليمين المعقودة؟، 3. ما الصفات الإلهية المذكورة وما دلالتها؟، 4. كيف تربط الآيات بين مراقبة الله وفعل الخير؟، 5. ما الرسالة الأخلاقية التي تقدمها هذه الآيات؟
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (226) وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (227)
عنوان موضوعي: أحكام الإيلاء والتعامل مع الزوجات
التفسير: الإيلاء هو أن يحلف الرجل على الامتناع عن معاشرة زوجته، وتوضح الآيات أن للزوجة حق التربص أربعة أشهر، فإن رجع الزوج خلال هذه المدة فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق بعد انقضائها فالله سميع عليم، مما يبرز أن القرارات الزوجية يجب أن تكون بنية الإصلاح والعدل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان أحكام الأيمان، تأتي هذه الآيات لتوضح أثر الحلف في الحياة الزوجية عبر حكم الإيلاء، مما يربط بين اليمين والعمل ويُظهر أن الشريعة تنظم النية والفعل معًا لتحقيق العدل الأسري.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين اليمين والعلاقة الزوجية الإيلاء أثر من آثار القسم في الحياة الأسرية، 2. الربط بين الرجعة والرحمة والطلاق والعلم من رجع رُحم ومن طلق خضع لعلم الله، 3. الربط بين العدالة والمهلة الأربعة أشهر ضمان لحقوق الطرفين.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما معنى الإيلاء في القرآن؟، 2. كم مدة التربص التي حددتها الآيات؟، 3. ما خياري الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء؟، 4. ما الصفات الإلهية المذكورة وما علاقتها بالحكم؟، 5. كيف تحقق الآيات التوازن في العلاقة الزوجية؟
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ (230)
عنوان موضوعي: أحكام الطلاق والرجعة
التفسير: تبين الآيات أحكام الطلاق والرجعة، فتوجب على المطلقة الانتظار ثلاثة قروء قبل الزواج بآخر، وتمنع كتمان الحمل، وتمنح الزوج حق الرجعة أثناء العدة بشرط نية الإصلاح، وتقرر مبدأ التوازن بين الحقوق بأن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، مع درجة قيادة للرجل. وتوضح أن الطلاق مرتان، وبعدهما إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وتحرم أخذ المهر ظلمًا إلا في حال الخلع، وتقرر أن الطلاق الثالث لا رجعة بعده حتى تتزوج المرأة بزوج آخر ثم تفترق منه بحق، فهذه حدود الله التي تحفظ كرامة الأسرة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان الإيلاء، تأتي هذه الآيات لتفصل أحكام الطلاق والرجعة، مما يربط بين النية في اليمين والتنفيذ في الطلاق ويُظهر أن الإسلام يضع حدودًا دقيقة تحفظ حقوق الزوجين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإيلاء والطلاق كلاهما ينظم الخلاف الزوجي تدريجيًا، 2. الربط بين العدة وحق الرجعة العدّة فرصة للإصلاح، 3. الربط بين حفظ الحقوق وحدود الله الطلاق مضبوط بشرع يمنع الظلم.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما مدة العدة للمطلقة؟، 2. متى يجوز للزوج إرجاع زوجته؟، 3. كم مرة يُسمح بالطلاق الرجعي؟، 4. متى يُسمح بالخلع؟، 5. ما شرط رجوع المطلقة بعد الطلاق الثالث؟
وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (231) وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (232)
عنوان موضوعي: أحكام الرجعة ومنع الإضرار بالمطلقات
التفسير: توضّح الآيات أنه عند قرب انتهاء العدّة يجب على الزوج أن يختار إمّا الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف، وتحذر من إمساك المطلقة بنية الإضرار، وتدعو لتذكر نعم الله والكتاب والحكمة، وتحرم منع المرأة من الزواج بزوجها السابق إذا تراضيا بعد العدّة، وتؤكد أن ذلك أزكى وأطهر لمن يؤمن بالله واليوم الآخر.
مناسبة المقطع للمقطع السابق والربط: بعد بيان أحكام الطلاق والعدة، تأتي هذه الآيات لتؤكد حفظ كرامة المطلقة ومنع الإضرار بها، مما يربط بين الإيمان الحق والسلوك العادل في العلاقات الأسرية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الطلاق والمعروف تكرار لفظ «بمعروف» يرسخ العدل، 2. الربط بين الرجعة والنية الصالحة الرجوع للإصلاح لا للضرر، 3. الربط بين الإيمان والسلوك الاجتماعي من يؤمن يلتزم بالعدل والرحمة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الخيارات بعد انتهاء العدة؟، 2. ما التحذير في شأن إمساك المطلقة؟، 3. ما حكم منع المطلقة من الزواج بزوجها السابق؟، 4. كيف يرتبط الإيمان بهذه الأحكام؟، 5. ما معنى قوله تعالى: ) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(؟
۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ (233)
عنوان موضوعي: أحكام الرضاعة وحقوق الأم والطفل
التفسير: تحدد الآيات مدة الرضاعة الكاملة بعامين لمن أراد إتمامها، وتوجب على الأب رزق الأم وكسوتها بالمعروف دون إسراف أو تقصير، وتحذر من الإضرار بالأم أو الأب بسبب الولد، وتوضح أن قرار الفطام قبل السنتين يجب أن يكون بالتراضي والتشاور، كما تجيز الاسترضاع بغير الأم بشرط أداء الأجر بالمعروف، وتختم بالأمر بتقوى الله لأنه بصير بأعمال الناس.
مناسبة المقطع للمقطع السابق والربط: بعد تنظيم الطلاق والعدة، تأتي هذه الآية لتكمل منظومة الأسرة ببيان حقوق الأم والطفل، مما يربط بين الرحمة في التشريع وتحقيق التوازن الأسري.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الرضاعة والحقوق الأسرية توزع المسؤوليات بين الأب والأم، 2. الربط بين التراضي والتشاور في الفطام يظهر روح التعاون، 3. الربط بين التقوى والرقابة الإلهية يختم التوجيه بمحاسبة الله على النيات.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المدة المحددة للرضاعة؟، 2. ما حقوق الأم المرضعة على الأب؟، 3. متى يجوز الفطام قبل السنتين؟، 4. ما شروط الاسترضاع من مرضعة أخرى؟، 5. ما دلالة ختم الآية بتقوى الله؟
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ (235) لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
عنوان موضوعي: عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الطلاق قبل الدخول
التفسير: تحدد الآيات أن عدة المرأة التي تُوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وبعد انقضائها يجوز لها الزواج بالمعروف، وتجيز التعريض بخطبتها دون تصريح أو وعد خفي حتى تنقضي عدتها. كما تبين أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يحدد لها مهرًا فعليه متاع بحسب قدرته، ومن طلقها قبل الدخول بعد فرض المهر فله أن يدفع نصفه إلا إذا عفت أو عفا الزوج، وتختم بالحض على العفو والفضل بين الناس لأن الله بصير بأعمالهم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق والربط: بعد الحديث عن الرضاعة والحقوق الأسرية، تأتي هذه الآيات لتكمل بيان أحكام المرأة في حالتي الوفاة والطلاق قبل الدخول، مما يربط بين رحمة التشريع وشموليته في حماية المرأة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الأسرة وحقوق أفرادها يوضح التكامل التشريعي للأسرة، 2. الربط بين المعروف كقيمة مكررة يؤكد التعامل الحسن، 3. الربط بين التقوى والرقابة الإلهية يذكّر بأن الله بصير بأعمال العباد.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كم عدة المتوفى عنها زوجها؟، 2. ما حكم التعريض بخطبة المعتدة؟، 3. ما حكم طلاق غير المدخول بها بلا مهر؟، 4. ما حكم طلاقها بعد فرض المهر؟، 5. كيف تُظهر الآيات أهمية العفو والفضل في العلاقات الزوجية؟
حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ (238) فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ (239)
عنوان موضوعي: الحفاظ على الصلاة وأدائها في الظروف المختلفة
التفسير: تأمر الآيات المؤمنين بالمحافظة على جميع الصلوات بأوقاتها، مع تخصيص الصلاة الوسطى (الراجح أنها صلاة العصر) نظرًا لأهميتها ومكانتها في اليوم. وتحثّ على أداء الصلاة بخشوعٍ وخضوعٍ لله، وقنوتٍ تامٍّ بمعنى الطاعة والإخلاص في الوقوف بين يدي الله. ثم تبين رخصة الصلاة في حالة الخوف أو الظروف الطارئة كالحرب أو السفر، فيجوز أداؤها مشيًا أو على ظهور الركاب (رجالًا أو ركبانًا)، لأن الصلاة لا تسقط بحال. وبعد زوال الخوف وعودة الأمن يُؤمر المؤمنون بالعودة إلى أدائها تامة بأركانها وذكر الله على ما علّمهم من أحكامها، تذكيرًا بأن فضل الله وتعليمه هو السبب في تمام عبادتهم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن تنظيم شؤون الأسرة والحقوق الزوجية، تأتي هذه الآيات لتؤكد أهمية صلة العبد بربه عبر الصلاة، فتربط بين صلاح العلاقات الاجتماعية وصلاح الصلة بالله، وتُظهر أن الصلاة لا تُترك حتى في الشدة لأنها عماد الدين.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الصلاة وتنظيم الحياة بعد ذكر الأسرة جاءت الصلاة لتؤكد أن العبادة هي الأساس في كل علاقة، 2. الربط بين الثبات والمرونة أداء الصلاة في الأمن والخوف يبرز شمول التكليف، 3. الربط بين التعليم والذكر ختم الآية بالتذكير بنعمة التعليم الإلهي يحفز على الشكر والمواظبة على الصلاة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهته الآيات بشأن الصلوات؟، 2. ما المقصود بالصلاة الوسطى وفقًا للراجح؟، 3. كيف تؤدى الصلاة في حالة الخوف أو الطوارئ؟، 4. ماذا يُطلب من المؤمنين بعد زوال الخوف؟، 5. كيف تُبرز الآيات أهمية الصلاة في حياة المسلم؟
وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ (240) وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ (241) كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ (242)
عنوان موضوعي: حقوق الزوجات بعد وفاة الزوج والمطلقات
التفسير: توصي الآيات الأزواج أن يتركوا وصية لزوجاتهم بأن يمكثن في بيوت الزوجية عامًا كاملًا بعد وفاتهم، يتمتعن فيه بالنفقة والسكن دون أن يُخرجن قسرًا. فإن خرجن باختيارهن بعد الوفاة فلا حرج على أوليائهن فيما فعلن من المعروف كالزواج أو التصرف بشؤونهن. ثم تقرر الآيات أن للمطلقات حقًّا في متاعٍ بالمعروف، وهو نفقة وهديّة تليق بحال الزوج، واجب على كل متقٍ لله، تأكيدًا لمبدأ الإحسان حتى بعد الانفصال. وتُختتم الآيات ببيان أن هذه الأحكام تجلّي حكمة الله وعدله، ودعوة للمؤمنين إلى التعقل والتدبر في مقاصد الشريعة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق والربط: بعد الأمر بالمحافظة على الصلاة التي تمثل صلة العبد بربه، تعود هذه الآيات لتنظيم الحقوق الاجتماعية للنساء بعد الطلاق أو الوفاة، مما يربط بين العبادة والمعاملة ويظهر تكامل التشريع بين حق الله وحق العباد.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين المعروف في الحياة وبعدها كما أُمر الأزواج بالمعروف أحياءً أُمروا به بعد الوفاة، 2. الربط بين التقوى والإحسان حق المطلقة متاع بالمعروف “حقًّا على المتقين”، 3. الربط بين البيان والعقل ختم المقطع بـ”لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ” يحث على التدبر والفهم.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما وصية الله للأزواج تجاه زوجاتهم بعد الوفاة؟، 2. ما حكم خروج الزوجة أثناء عدتها؟، 3. ما الحق الذي أوجبته الآيات للمطلقات؟، 4. كيف ترتبط هذه الأحكام بالتقوى؟، 5. ما الغاية من ختام الآيات بـ”لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ”؟
۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيَٰهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ (243) وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ (244) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (245)
عنوان موضوعي: الحياة والموت وأهمية الجهاد والإنفاق
التفسير: تروي الآيات قصة قوم خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ فرارًا من الموت خوفًا من الطاعون أو الحرب، فأماتهم الله ثم أحياهم ليُعلّمهم أن الحياة والموت بيده وحده، وأن الفرار لا يُنجي من قدره. وتذكّر الآيات بفضل الله العظيم على الناس رغم جحود أكثرهم، ثم تأمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله دفاعًا عن الحق والدين، مع اليقين بأن الله سميع لأقوالهم، عليمٌ بنيّاتهم. وتحث الآيات كذلك على الإنفاق في سبيل الله وتصفه بالقرض الحسن، أي الإنفاق بإخلاصٍ دون منٍّ ولا أذى، وتعد بمضاعفة الأجر أضعافًا كثيرة، تأكيدًا على كرم الله وسعة عطائه. وتُختم الآيات ببيان أن الله وحده يبسط الرزق أو يقدّره، وأن إليه المرجع والمآل للحساب والجزاء.
مناسبة المقطع للمقطع السابق والربط: بعد عرض الأحكام المتعلقة بالأسرة والعبادات والمعاملات، تأتي هذه الآيات لتوسع دائرة الخطاب نحو قضايا الأمة الكبرى كالحياة والموت والجهاد والإنفاق، مما يربط بين عبادة الفرد وبناء المجتمع وثقته بالله في جميع الأحوال.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الخوف من الموت والإيمان بالقدر القصة تعلّم أن لا مفر من قضاء الله، 2. الربط بين الجهاد والإنفاق كلاهما وسيلة لنصرة الدين، 3. الربط بين الجزاء والعمل ختم الآيات بـ”وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ” يغرس المسؤولية أمام الله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما القصة التي تذكرها الآيات عن الذين خرجوا من ديارهم؟، 2. ما الدرس من إماتتهم ثم إحيائهم؟، 3. ما الأمر الإلهي الذي وُجّه للمؤمنين بعد القصة؟، 4. ما المقصود بالقرض الحسن؟، 5. كيف تُبرز الآيات حكمة الله في الرزق والجزاء؟
أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا نُّقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُواْۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ (246)
عنوان موضوعي: طلب بني إسرائيل ملكًا للقتال وموقفهم من التكليف
التفسير: تخاطب الآية جماعة من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام، إذ طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكًا يقودهم للقتال في سبيل الله، فحذّرهم من احتمال تراجعهم بعد فرض القتال، فتعهدوا بالثبات لما أصابهم من إخراج من ديارهم وأبنائهم، لكن لما كُتب عليهم القتال تولى أكثرهم ورفضوا المشاركة إلا قلة قليلة، وتوضح الآية أن الله عليم بالظالمين الذين ينقضون عهودهم ولا يوفون بوعودهم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الجهاد والإنفاق في سبيل الله، تأتي هذه الآية لتُبرز مثالًا عمليًا من تاريخ بني إسرائيل يُظهر تقلب النفوس وضعفها أمام التكاليف، مما يعزز الدعوة للثبات في سبيل الله، ويُبرز أهمية الالتزام بالطاعة عند مواجهة الأوامر الإلهية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين المثال التاريخي والتكليف الإلهي: تأتي هذه القصة بعد آيات الجهاد والإنفاق لتُقدّم نموذجًا واقعيًا يُحذّر من ضعف الاستجابة لأوامر الله، 2. الربط بين القول والفعل في طاعة الله: تعهدهم بالقتال ثم تراجعهم يُظهر التناقض بين الادعاء والعمل، 3. الربط بين العلم الإلهي ومواقف البشر: ختم الآية بأن “اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ” يرسّخ مراقبة الله للنيات والأفعال.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الطلب الذي قدّمه بنو إسرائيل لنبيهم؟، 2. كيف رد النبي على طلبهم ببعث ملك للقتال؟، 3. ما موقفهم بعد فرض القتال؟، 4. كيف تُظهر الآية علم الله بالظالمين؟، 5. ما الدرس المستفاد من موقفهم تجاه التكليف الإلهي؟
وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ قَالُوٓاْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ أَحَقُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةٗ مِّنَ ٱلۡمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ وَٱللَّهُ يُؤۡتِي مُلۡكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ (247) وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ءَايَةَ مُلۡكِهِۦٓ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَبَقِيَّةٞ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (248)
عنوان موضوعي: اختيار طالوت ملكًا ودلالة ملكه
التفسير: يخبر النبي قومه أن الله اختار طالوت ملكًا عليهم، فاعترضوا بحجة أنه ليس من أصحاب المال وأنهم أحق بالملك، فرد بأن الله اختاره لعلمه وقوته، وأن الملك هبة من الله يؤتيه من يشاء. وبيّن أن علامة اختياره أن يأتيهم التابوت حاملاً السكينة من الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فيكون ذلك دليلًا قاطعًا على صدق النبوة وصحة الاختيار.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن طلب بني إسرائيل ملكًا يقودهم للقتال، تأتي هذه الآيات لتبيّن اختيار الله لطالوت ملكًا عليهم، مما يُظهر حكمة الله في الاصطفاء ويُبرز ضعف حججهم في الاعتراض، ويؤكد أن الطاعة والتسليم لأمر الله هما أساس النجاح.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين اعتراض البشر واصطفاء الله: اعتراض بني إسرائيل على اختيار طالوت يُقابله تأكيد النبي أن الاختيار لله وحده، 2. الربط بين الصفات المؤهلة والقيادة: ذكر العلم والجسم كسببين للاصطفاء يوضح معايير الكفاءة الإلهية، 3. الربط بين الدليل الحسي والإيمان القلبي: ظهور التابوت كآية يربط بين الغيب والشهادة في تثبيت الإيمان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما سبب اعتراض بني إسرائيل على اختيار طالوت؟، 2. كيف رد النبي على اعتراضهم؟، 3. ما العلامة التي أيد الله بها ملك طالوت؟، 4. ما معنى السكينة وما علاقتها بالتابوت؟، 5. كيف تُظهر الآيات حكمة الله في اصطفاء القادة؟
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلۡجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ بِيَدِهِۦۚ فَشَرِبُواْ مِنۡهُ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلۡيَوۡمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ (251) تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتۡلُوهَا عَلَيۡكَ بِٱلۡحَقِّۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ (252)
عنوان موضوعي: اختبار طالوت وهزيمة جالوت بقيادة داوود
التفسير: تعرض الآيات مشهد اختبار جنود طالوت حين ابتلاهم الله بنهر ليميز المطيعين من العاصين، فمن شرب منه بإفراط خرج من الصف، ومن اكتفى بغرفة بيده كان من المخلصين، فكان النهر ميدان التصفية قبل ميدان القتال. ولم يثبت بعده إلا القلة المؤمنة التي واجهت جالوت وجنوده بثقة في الله، فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فاعتمدوا على التوكل والدعاء قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فكان النصر لهم وقُتل جالوت على يد داوود عليه السلام. ثم يذكر القرآن فضل الله على داوود إذ آتاه الملك والحكمة وعلّمه ما يشاء، دلالة على أن التمكين بيد الله يرفعه لمن صدق معه. وتوضح الآيات أن سنة التدافع بين الناس رحمة تحفظ الأرض من الفساد وتقيم العدل، وتختم بتأكيد أن ما يُتلى على النبي ﷺ من هذه القصة هو الحق من عند الله، تثبيتًا لرسالته وبرهانًا على صدقه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن اختيار طالوت ملكًا وآية التابوت، تكمل هذه الآيات القصة بذكر اختبار النهر ومواجهة جالوت، مما يُبرز حكمة الله في امتحان الإيمان قبل التمكين، ويؤكد أن الثبات والصبر طريق النصر بإذن الله.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الابتلاء والنصر: تبدأ القصة باختبار النهر وتنتهي بالتمكين، مما يُظهر أن الصبر في البلاء طريق النصر، 2. الربط بين القلة المؤمنة والنصر الإلهي: تأكيد أن الإيمان هو سبب الغلبة لا العدد، 3. الربط بين الدعاء والعمل والتمكين: دعاؤهم قبل المعركة ونصرهم بعد الثبات يُرسخ أن النصر ثمرة الإخلاص والاعتماد على الله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الاختبار الذي واجه جنود طالوت؟، 2. كيف تميّز المؤمنون في الاختبار؟، 3. ما الدعاء الذي دعا به المؤمنون قبل القتال؟، 4. كيف انتهت المعركة بين طالوت وجالوت؟، 5. ما الحكمة من سنة التدافع بين الناس؟
۞تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (254)
عنوان موضوعي: تفضيل الرسل وأمر الإنفاق قبل يوم القيامة
التفسير: تبيّن الآيات أن الله فضّل بعض الرسل على بعض؛ فموسى كلّمه الله، ومحمد ﷺ رفعه درجات، وعيسى أُعطي البينات وأُيّد بروح القدس. ومع ذلك اختلفت الأمم من بعدهم فآمن بعضهم وكفر آخرون، وكان اقتتالهم بإرادة الله لتحقيق حكمته في الابتلاء. ثم تدعو الآيات المؤمنين إلى الإنفاق مما رزقهم الله قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا بيع فيه ولا صداقة ولا شفاعة إلا بإذنه، لتؤكد أن الكافرين هم الظالمون لأنهم غفلوا عن الاستعداد لذلك اليوم العظيم.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد ذكر قصة طالوت وجالوت وما فيها من الإيمان والجهاد والتمكين، تأتي هذه الآيات لتبيّن أن سنة الله ماضية في تفضيل الرسل واختبار الناس، وتحث على الإنفاق استعدادًا ليوم لا شفاعة فيه إلا بإذن الله، مما يربط بين العمل في الدنيا والجزاء في الآخرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين تفضيل الرسل واختلاف الأمم: كما اختلفت الأمم من بعدهم فآمن بعضهم وكفر بعض، يذكّر ذلك بسنّة الابتلاء، 2. الربط بين الإنفاق والاستعداد للآخرة: الدعوة للإنفاق قبل يوم لا بيع فيه تؤكد أن العمل الصالح هو الزاد الحقيقي، 3. الربط بين حكمة الله في الابتلاء وعدله في الجزاء: من اختلف فبحكمة الله، ومن أنفق فبفضله، مما يرسّخ التكامل بين القضاء الإلهي ومسؤولية الإنسان.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف فضّل الله بعض الرسل على بعض؟، 2. ما المعجزات التي خُص بها عيسى ابن مريم؟، 3. ما سبب اقتتال الناس بعد الرسل؟، 4. ما التحذير الذي وجهته الآية بشأن يوم القيامة؟، 5. كيف يرتبط الإنفاق بالاستعداد للآخرة؟
ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ (255)
عنوان موضوعي: آية الكرسي: صفات الله العظمى
التفسير: تبدأ الآية العظيمة بإثبات توحيد الله، بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، المستحق وحده للعبادة والطاعة. وتصفه بأنه الحي القيوم، أي الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا يزول، والقيّوم الذي يقوم بنفسه ويدبّر أمر خلقه كلهم، لا يحتاج إلى أحد، بينما الخلق كلهم يحتاجون إليه. وتؤكد كمال صفاته بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يغشاه النعاس ولا ينام، دلالة على كمال قدرته واستمرارية حفظه للسماوات والأرض دون غفلة أو تعب.
تُبيّن الآية أن ملك الله شامل، فكل ما في السماوات والأرض ملكه وحده، لا يخرج شيء عن سلطانه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، دلالة على عظمته وهيبته. كما تؤكد إحاطة علمه الكامل بالماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وتشير إلى عظمة ملكه بذكر أن كرسيه يسع السماوات والأرض، وأن حفظهما لا يُثقله، مما يبرز كمال قوته وسلطانه. وتُختتم الآية بوصفه بـ العلي العظيم، المتعالي في ذاته وصفاته، العظيم في ملكه وقدرته، الذي لا يُشبهه شيء.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الإنفاق في سبيل الله وأعمال الإيمان، تأتي هذه الآية العظيمة لتُظهر صفات الله العليا وقدرته المطلقة، مما يعمّق الثقة به ويغرس في القلوب تعظيمه والتوكل عليه.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التوحيد وصفات الله: تبدأ الآية بإثبات وحدانية الله وتتابع بصفاته من الحياة إلى العلم إلى الملك، مما يسهل الحفظ بالترتيب المنطقي، 2. الربط بين العلم والسلطان: تبيّن أن علم الله المطلق مقترن بقدرته التامة، فيمنح أو يمنع بإذنه وحده، 3. الربط بين الكرسي والحفظ: ذكر سعة الكرسي ثم حفظ السماوات والأرض دون كُلفة يعمّق معنى القوة المطلقة لله.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما أبرز صفات الله التي وردت في الآية؟، 2. ماذا تعني صفتي “الحي” و”القيوم”؟، 3. كيف تُظهر الآية كمال علم الله وسلطانه؟، 4. ما المقصود بسعة الكرسي؟، 5. ما دلالة ختم الآية بوصف “العلي العظيم”؟
لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
عنوان موضوعي: حرية الإيمان وثبات الإيمان الحق
التفسير: تؤكد الآية قاعدة عظيمة في الإسلام وهي أن الإيمان لا يُفرض بالإكراه، لأن طريق الهدى والضلال قد تبيّن، فلا يحتاج الحق إلى إجبار، بل يُدرك بالعقل والبصيرة. وتوضّح أن من كفر بالطاغوت (كل ما يُعبد من دون الله) وآمن بالله وحده، فقد تمسك بالعروة الوثقى، أي بالعقيدة الراسخة التي لا تنفصم ولا تنكسر، وهي التوحيد الخالص. وتُختتم الآية بذكر صفتي الله السميع العليم، الدالتين على أن الله يسمع أقوال عباده ويعلم ما في قلوبهم، فيجازي كل إنسان على اختياره بحرية وعدل.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد عرض صفات الله العظمى في آية الكرسي، تأتي هذه الآية لتبيّن أن الإيمان بهذا الإله العظيم يجب أن يكون اختيارًا واعيًا عن قناعة لا قهر، مما يُظهر عدل الله وحكمته في منح الحرية للناس.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين البيان والاختيار: بعد أن تبيّن الحق في آية الكرسي، جاء التأكيد على حرية الإيمان دون إكراه، 2. الربط بين رفض الطاغوت والتمسك بالعروة الوثقى: الجمع بين الترك والتمسك يوضح منهج التوحيد الكامل، 3. الربط بين صفات الله والجزاء العادل: ختم الآية بصفتي السميع العليم يُظهر مراقبة الله لاختيارات العباد.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما معنى “لا إكراه في الدين”؟، 2. من هو الطاغوت في الآية؟، 3. ما المقصود بالعروة الوثقى؟، 4. ما الصفات الإلهية التي خُتمت بها الآية؟، 5. كيف تُبرز الآية الحرية في الإيمان والثبات عليه؟
ٱللَّهُ وَلِیُّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ یُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِینَ كَفَرُوٓا۟ أَوۡلِیَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ یُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ (257)
عنوان موضوعي: ولاية الله للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين
التفسير: تبين الآية أن الله هو الولي الحق للمؤمنين، أي الناصر لهم والمُخرج لهم من ظلمات الجهل والكفر والذنوب إلى نور الإيمان والهداية. أما الذين كفروا، فأولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من نور الفطرة والعقل والحق إلى ظلمات الكفر والضلال، فيغرقون في الباطل حتى يصيروا من أصحاب النار، خالدين فيها جزاءً لاختيارهم الباطل ورفضهم الهداية.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان حرية الإيمان واختيار الحق، تأتي هذه الآية لتُظهر نتيجة هذا الاختيار؛ فالمؤمنون جعلوا الله وليهم فأنقذهم من الظلمات، والكافرون اتخذوا الطاغوت وليًا فأوردهم الهلاك.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الولايتين: “الله ولي الذين آمنوا” في مقابل “الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت” يعزز التوازن اللفظي والمعنوي، 2. الربط بين الظلمات والنور: تكرار الثنائية يُرسّخ الفهم ويُسهّل التذكر، 3. الربط بين الولاية والمصير: ولاية الله تقود إلى النور والنجاة، وولاية الطاغوت إلى الظلمات والنار.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما معنى ولاية الله للمؤمنين؟، 2. كيف يُخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور؟، 3. ما أثر ولاية الطاغوت على الكافرين؟، 4. ما المصير الذي ذكرته الآية للكافرين؟، 5. كيف تُبرز الآية أثر اختيار الولي في مصير الإنسان؟
أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِی حَآجَّ إِبۡرَٰهِیمَ فِی رَبِّهِۦۤ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَۖ إِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِیمُ رَبِّیَ ٱلَّذِی یُحۡیِـۧ وَیُمِیتُۖ قَالَ أَنَا۠ أُحۡیِـۧ وَأُمِیتُۖ قَالَ إِبۡرَٰهِیمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ یَأۡتِی بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِی كَفَرَۗ وَٱللَّهُ لَا یَہۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ (258)
عنوان موضوعي: مجادلة إبراهيم مع الطاغية حول الربوبية
التفسير: تسرد الآية قصة الطاغية الذي جادل نبي الله إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وقدرته، إذ زعم أن له القدرة على الإحياء والإماتة، بمعنى أنه يملك مصير الناس بحكم سلطانه. فواجهه إبراهيم بحجة قاطعة حين قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتِ بها أنت من المغرب إن كنت تملك مثل سلطانه. فبهت الطاغية وعجز عن الرد، وانكشفت جهالته وضعف حجته أمام برهان التوحيد، وخُتمت الآية بأن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين يجادلون بالباطل عنادًا.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان ولاية الله للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين، تعرض الآية مثالًا واقعيًا من التاريخ يُظهر ضعف الطغاة أمام حجة الإيمان، في تأكيد أن القوة الحقيقية هي بيد الله لا بيد من ادّعى الربوبية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الجدال والإيمان: القصة تجسد عمليًا الفرق بين حجة الإيمان وعجز الطغيان، مما يربط بين الفكرة السابقة والتطبيق التاريخي، 2. الربط بين البرهان العقلي والمعجزة الكونية: الانتقال من الإحياء والإماتة إلى الشمس والمشرق والمغرب يجعل الحجة أكثر وضوحًا في الذهن، 3. الربط بين النتيجة والعبرة: “فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ” تختصر القصة في لحظة حسم، مما يسهل تذكرها ويعمق المعنى العقائدي.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الحجة التي قدمها الطاغية لإبراهيم؟، 2. بماذا رد إبراهيم عليه السلام؟، 3. ما التحدي الذي قدمه إبراهيم، وما نتيجته؟، 4. ما الدلالة من قوله تعالى “فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ”؟، 5. كيف تُظهر الآية عاقبة الظلم والعناد أمام الحق؟
أَوۡ كَٱلَّذِی مَرَّ عَلَىٰ قَرۡیَةࣲ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَاۖ قَالَ أَنَّىٰ یُحۡیِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامࣲ ثُمَّ بَعَثَهُۥۖ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ یَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ یَوۡمࣲۖ قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامࣲ فَٱنظُرۡ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ یَتَسَنَّهۡۖ وَٱنظُرۡ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَایَةࣰ لِّلنَّاسِۖ وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَیۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمࣰاۚ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرࣱ (259)
عنوان موضوعي: إحياء القرية الخاوية: دليل قدرة الله
التفسير: تروي الآية قصة رجلٍ مرَّ على قرية خربةٍ مهدّمة، فتساءل كيف يُعيد الله إليها الحياة بعد موتها. فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وسأله كم لبث، فظن أنه يوم أو بعض يوم، فأُعلم أنه مائة عام. طُلِب منه أن ينظر إلى طعامه وشرابه فلم يتغيّرا رغم مرور السنين، وأن ينظر إلى حماره الذي بَلِي جسده، وكيف أعاده الله حيًا أمام عينيه ليكون آية للناس. فشهد بعينه مراحل الإحياء حتى قال: “أعلم أن الله على كل شيء قدير”، إقرارًا بقدرة الله المطلقة على إحياء الموتى.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد قصة إبراهيم والطاغية التي أبرزت ضعف البشر أمام قدرة الله، تأتي هذه القصة لتقدم برهانًا عمليًا على إحياء الموتى، مما يزيد المؤمنين يقينًا بعظمة الله وقدرته.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التساؤل والمعاينة: يبدأ الموقف بسؤال وينتهي برؤية اليقين، مما يسهل تتبع تسلسل الأحداث، 2. الربط بين المظاهر الثلاثة (الطعام، الحمار، العظام): يربط مراحل الإحياء بخطوات محسوسة متتابعة تعين على الحفظ، 3. الربط بين التجربة والإيمان: ختم القصة بقول الرجل “أعلم أن الله على كل شيء قدير” يلخص الهدف الإيماني من القصة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما السؤال الذي طرحه الرجل عندما رأى القرية؟، 2. كم لبث ميتًا قبل أن يبعثه الله؟، 3. ما المعجزة التي ظهرت في الطعام والشراب؟، 4. كيف أحيا الله الحمار أمام عينيه؟، 5. ما الدرس المستفاد من نهاية القصة؟
وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِیمُ رَبِّ أَرِنِی كَیۡفَ تُحۡیِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۡۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِیۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةࣰ مِّنَ ٱلطَّیۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَیۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلࣲ مِّنۡهُنَّ جُزۡءࣰا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ یَأۡتِینَكَ سَعۡیࣰاۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ (260)
عنوان موضوعي: إبراهيم عليه السلام ومعجزة إحياء الطير
التفسير: طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى، لا عن شك، بل ليزداد طمأنينة قلبه ويقينه بقدرة الله. فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور، فيذبحها ويخلط أجزاؤها، ثم يوزع كل جزء على جبل، ثم يدعوها، فإذا بها تعود إليه حية تسعى بأمر الله، فكانت معجزة حية شاهدة على قدرة الله في الخلق والإحياء. وتُختتم الآية بالتنبيه إلى أن الله عزيز في قدرته، حكيم في أفعاله، لا يفعل شيئًا عبثًا.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد عرض قصة إحياء القرية لتأكيد قدرة الله، تأتي قصة إبراهيم لتؤكد أن أعظم الأنبياء أنفسهم يسعون لزيادة الطمأنينة في الإيمان، مما يربط بين التجربة الحسية واليقين القلبي.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإيمان والطمأنينة: الموقف يوضّح أن الطمأنينة مرتبة أعلى من مجرد الإيمان، مما يعمق الفهم، 2. الربط بين الخطوات الحسية للمعجزة وتسلسلها: ترتيب الأحداث من الطيور إلى الإحياء يجعل المشهد حيًا في الذاكرة، 3. الربط بين صفتي “العزيز الحكيم” ونهاية القصة: يجمع الختام بين القدرة والحكمة لتثبيت المعنى الكامل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. لماذا سأل إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى؟، 2. ما الخطوات التي أمر الله بها إبراهيم؟، 3. ما الذي حدث للطيور بعد توزيع أجزائها؟، 4. ما الدرس الإيماني من هذه المعجزة؟، 5. ما دلالة ختم الآية بصفتي “العزيز الحكيم”؟
مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ (261) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (262) ۞ قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ (263) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ (264)
عنوان موضوعي: الإنفاق في سبيل الله وأهمية النية
التفسير: تشبّه الآية أجر المنفقين في سبيل الله بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، دلالة على مضاعفة الأجر لمن أنفق بإخلاص. وتوضح أن من أنفق دون منٍّ أو أذى له أجره عند الله ولا خوف عليه ولا حزن، بينما القول الطيب والمغفرة أفضل من صدقة يتبعها أذى، لأن الله غني عن خلقه وحليم على عباده. وتحذر من إبطال الصدقات بالرياء والمنّ، إذ يُشبه عمل المرائي بصخرة صُقل سطحها، عليها تراب زائل، فإذا نزل عليها المطر أزال التراب ولم يبق أثر، إشارة إلى ضياع الأجر بسبب الرياء.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد عرض قصص الإيمان بالبعث وقدرة الله، تنتقل الآيات لتطبيق هذا الإيمان عمليًا في الإنفاق بإخلاص، فترسخ أن صدق النية أساس قبول العمل.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين النية والجزاء: الحبة التي تنبت سبع سنابل تمثل الإخلاص الذي يضاعف الأجر، 2. الربط بين القول والعمل: “قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى” يوازن بين الفعل الظاهر والنية الباطنة، 3. الربط بين الصورة الحسية والمغزى الروحي: تشبيه الرياء بالصفوان الممحو يخلق صورة بصرية تسهّل التذكر.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما مثل أجر المنفقين في سبيل الله؟، 2. ما الذي يُبطل أجر الصدقة؟، 3. ما الذي هو خير من صدقة يتبعها أذى؟، 4. ما التشبيه الذي قدّمته الآية للرياء؟، 5. كيف تربط الآيات بين النية والإخلاص في العمل؟
وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٞ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٞ فِيهِ نَارٞ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ (266)
عنوان موضوعي: الإنفاق المخلص وأثر الرياء على العمل الصالح
التفسير: يُشبه الله تعالى المنفقين المخلصين الذين يبتغون مرضاته بجنةٍ على ربوةٍ (أي أرض مرتفعةٍ خصبةٍ)، إذا نزل عليها المطر الغزير أثمرت أضعافًا مضاعفة، وإن لم يصبها إلا مطر خفيف (طلّ) بقيت مثمرة، مما يدل على دوام بركة العمل الصالح متى كانت النية خالصة. ثم يضرب الله مثلًا آخر لمن يعمل عملًا صالحًا بلا إخلاص، أو يتبعه بالمنّ والأذى، كرجلٍ كبيرٍ له بستان مثمر يطعم منه أبناءه الضعفاء، فإذا أصاب البستان إعصار فيه نار، احترق كله، وضاع جهد السنين، وهكذا يضيع العمل بالرياء. وتختم الآيات بدعوة المؤمنين إلى التفكر في هذه الأمثال ليعوا أثر النية والإخلاص في صلاح العمل أو بطلانه.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد التحذير من الرياء والمنّ في الصدقة، تأتي هذه الآيات لتوضّح ببلاغة أثر الإخلاص في مضاعفة الأجر، وأثر الرياء في إحراق العمل الصالح، مما يربط النية بنتيجة العمل في الدنيا والآخرة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإخلاص والبركة: تصوير الإنفاق المخلص بجنةٍ على ربوةٍ يربط بين صفاء النية ودوام الثمرة، 2. الربط بين فساد النية وضياع العمل: مشهد احتراق البستان يجعل صورة العمل الريائي مؤثرة وواضحة في الذهن، 3. الربط بين الأمثال والتفكر: ختام الآيات بدعوة إلى التفكر “لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ” يرسّخ أن الغاية من المثل هي وعي القلب لا مجرد السرد القصصي.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما المثل الذي ضربته الآية للمنفق المخلص؟، 2. كيف تختلف ثمار الجنة بحسب المطر في المثل؟، 3. ما المثل المقابل للعمل غير المخلص؟، 4. ما دلالة احتراق البستان في سياق العمل الريائي؟، 5. كيف تحث الآيات على التفكر في النيات والأعمال؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ (268) يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ (269) وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ (270) إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ (271)
عنوان موضوعي: أدب الإنفاق بين الطيب والخبيث، ووعد الشيطان ووعد الله، وأثر الحكمة والنية في الصدقة
التفسير: تبدأ الآيات بنداء للمؤمنين يأمرهم الله فيه أن يُنفقوا من أطيب ما كسبوا من أموالهم، ومن خيرات ما أنبتت لهم الأرض، محذرًا من تقديم الرديء في الصدقة، ذلك الذي لا يقبله الإنسان لنفسه إلا مكرهًا، لأن الله غنيٌّ عن الخبيث، محمودٌ في ذاته وصفاته. وتكشف الآيات الصراع النفسي في قلب المؤمن بين وسوسة الشيطان ووعد الرحمن؛ فالشيطان يخيف الإنسان من الفقر ليمنعه من العطاء، ويأمره بالبخل والفحشاء، بينما الله يعده بالمغفرة والفضل الواسع، فهو واسع العطاء، عليم بمن يستحقه. ثم تبيّن أن الحكمة عطية ربانية عظيمة، من أُعطيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا، إذ يهديه الله إلى حسن النية وإتقان العمل. وتطمئن الآيات المؤمنين بأن كل نفقة أو نذر يعلمه الله ولا يضيع أجره، وتختم ببيان أن إظهار الصدقة حسن، لكن إخفاءها خالصًا لله خير وأعظم أجرًا، لأنه أدعى للإخلاص وتكفير الذنوب، والله خبيرٌ بما تعمل القلوب والجوارح.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد أن بيّنت الآيات السابقة أثر الإخلاص والرياء في قبول الصدقة، تأتي هذه الآيات لتقدّم توجيهات عملية في اختيار المال الطيب، ومجاهدة وساوس الشيطان، والسعي إلى الحكمة والإخلاص في الإنفاق سرًّا وعلانية، لتكتمل منظومة التربية الإيمانية في باب الصدقة.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الطيب والخبيث: المقارنة بين ما يرضاه الإنسان لنفسه وما يقدمه لله ترسخ قاعدة الإحسان في العطاء، 2. الربط بين وعد الشيطان ووعد الله: عرض الخوف من الفقر مقابل وعد المغفرة والفضل يجعل المعنى واضحًا بالتضاد، 3. الربط بين الحكمة والنية: بيان أن الحكمة ثمرة الإخلاص، وأنها تميز العطاء الصادق من الريائي، 4. الربط بين السر والعلانية: التدرج من الإظهار إلى الإخفاء يربط مراتب الإخلاص بالجزاء الأعظم.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الذي أمرت به الآيات في شأن الصدقة؟، 2. لماذا نُهي المؤمن عن إنفاق المال الخبيث؟، 3. ما الفرق بين وعد الشيطان ووعد الله؟، 4. ما فضل الحكمة ومن يمنحها الله؟، 5. ما الذي يترتب على إخفاء الصدقة؟
۞لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ (272) لِلۡفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحۡصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱلۡجَاهِلُ أَغۡنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ (273) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (274)
عنوان موضوعي: أهمية الإخلاص في الإنفاق ومواصفات المستحقين
التفسير: توضح الآيات أن مسؤولية هداية الناس ليست على النبي ﷺ، بل هي بيد الله وحده، وأن ما يُنفقه المؤمن من خيرٍ يعود نفعه إليه إذا قصد به وجه الله. ثم تحدد صفات الفقراء الحقيقيين المستحقين للصدقة: هم الذين انقطعوا للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون السعي في الأرض، ويبدو عليهم الغنى من شدة تعففهم، فلا يسألون الناس إلحافًا، ويُعرفون بعلامات الحياء والزهد. وتختم الآيات بمدح الذين ينفقون أموالهم في جميع الأوقات، ليلًا ونهارًا، سرًا وعلانية، مؤكدة أن لهم أجرًا عظيمًا عند ربهم، وأنهم في أمنٍ من الخوف والحزن يوم القيامة.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد توجيهات الإنفاق وآدابه، تنتقل هذه الآيات لتبيّن أن القبول بيد الله، وأن على المؤمن أن يُخلص النية ويُحسن الاختيار في المستحقين، لتتكامل جوانب الإنفاق في المنهج الإيماني.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الهداية والإخلاص: القبول الإلهي مرتبط بالنية لا بهداية المتلقي، 2. الربط بين صفات الفقراء ومظهرهم: وصفهم بالتعفف رغم حاجتهم يُجسد معاني الكرامة ويُسهّل حفظ الصورة الذهنية، 3. الربط بين عموم الوقت والجزاء: ذكر الليل والنهار، السر والعلانية، يعمّق مفهوم الاستمرار في العطاء، ويُسهّل تذكر الوعد بالأمان والرضا.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. من الذي بيده الهداية وقبول العمل؟، 2. ما الصفات التي تميز الفقراء المستحقين للصدقة؟، 3. ما المقصود بقوله تعالى “لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا”؟، 4. ما فضل الإنفاق في كل الأوقات؟، 5. ما الجزاء الذي وعد الله به المنفقين المخلصين؟
ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (275) يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)
عنوان موضوعي: تحريم الربا ومصيره، وبركة الصدقات
التفسير: يصوّر الله حال الذين يتعاملون بالربا في مشهدٍ رهيبٍ يوم القيامة، إذ يقومون من قبورهم متخبطين كالممسوس الذي صرعه الشيطان من الجنون، في دلالةٍ على اضطرابهم وذلّهم وشدة عذابهم. وبيّنت الآية سبب هذا المصير، وهو زعمهم الباطل أن الربا كالبيع، مع أن الله أحلّ البيع لما فيه من التراضي، وحرّم الربا لما فيه من الظلم والاستغلال. ومن وُعِظ فاتعظ وترك الربا فله ما سلف، أي يُعفى عن ماضيه، وأمره إلى الله يرجى له القبول، أما من عاد بعد العلم فهو من أهل النار خالدًا فيها. ثم تُظهر الآيات أن الله يمحق الربا أي يُزيل بركته ويُطمس أثره، في حين يبارك في الصدقات وينميها، فشتان بين مالٍ ممحوقٍ بالحرام وآخرٍ مباركٍ بالحلال. وتختم بأن الله لا يحب الكافرين الآثمين الذين يُصرّون على الحرام عن علمٍ وعناد.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن الإخلاص في الإنفاق وبركته، تأتي هذه الآيات لتحذر من الربا الذي يمحق البركة، وتُبرز أن المال لا يزكو إلا بالصدق والطهارة، لا بالاستغلال والطمع.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين المشهد والعقوبة: تصوير أكلة الربا كممسوس بالشيطان يربط بين فساد العمل واضطراب الجزاء، 2. الربط بين الربا والصدقة: تقابل “يمحق الله الربا” و”يربي الصدقات” يجعل الفكرة متوازنة وسهلة الاستحضار، 3. الربط بين التوبة والمآل: تقسيم الناس بين من انتهى فله ما سلف ومن عاد فله النار يُثبّت المعنى بالتفصيل المتقابل.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف وصف الله حال آكل الربا يوم القيامة؟، 2. ما حجتهم في تشبيه الربا بالبيع؟، 3. ما مصير من تاب من الربا بعد العلم؟، 4. كيف تُقارن الآية بين أثر الربا والصدقات؟، 5. من هم الذين لا يحبهم الله في ختام الآية؟
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (277) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (278) فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (280) وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ (281)
عنوان موضوعي: جزاء المؤمنين والتحذير من الربا ويوم الحساب
التفسير: تمدح الآية المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوفٌ عليهم ولا حزن. ثم يُوجّه الخطاب للمؤمنين بترك ما بقي من الربا إن كانوا صادقين في إيمانهم، وإلا فليعلموا أنهم في حربٍ من الله ورسوله، وهو وعيدٌ شديد يدل على فظاعة هذا الذنب. ومن تاب فله رأس ماله دون زيادة أو نقصان، فلا يظلم ولا يُظلم. وإن كان المدين معسرًا وجب الإمهال حتى يوسر، والتصدق عنه خيرٌ وأفضل عند الله. وتُختتم الآيات بالتحذير من يومٍ يُرجع فيه الناس إلى الله فيُوفَّى كل امرئٍ عمله دون ظلم، فيربط النص بين المعاملة الدنيوية والمحاسبة الأخروية.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان محق الربا وبركة الصدقة، تأتي هذه الآيات لتؤكد أن التقوى والإيمان الحقيقي يظهران في ترك الربا والرفق بالناس، وتذكّر أن الحساب يوم القيامة يشمل كل معاملة مالية.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين الإيمان والعمل والجزاء: جمع الإيمان والصلاة والزكاة مع وعد الأمان من الخوف يربط بين الدين والسعادة الأخروية، 2. الربط بين الربا والحرب الإلهية: التحذير بلفظ “فأذنوا بحرب” يجعل العقوبة مرعبة وسهلة التذكّر، 3. الربط بين الترفق بالدائنين ويوم الجزاء: الانتقال من التعامل المالي إلى مشهد الحساب يُظهر أن الأخلاق في المعاملات امتدادٌ للتقوى.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما صفات المؤمنين الذين ينالون الأجر والأمان؟، 2. ما الوعيد الذي وجّهه الله لآكل الربا؟، 3. ما الحكم في حال عجز المدين عن السداد؟، 4. ما فضل التصدق عن المعسر؟، 5. كيف يربط ختام الآيات بين المعاملة في الدنيا والجزاء في الآخرة؟
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (282) ۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ (283)
عنوان موضوعي: تنظيم المعاملات المالية وضمان الأمانة
التفسير: تأمر الآية بكتابة الديون المؤجلة توثيقًا عادلًا يحفظ الحقوق ويمنع التلاعب، ويقوم بالكتابة كاتب مختص يلتزم بالعدل، وعلى المدين أن يُملي الدين بنفسه بدقة وتقوى، فإن عجز ناب عنه وليه، كما توصي بإحضار شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ضمانًا للعدالة، وتلزم الشهود بأداء شهادتهم وعدم الامتناع عنها. وتستثنى التجارة الحاضرة من الكتابة ويُكتفى بالتراضي المباشر، أما في السفر أو عند تعذر الكتابة فيؤخذ رهن مقبوض كضمان، ومن اؤتمن على مال وجب عليه أداء الأمانة كاملة عند الطلب، وتختتم الآية بالتحذير من كتمان الشهادة وتؤكد أن ذلك إثم عظيم وأن الله مطلع على كل شيء.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد الحديث عن التقوى ويوم الحساب، تأتي هذه الآية لتوضح أهمية العدل في المعاملات المالية حفظًا للحقوق ومنعًا للظلم، فيُظهر الربط أن العدل في الدنيا صورة من صور التقوى والإيمان بالله.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين التوثيق والعدالة، 2. الربط بين الحالات الخاصة والضمانات، 3. الربط بين أداء الأمانة وكتمان الشهادة.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. ما الأمر الذي وجهت الآية به عند توثيق الديون المؤجلة؟، 2. ما الحالات التي يُطلب فيها رجل وامرأتان للشهادة؟، 3. ماذا يجب على الشخص الأمين إذا أعطي أمانة؟، 4. ما الحكم الشرعي بشأن كتمان الشهادة؟، 5. كيف تظهر الآيات أهمية توثيق الحقوق في المعاملات؟
لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ (284) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ (286)
عنوان موضوعي: شمول علم الله، إيمان المؤمنين، ودعاء ختام السورة
التفسير: تُختتم سورة البقرة بهذه الآيات الجامعة لمقاصد الدين في الإيمان والطاعة والمسؤولية والدعاء. تبدأ بتقرير أن كل ما في السماوات والأرض ملك لله، وأنه وحده المتصرف فيه، يعلم ما يُظهره الناس وما يُخفونه، ويحاسبهم على نواياهم وأعمالهم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم تُظهر الآيات إيمان الرسول ﷺ والمؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله دون تفريق بينهم، قائلين: ) سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا(، سائلين ربهم المغفرة والرجوع إليه. وتؤكد أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن لكل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر. وتختتم السورة بدعاء جامع يطلب العفو والمغفرة والرحمة والنصر، ويعبر عن التوكل الكامل على الله وعدله ورحمته.
مناسبة المقطع للمقطع السابق: بعد بيان أحكام المعاملات والعدل بين الناس، تُختتم السورة بالتذكير بعلم الله الشامل وإيمان المؤمنين الصادق، لتربط بين التشريع العملي والإيمان القلبي، وتُظهر أن الشريعة لا تنفصل عن العقيدة والروح.
أوجه الربط لتسهيل الحفظ: 1. الربط بين شمول علم الله والمحاسبة، 2. الربط بين الإيمان الجامع والدعاء الخاشع، 3. الربط بين التكليف والتيسير الإلهي.
مناسبة المقطع لختام السورة: تُختتم السورة بآيات تجمع بين التشريع والعقيدة، فتربط كل ما سبق بعلم الله وعدله ورحمته، وتذكّر أن الدين الكامل هو عبادة الله في السر والعلن، بالعمل والإيمان والدعاء.
أسئلة لترسيخ الفهم: 1. كيف يعبر المؤمنون عن إيمانهم بالله ورسله؟، 2. ما الذي لا يكلف الله به المؤمنين؟، 3. ما الأشياء التي طلب المؤمنون التخفيف منها في دعائهم؟، 4. ما أثر الإيمان بعلم الله في حياة المسلم اليومية؟، 5. كيف يربط ختام السورة بين المعاملات الدنيوية والرجاء في رحمة الله؟